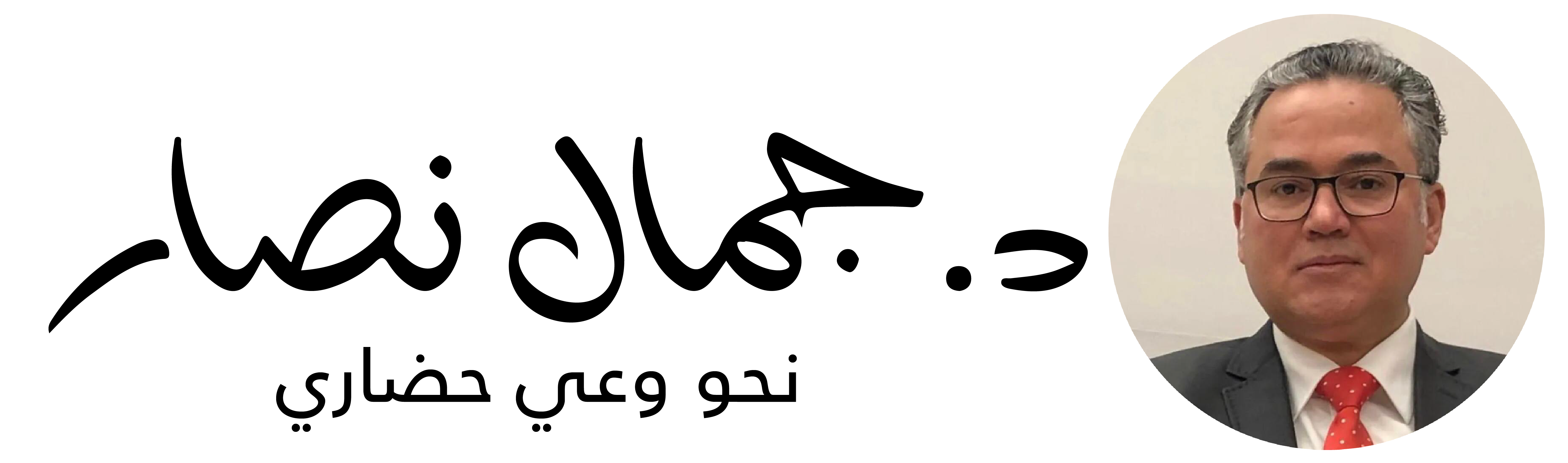د. جمال نصار – عربي21
لو طرحنا سؤالًا مهمًا وجوهريًا في سياق الصراع الدائر في السودان بين طرفيه المتحالفين سابقًا، المتناحرين حاليًا (البرهان – حميدتي)، ما هي الدولة العربية أو الأفريقية التي نالت حريتها وتطوّرت في ميادين الحياة، وتبوأت مكانتها بين الأمم في ظل حكم العسكر، أو انقلابه على المسار الديمقراطي؟!
ستكون الإجابة الواضحة الشافية أنه لا يوجد قطعًا دولة حظيت باستقلالها الوطني، أو نالت حريتها وكرامتها، أو اختارت حكامها بشكل ديمقراطي في ظل حكم العساكر.
وحقيقة الأمر أن فكرة إنشاء الجيوش العربية جاءت بداية من المستعمر، حتى يكون له وكلاء في المنطقة، يستمعون له، وينفذون أجندته في المنطقة، والنماذج على ذلك كثيرة، فمنذ بدايات القرن العشرين كان قائد الجيوش العربية، هو نفسه قائد الجيش الأردني، ولكم أن تعلموا أنه كان ضابطًا بريطانيًا يُدعى “جون باغوت جلوب”، في الفترة (1939 – 1956)، والأمر لم يختلف كثيرًا في مصر والعراق، حيث تم تأسيس الجيش على يد الضباط البريطانيين باعتبار أن البلدين كانا تحت الاحتلال وقتها، ولم تتغير الأمور كثيرًا مع انقلاب يوليو 1952، فالمستعمر البريطاني لم يكن ليترك بعض الضباط في الجيش المصري لينقلبوا على الملك إلا بعد التأكد من رعاية مصالحهم، وتنفيذ أجندتهم، وعدم مواجهتهم.
واللافت للانتباه أن أغلب المعارك التي تعتبر نصرًا أو نصرًا جزئيًا، في التاريخ العسكري العربي الحديث، تركزت حول الدفاع لا الهجوم، ففي حرب أكتوبر عام 1973 مثلًا، كانت خطة الهجوم المصرية المسماة “المآذن العالية” ترتكز بحسب رئيس أركان حرب الجيش المصري وقتها الفريق سعد الدين الشاذلي على “عبور مانع قناة السويس والتمسك بجسور دفاعية في انتظار العدو، وإطالة الحرب لأطول أمد ممكن بحيث يدفع العدو للانصياع للوضع الموجود على الأرض، أو القيام بهجمات تكلفه خسائر كبيرة لا يقوى معها على الاستمرار في المعركة”، حتى الحروب الأخرى التي خاضها الجيش المصري كانت كلها لأجل غرض دفاعي حتى إن بدأت بتحرك شبه هجومي كما في العام 1967 بالسيطرة على أماكن قوات حفظ السلام الدولية بعد توجيه طلب رسمي لها بالانسحاب من حدود خط الهدنة عام 1956.
والجيش السوداني لا يخرج كثيرًا عن هذا السياق، فقد تأسست نواته في العصر الحديث قبل عام 1955، وعُرف آنذاك بقوة دفاع السودان، وكانت تتكون من عدد من الجنود السودانيين تحت إمرة الجيش البريطاني المحتل، ولم يتم تكوين جيش وطني جديد إلا بعد أن نال السودان استقلاله عن الحكم الثنائي الإنجليزي المصري عام 1956، وعُرف وقتها باسم الجيش السوداني.
وإذا أخذنا نموذجًا لحكم العسكر في دولة محورية مثل مصر، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري، سنجد أن العملة المحلية تأثرت كثيرًا، فبعد أن كانت قيمتها قبل العام 1952 تفوق الدولار، أصبح الآن الدولار يتخطى الـ 35 جنيهًا، ناهيكم عن ازدياد الديون الخارجية والداخلية بشكل مخيف.
ما أريد أن أؤكد عليه من ذكر هذه الحقائق أن الحكم العسكري شرٌ كله، ولا يمكن لأي دولة أن تحصل على استقلالها الوطني من خلال هذا الحكم، لأنه في الغالب يتم اختيارهم بعناية، ومن تظهر عليه علامات الوطنية يتم استبعاده فورًا، هذا الكلام ينطبق في كثير من الأحيان على كل الجيوش العربية إلا من رحم.
البرهان وحميدتي والطريق للهاوية
أقول: لا تخرج التكوينة العسكرية لكل من عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي عن نائبه محمد حمدان حميدتي، فكلاهما سعي منذ فترة لكي يصعد على حساب أقرانه في القوات المسلحة السودانية، والاختلاف الوحيد بينهما أن البرهان تدرّج في التراتبية العسكرية، أما حميدتي فلم يمارس التراتبية في الجيش السوداني، ولم يكن عسكريًا في الأساس، ولكنه عمل كتاجر للإبل، وكوّن ميليشيات عسكرية منذ العام 2005، واحتضنه الرئيس المعزول عمر البشير، واستخدمه لوقف التمرد ضد الحكومة السودانية في دار فور في العام 2010، وارتكب جرائم كبيرة في حق السودانيين في دار فور، وفي غيرها.
وقد تشكلت قوات الدعم السريع، وعُرفت بهذا الاسم في عام 2013، وتعود أصولها إلى ميليشيا الجنجويد التي قاتلت بضراوة المتمردين في دارفور. ومنذ ذلك الحين، سعى الجنرال دقلو، المعروف بحميدتي إلى تأسيس قوات قوية تدخّلت في صراعات في اليمن وليبيا، وهي تسيطر على بعض مناجم الذهب في السودان. واتُهمت بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك مجزرة قُتل فيها أكثر من 120 متظاهرًا في يونيو/حزيران 2019.
وقد تباينت مواقف الرجلين بعد التوقيع على “الاتفاق الإطاري” مع المكون المدني، في 5 ديسمبر /كانون الأول 2022. وعلى الرغم من أنهما صرحا في أكثر من موقف أن المؤسسة العسكرية تسعى لتسليم السلطة للمدنيين، إلا أن تصريحاتهما اللاحقة كشفت عن تباين؛ إذ بينما أقرّ حميدتي بـفشل الانقلاب، وأعلن دعمه الكامل للاتفاق باعتباره مخرجًا، بدت تصريحات البرهان كمحاولة للتملص من الاتفاق، وسرعان ما تحول هذا التباين إلى ملاسنات غير مباشرة بين الطرفين، مستفيدين في ذلك من تشتت المكون المدني، وانتهى بهم الأمر إلى الصراع العسكري الحادث إلى الآن، والتي بدأت شرارته في الخامس عشر من أبريل/ نيسان 2023.
واللافت للنظر بالرغم من الخلافات بين الرجلين، إلا أنهما يتفقان على شيء واحد فقط، وإن لم يُصرحا به علانية، وهو إجهاض المسار الديمقراطي في السودان. وذلك لأن لديهما يقين أن القوى المدنية التي ستتولى السلطة في الفترة القادمة ستفشل في إدارة المرحلة الانتقالية، وهو ما قد يُمهد الطريق لعودة أحدهما إلى السلطة من بابها الكبير، وبما سوف يسمح لأحدهما بالتخلص نهائيًا من الآخر، وبالضربة القاضية.
أقول إن هذه الحرب المستعرة بين الرجلين قد تؤدي إلى تمزيق البلاد أكثر، وتأجيج الاضطرابات السياسية، مما يؤثر بالسلب على الدول المجاورة والأمن الإقليمي، ناهيكم عن نزوح الملايين من الشعب السوداني، وزيادة المعاناة التي يعيشها منذ سنوات، وانتشار حالة الفوضى والسرقات، والانهيار الكامل للنظام الصحي، وربما ينتهي الأمر إلى استدعاء تدخلات من الدول المجاورة، وتقسيم السودان على أقل تقدير، بعد أن قُسم من قبل إلى شمال وجنوب.
وفي تقديري لن تصمد الهُدن التي يُعلن عنها من حين لآخر، طالما هناك دعمًا من بعض الدول الإقليمية والدولية للطرفين، وهذا مما لا شك فيه سيجعل الحرب مستعرة بشكل دائم، والمتضرر بلا أدنى شك هو الشعب السوداني، ومقدراته، مع الانهيار الكامل للبنية التحتية للدولة السودانية في جميع المجالات.
وأعتقد أن الحل لمعضلة السودان في هذه المرحلة الراهنة وما بعدها أن يتم استبعاد العسكريين من سُدة الحكم، والذهاب فورًا إلى حكومة مدنية وطنية، من كل مكونات المجتمع، لفترة انتقالية، يتم بعدها إجراء انتخابات حرة نزيهة، لكي يقول الشعب السوداني كلمته، بعيدًا عن فوة المدافع والأليات العسكرية، ويقوم العسكريون بدورهم المنوط بهم في كل دساتير العالم، من حفظٍ للحدود، والدفاع عن الدولة ضد أعدائها، وليتركوا الساسة لأهلها، وهذا ما يحدث في كل دول العالم المتحضر.