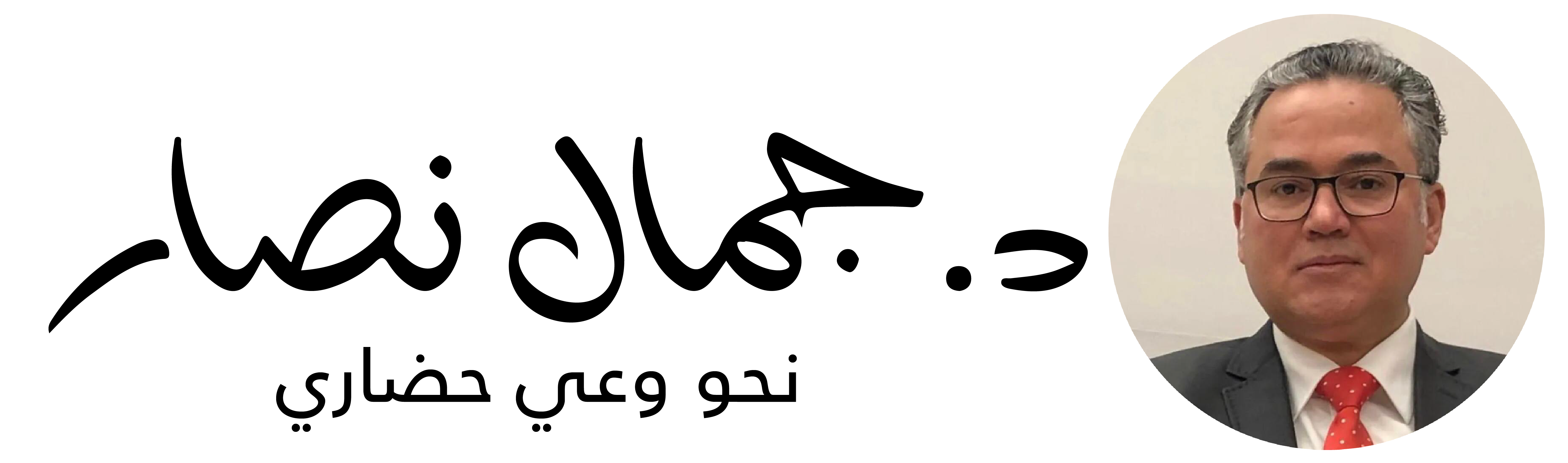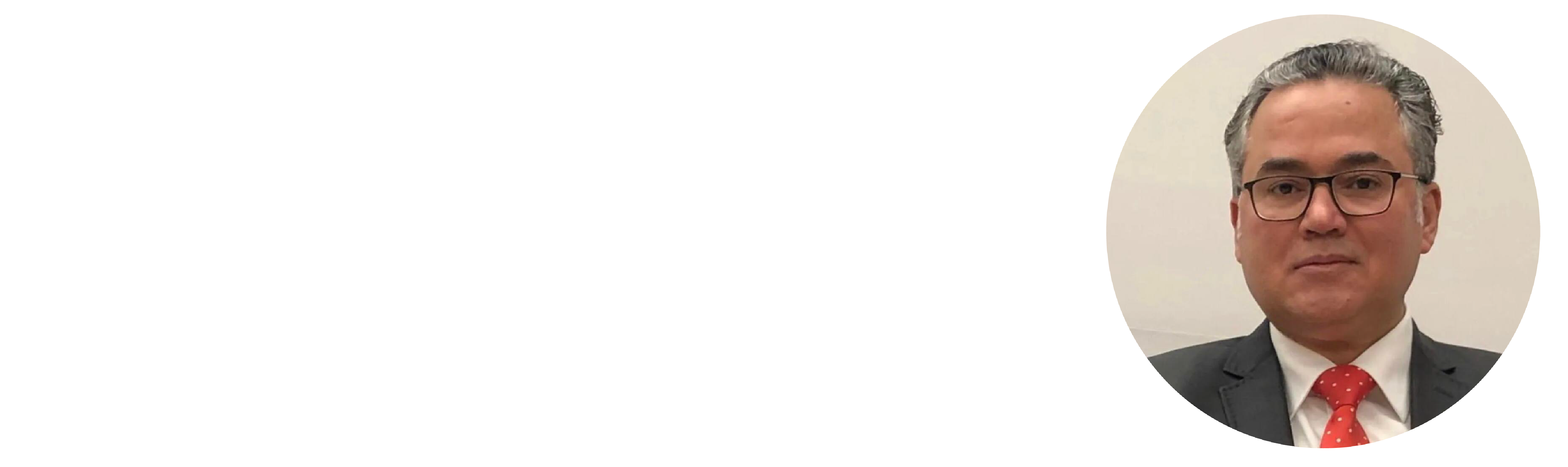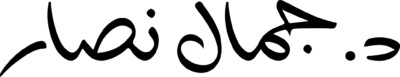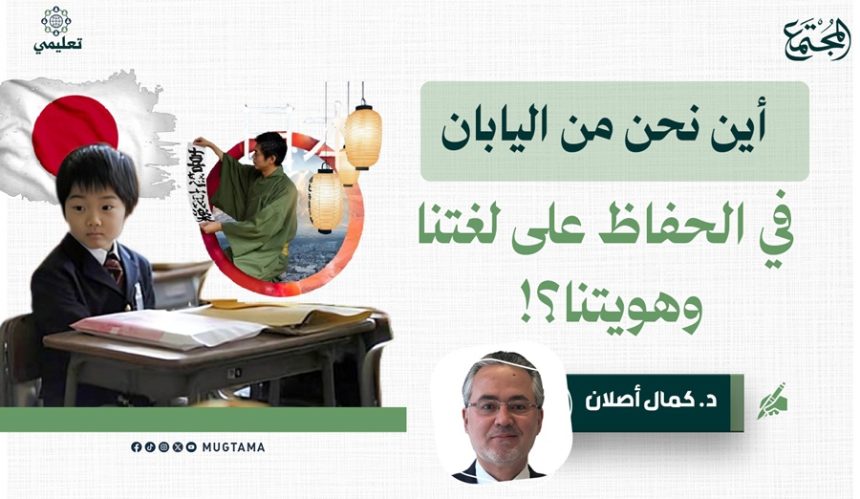د. كمال أصلان – المجتمع الكويتية
أرسل إليّ صديق عزيز مقطع فيديو يتناول كيف يُقدّم اليابانيون لغتهم على سائر اللغات، وأن ذلك كان من أسباب تقدمهم، حتى إنهم جعلوا لغتهم قُدس الأقداس. تأملتُ في واقعنا، وتألمتُ كثيرًا… لماذا؟
لأننا فرطنا في لغتنا بشكل كبير، ولا نحسن التعامل معها وبها، وانصرف اهتمامنا الأكبر إلى اللغات الأجنبية وخصوصًا اللغة الإنجليزية، حتى إن البعض إذا أراد أن يتحدث مع الآخرين باللغة العربية، يستخدم بشكل تلقائي بعض العبارات الإنجليزية، ليثبت أنه إنسان متحضر، كأن تمسكنا بلغتنا هو سبب تخلفنا!
وأصبحنا في عالمنا العربي نتجه، بقصد أو بدون قصد، نحو التفريط في اللغة الأم والانبهار المبالغ فيه باللغات والثقافات الأجنبية. هذا الكلام لا يعني الانغلاق، بل محاولة لتسليط الضوء على أهمية التوازن بين الانفتاح والاعتزاز بالذات.
والسؤال الذي يطرح نفسه: أين نحن من اليابان في الحفاظ على اللغة والهوية؟ ولماذا يبدو الفارق شاسعًا؟
أرى أن هناك عدة أسباب أوصلتنا إلى ذلك منها:
أولًا: اللغة ليست مجرد كلمات.. بل روح وهوية:
اللغة ليست وسيلة تواصل فحسب، بل هي وعاء الفكر، ومرآة الثقافة، وجسر الماضي إلى المستقبل، وعندما تضعف اللغة الأم في مجتمعٍ ما، فإن ذلك ينعكس على التفكير، وعلى التصور الذاتي، وعلى القدرة في التعبير عن الذات بخصوصية وتميّز.
في المقابل، نرى أن اليابانيين ينظرون إلى لغتهم باعتبارها جزءًا لا يُفصل عن كيانهم الوطني، ويرفضون أن تحل محلها أي لغة أخرى حتى في مجالات العلم والتكنولوجيا، بل يعيدون إنتاج المعرفة بلغتهم ويترجمون المحتوى العالمي بما يتناسب مع خصوصيتهم.
أما نحن، فكثيرًا ما نرى ميلاً لتقديم اللغات الأجنبية، وخاصة الإنجليزية والفرنسية، على اللغة العربية في التعليم، والإعلانات، والتواصل اليومي، بل حتى في الأوساط العلمية والثقافية، ويزداد هذا الميل في أوساط النخبة، ويُنظر إلى من يتقن لغة أجنبية على أنه “مثقف” حتى لو كان ذلك على حساب إتقانه للغته الأم.
ثانيًا: التعليم والخلل في المنظومة التربوية:
تفرض اليابان تعليم اللغة اليابانية بصرامة في كافة المراحل التعليمية، وتعدها أولوية قصوى، بينما تُدرس اللغات الأجنبية كأداة مساعدة لا كبديل، أما في بلادنا، فقد أصبحت بعض المدارس والجامعات تُدرس العلوم والرياضيات والطب والهندسة بلغة أجنبية، دون أن يُرافق ذلك تعليم جاد للغة العربية يمكن أن يوازن أو يحفظ الهوية.
هذا الوضع أنتج أجيالًا تتعثر في التعبير بلغة سليمة، وتفتقد المصطلحات العربية العلمية، وتجد صعوبة في كتابة مقال أكاديمي أو حتى خطاب رسمي بلغتها الأم، بينما تُتقن مصطلحات أجنبية دون فهم عميق لسياقاتها.
ثالثًا: الإعلام.. أداة بناء أم هدم؟:
في اليابان، الإعلام بكل أنواعه يشتغل باللغة الوطنية، حتى البرامج الموجهة للأطفال والرسوم المتحركة (الأنمي) تُنتج بلغة تحمل روح اليابان، وتنقل ثقافتها، أما في عالمنا العربي، فكثير من القنوات والمسلسلات والبرامج، خصوصًا المُستوردة أو الموجهة للشباب، تُستخدم فيها لغة هجينة، لا هي عربية فصيحة، ولا هي لهجة محلية، وغالبًا ما تتخللها كلمات أجنبية بلا حاجة.
هذا النمط الإعلامي يُعمق الانفصال عن اللغة الأم، ويُضعف الذوق اللغوي، ويفقد الشباب الثقة بلغتهم، وكأنها لغة عتيقة لا تصلح للحاضر.
رابعًا: الانبهار بالآخر.. عقدة أم افتتان مشروع؟:
من الطبيعي أن يعجب الإنسان بتقدم الآخرين، وأن يتعلم من تجاربهم، لكن المشكلة تبدأ حين يتحول هذا الإعجاب إلى ذوبان، فيصبح كل ما هو “غربي” أفضل، وكل ما هو “محلي” متخلفًا أو دونيًّا، هذا الشعور تفشى في مجتمعاتنا إلى حد بات فيه كثير من الناس يربطون النجاح بإتقان لغة أجنبية، ويعتبرون استخدام اللغة العربية في بعض المجالات علامة على الرجعية أو التخلف، ولعل هذا ما ذكره ابن خلدون (808ه) من أن المغلوب يتبع الغالب.
في حين أن الياباني لا يشعر بأي نقص حين يستخدم لغته في مؤتمرات عالمية، ولا يرى في الترجمة أو التعريب عيبًا، بل مصدر قوة، بل حتى عندما يتحدث بلغة أجنبية، يُصر على أن يحمل اسمه الياباني، وثقافته في تعبيره.
خامسًا: مسؤولية النخب وصنّاع القرار:
الفرق بيننا وبين اليابان لا يتعلق بالشعب فقط، بل بمن يُمسكون بزمام الأمور، فالدولة اليابانية تضع اللغة والثقافة في قلب استراتيجياتها الوطنية، وتُخصص ميزانيات ضخمة لترجمة العلوم إلى اليابانية، وإنتاج محتوى ثقافي وتعليمي يُرسِّخ الهوية.
أما في عالمنا العربي، فكثير من النخب السياسية والثقافية تتحدث بلغة أجنبية في المحافل، وتكتب بها، بل وتُفضل التعامل بها، وكأنها لغة النخبة، بينما العربية يُنظر إليها كلغة عادية أو شعبية. هذا التوجه يُكرس الانفصال بين اللغة والقيادة، ويُضعف الحافز لدى الأجيال الناشئة للاعتزاز بلغتهم.
سادسًا: مستقبل اللغة.. بين الذوبان والنهضة:
إذا استمر هذا الحال، فإن الهوية اللغوية ستتآكل تدريجيًا، وسيجد الشباب أنفسهم بين لغتين: لغة أجنبية لا يتقنونها جيدًا، ولغة أم لا يُعبرون بها بثقة. والنتيجة: ضعف فكري، وضياع ثقافي، وتبعية معرفية.
أما إذا وعينا خطورة هذا المسار، وتعلمنا من نموذج كاليابان، فيمكننا أن ننهض بلغتنا ونوظفها لبناء نهضة علمية وإنسانية متوازنة.
ويمكن القول إن تمسك اليابان بلغتها الوطنية وقلة اهتمامها باللغات الأجنبية ليس نتيجة عزلة، بل نابع من رؤية ثقافية متجذرة وشعور قوي بالهوية. ورغم أن لهذا التوجه بعض التحديات، إلا أنه يمثل تجربة فريدة في كيفية التوفيق بين التقدم والانفتاح من جهة، والحفاظ على الخصوصية والهوية من جهة أخرى.
ولعل دروس اليابان في هذا السياق تصلح لأن تُلهم دولًا أخرى تسعى للحفاظ على لغتها وثقافتها في زمن العولمة الجارفة، ولعلنا في عالمنا العربي والإسلامي ننتبه لهذا الانجراف نحو اللغات الأخرى دون وعي، مع إهدار اللغة الأم التي تمثل ثقافتنا وهويتنا.
في النهاية أود أن أقول إننا لسنا أقل من اليابان في الذكاء أو الإمكانيات، لكننا بحاجة إلى إعادة الاعتبار للغتنا، وأن ندرك أن من لا يعتز بلغته لا يُمكن أن يبني نهضة حقيقية.
فهل آن الأوان لنراجع أنفسنا؟ وهل نملك الشجاعة لنقول: نريد أن نكون أمة تفكر وتبدع بلغتها؟