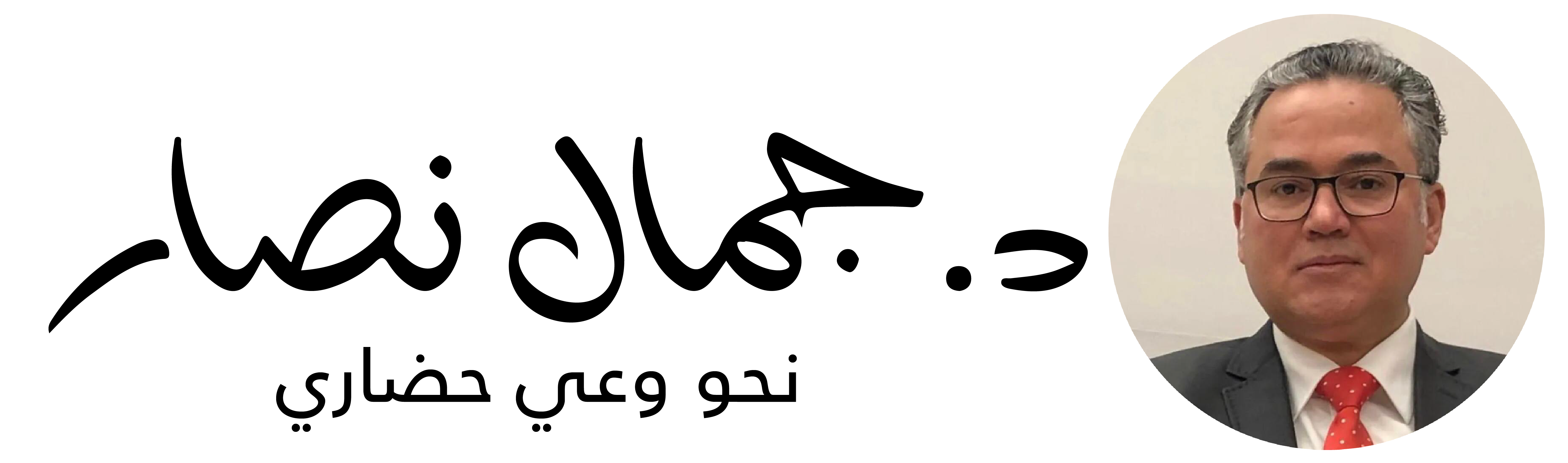د. جمال نصار – الجزيرة مباشر
أتصور أن الأزمات التي نعيشها في حياتنا، على مستويات عدة، لها سبب أصيل، وهو غياب الجانب الأخلاقي والقيمي في حياتنا، فالواقع المُشاهد لسلوكيات الكثير مِنّا في الوقت الراهن لتصيبه دهشة شديدة مما آل إليه أمر العديد من المجتمعات في الوطن العربي!
فالحقيقة أن الأخلاق لم يعد لها مجال، في غالب الأحيان، في واقعنا، وكأنها تدفعنا إلى التخلف والتأخر في جميع الميادين! ودون أن نشعر نستبدل بأخلاقنا الأصيلة ما يُسمى الأخلاق النفعية أو المكيافيلية، التي تبرر الوسيلة للوصول إلى الغاية التي يريدها أي إنسان في حياته، مهما كانت هذه الوسيلة مخالفة لديننا وعاداتنا وتقاليدنا.
وهذا واضح على مستوى الأفراد والمجتمع، حتى الدولة، فالفرد إذا انعدم عنده الوازع الخُلقي، لا شك أن ذلك يظهر في المجتمع، وتكون له آثار سلبية ومخيفة، وهذا ما لاحظناه في الآونة الأخيرة من أحداث القتل بين طالب وزميلته، في أكثر من مكان، وبين قاضٍ وزوجته، وزيادة حالات الانتحار بشكل ملحوظ، وغير ذلك كثير من الأحداث المؤسفة.
أين مَكْمَن المشكلة؟
أتصور أن أصل الداء لدينا أننا لا نواجه أنفسنا بالمشكلة الأساسية، التي تؤثر على كل مجريات حياتنا، ولا نبحث لها عن حل ناجع، وليست لدينا، في غالب الأحيان، الإرادة الحقيقية لتغيير الأوضاع وتحسين الأخلاق.
ومن ثمَّ وجب علينا أن نعيد حساباتنا، ونراجع أنفسنا في أخلاقنا ومعاملاتنا، وننظر بعين الناقد لتصرفاتنا، ونسأل أنفسنا هل غياب الأخلاق سيحقق لنا ما نريد، وهل المعرفة النظرية بتلك الأخلاق دون تطبيقها يفيدنا، أم أنه من الواجب علينا أن نعيش بأخلاقنا ونتواصل ونتعايش بها؟
فالأخلاق هي رافعة المجتمع، فحين تكون الأخلاق موجودة في سلوكيات أي مجتمع من المجتمعات فهذا يعني أنّ هذا المجتمع متحضر متمدن، يسعى للتقدم والرِّفعة بين الأمم، كما أنّ الأخلاق هي معيار بقاء الأمم والحضارات، كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
إنّما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
هدف الأخلاق في الإسلام
لا شك أن الهدف العام في الإسلام أن يلتزم المسلم بالأخلاق الحميدة، ويكون هذا الالتزام إرضاءً لله، عز وجل، ولا ينبغي بتاتًا أن يكون هدفه مدح الناس له؛ لأن ذلك يُعدّ من الرياء، وكذلك لا ينبغي للعاقل أن يكون هدفه من وراء ذلك الكسب المادي فقط، فالإسلام أيضًا يهدف إلى بناء مجتمع يقوم على التراحم والتعاون والإيثار وحب الخير للناس، من خلال علاقات حسنة مع الوالدين والأبناء، والأزواج، والأرحام، والجيران، وجميع المسلمين، بل وغير المسلمين، بل يتعدى ذلك إلى الحيوان والجماد، فالإسلام، بحمد الله تعالى، يهدف إلى حمل المسلم على التحلي بمكارم الأخلاق، والعيش في ظلها.
إن الإسلام يدرك تمام الإدراك ماذا يحدث لو أُهملت المبادئ الأخلاقية في المجتمع، وساد فيه الخيانة والغش، والكذب والسرقة، وسفك الدماء، والتعدي على الحرمات والحقوق بكل أنواعها، وتلاشت المعاني الإنسانية في علاقات الناس، فلا محبة ولا مودة، ولا نزاهة ولا تعاون، ولا تراحم ولا إخلاص.
الأخلاق والاستقرار الاجتماعي
للأخلاق والقيم أهمية كبيرة في تحقيق نوع من الاستقرار الاجتماعي، يتم فيه احترام القواعد الأخلاقية السائدة في المجتمع، فإذا ضعف الالتزام الخلقي بين أفراد المجتمع، بدأت المتاعب والاضطرابات السلوكية، وبدأ الشك بالقيم والثقافة المحلية كذلك، حتى يصبح تحقيق الذات وحيازة الاعتراف الاجتماعي متعارضين مع احترام القواعد الأخلاقية السائدة، وعندها يكون تأثير القيم والضبط الاجتماعي قد ضعفا كثيرًا.
ويجب أن يكون هناك حرصًا على بيان أن الخلق الإسلامي قائم على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، أي أن القواعد الخلقية في الإسلام تدور على عدم السماح للمسلم أن يضر نفسه، أو أن يصدر عنه الإضرار بالغير إضافة إلى كونها مصدر خير عميم للفرد والجماعة، فعلى المربي أن يعي هذا ويوضِّحه في كل خُلق يتناوله بالنقد أو القدح، ويأتي بالبديل من الأخلاق الفاضلة في الإسلام، وبهذا يكون قد حقق ما يصبو إليه من تهذيب.
دور المدرسة والإعلام والبيئة في تقويم السلوك
الدور التربوي للمدرسة لا يقل أهمية عن دورها التعليمي، فلا فائدة من تخريج أجيال متعلّمة بلا وعي، أو أخلاق أو مهارات تمكّنها من استغلال ذلك العلم، وقد اقترن الدور التربوي للمدرسة بدورها التعليمي منذ نشأتها الأولى، ففي صدر الإسلام كان المسجد هو المدرسة النظامية الأولى للمسلمين، وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، تطور الأمر فأنشأ بجانب المساجد كتاتيب لتعليم الأطفال وتربيتهم، وأخذ الأمر في التطور إلى أن وصلنا إلى نموذج المؤسسة التعليمية الذي نعرفه اليوم، وقد تغيّر الشكل وتعددت الآليات، ولكن ظلت المدرسة تؤدي نفس المهمتين المنوطتين بها، وهما التعليم والتربية.
ومن أهم الركائز المهمة لتقويم السلوكيات لكل فئات المجتمع؛ الإعلام الذي يجب أن يلعب دورًا مهمًا وحاسمًا في رفع مستويات السلوك القويم، ويجب على المحطات الفضائية والصحافة أن يتعاملا بجدية مع الفساد الأخلاقي والسلوكي، وعدم التستر على من يتسببوا في إفساد المجتمع، وتقديم البرامج الهادفة مع التركيز على حُسن الخلق والتربية الصالحة، والقدوة الحسنة، وتاريخنا الإسلامي مليء بمثل هذه النماذج بدلًا من التنافس العقيم على المسلسلات والدراما غير الهادفة، سوى التسلية.
والمجتمع الأخلاقي والبيئة الصالحة لهما دور كبير في بث الأخلاق الحميدة في نفوس الأفراد، فإذا كان المجتمع مؤمنًا موحِّدًا عقائديًا، فهو نظيف أخلاقيًا، والقانون الأخلاقي يأتي في درجة ثانية بعد الإيمان؛ لأن الأخلاق لا بد لها أن تنبثق من عقيدة، وبمقدار ما تكون الأخلاق في المجتمع قوية سليمة بمقدار ما يكون المجتمع راقيًا متماسكًا.
ومن ثمَّ يمكن أن نجمل أسباب الأزمة الأخلاقية في: ضعف التدين في نفوس المسلمين، والتصور الخاطئ لشرائع الإسلام وأحكامه وروحه، وغياب القدوة الصالحة في كثير من المجالات، وطغيان الجانب المادي والاهتمامات الدنيوية في العلاقات والأعمال، وقلة البرامج التوعوية والأنشطة التي تُعنى بالجانب الأخلاقي، وقلة التربية الخلقية في مناهج التعليم على كافة المستويات، وعدم سن أنظمة وقوانين تحافظ على المبادئ والقيم الأخلاقية العامة، وتوقيع العقوبات المناسبة على مرتكبي الجرائم الأخلاقية المتجددة.
تصحيح البوصلة
وإذا أردنا أن نُصحِّح اتجاه البوصلة مرة أخرى علينا أن نولي الأخلاق عناية كبيرة في حياتنا، لكي ننهض مرة أخرى، ونسعى أن نكون في الوضع الذي يليق بالأمة الإسلامية التي صدّرت الحضارة للعالم كله، حينما كانت في كامل قوتها.
ولا شك أن هذه الأمة كالغيث لا ينقطع خيرها وفيها خير كثير، ولا ينبغي لأحد أن يحكم على الأمة جمعاء بفقدها الخلق الحسن، أو الفساد، أو نحو ذلك من الأحكام الجائرة التي تُشعر باليأس والإحباط والقنوط، وليس هذا سبيل المؤمن المتبصر في دينه، قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (إذا قالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النّاسُ فَهو أهْلَكُهُمْ)، وإنما المؤمن ينبه على الأخطاء، ويعالجها، ويحسن الظن بربه، ولا يقطع الرجاء به، ويتفاءل من أجل إصلاح ما أفسده الآخرون.
وحقيقة الأمر أن من معالم الحضارة والرقي، التمسك بالأخلاق والعيش بها. وهذا ما ذكره “ول ديورانت”، الفيلسوف المعروف في كتابه “قصة الحضارة”، أن الحضارة تتكون من أربعة عناصر هي: المواد الاقتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون.