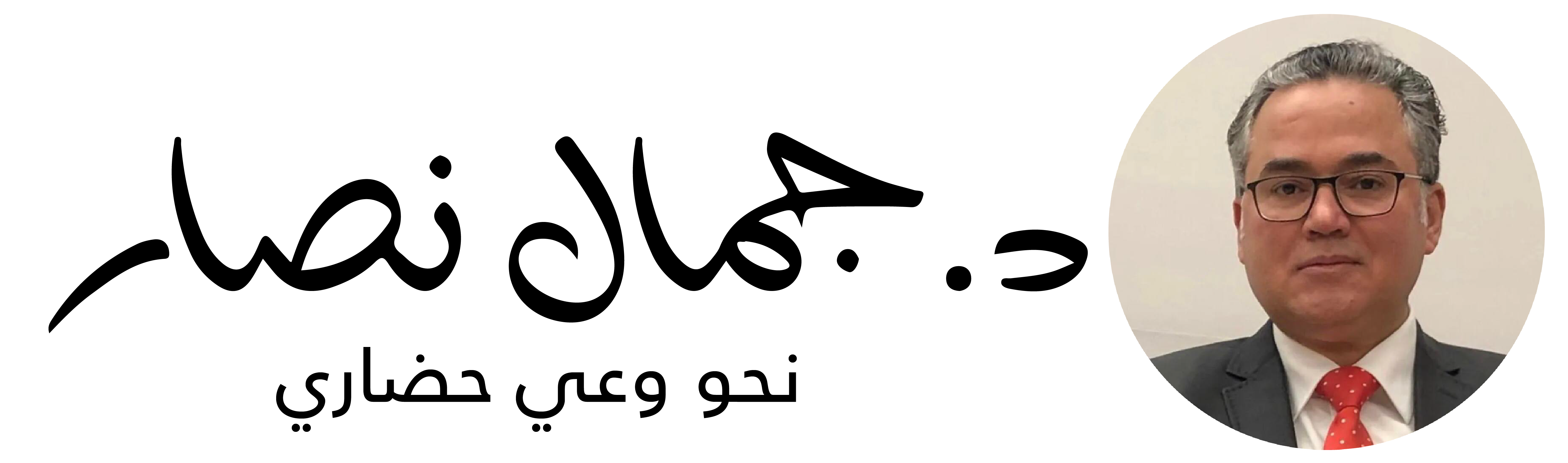يحظى العقل في الإسلام بمكانة عظيمة؛ إذ يعتبر مناط التكليف، وسر التشريف؛ حيث به ميّز الله تعالى الإنسان عن باقي المخلوقات، ورسم له حدودًا يعتبر تجاوزها جناية به وتكليفًا له بما لا يطيقه، وقد ورد فِعلُ العقل في القرآن الكريم في تسعةٍ وأربعين موضعًا، مما يدل على اهتمام القرآن بإعمال العقل واستخدامه فيما يفيد.
وبذلك شيّد الإسلام للعقل منهجًا سليمًا ومتماسكًا، حدد معالمه وأرشد مسيرته، وقد جعله علماء الشريعة من الكليات الخمس، التي تعتبر أعلى رتب المصالح، جنبًا إلى الدين، والنفس، والعرض، والمال، والتي تعتبر مدار الأحكام الشرعية، دقـها وجلها، المبنية على جلب المنافع ودرأ المفاسد.
ومن يتأمل التاريخ الإسلامي يجد أن المرض الوحيد، أو الأزمة الوحيدة التي أُصيب بها الخوارج هي أزمة الفكر، فليست أزمة عبادة ولا أزمة إخلاص، فقد كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة، لكن لمّا كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروق من الدين، فالانحراف الذي أصابهم سببه الخلل في منهجية تلقي القرآن، فهم يقرءون القرآن لكن بدون تدبر، ويحفظونه لكن بدون وعي، ولم يأخذ القرآن طريقه إلى عقولهم فيعوه، ولا إلى قلوبهم فيعقلوه، فأُتوا من فساد الفكر لا من فساد الضمير. فكيف لو أُضِيفَ إلى هذا الخلل الذي أصابهم علل نفسية، وعوامل مذهبية تساهم في تضخيم انحرافهم.
وهذا ما نراه في عصرنا، مذهبية كاذبة، تشدد في الفكر، قلة في الوعي والدراية، مع كثرة الحفظ أحيانًا، والتعمق في الجزئيات دون الإحاطة بالكليات لدرجة الإصابة بالتخمة في جزئيات الدين دون كلياته، وكثرة التكلف في البحث عن الصغائر دون إتقان فقه المقاصد، ومثل هؤلاء غاب عن أذهانهم أن من أصول الفقه الرشيد التركيز على فهم الواقع مع البعد عن التكلف والسؤال عما لا ينبني عليه عمل ولا إيمان.
ومن ثمَّ يجب إعادة ترتيب العقل الإسلامي من جديد وفق سنن الله تعالى في بناء الحضارات ومراعاتها في تمكين الأمم؛ لأن ثقافتنا الإسلامية في محنة، وأساس هذا الترتيب وفق شعب الإيمان وتنسيقها في سلم يكشف أدناها وأعلاها، وبإحصاء شؤون الدنيا التي لا يقوم الإيمان إلا بها، بعيدًا عن الخرافات المروية عن بعض الصوفية ومن شابههم، وبعيدًا – أيضًا – عن المتشددين الذين حصروا الدين في لباس قصير ولحية طويلة وسواك تحك به الأسنان، كل هذا من الدين، لكنه ليس كل الدين، وينبغي وضعه في مكانه، وإعطائه ما يستحق من اهتمام دون إفراط ولا تفريط، كما ينبغي التعريف بالقطعيات والظنيات في آفاق التشريع ومواطن التقليد والاجتهاد، والمحاكمة المستمرة لأعمال السلطات الإسلامية، وتبيّن الخطأ والصواب في مسيرتها، والمراجعة المستمرة لأرباحنا وخسائرنا طوال الفترات الماضية، وبذلك نفهم الإسلام كما فهمه سلفنا الصالح – عليهم رضوان الله – بأنه دين الله إلى عباد الله في كل زمان ومكان.
فرسالة الإسلام هي الرسالة التي امتدت طولًا حتى شملت آباد الزمن .. وامتدت عرضًا حتى انتظمت آفاق الأمم … وامتدت عمقًا حتى استوعبت شؤون الدنيا والآخرة، ولذا قال المستشرق دافيد دي سانتيلانا: “إن الإسلام دين ودولة، دون أن تكون دولته كهانة كنسية، تحكم بالحق الإلهي، كتلك التي عرفتها الحضارة المسيحية في أوروبا إبّان عصورها الوسطى والمظلمة، وأن الشريعة الإسلامية متميزة بالقانون الجامع بين الأحكام وبين منظومة القيم والأخلاق الدينية، والرابط بين المنفعة والمصلحة الدنيوية وبين الدين والجزاء الأخروي”.
فالدين الإسلامي دين شامل؛ لأنه يضمن جميع متطلبات الحياة، كما أن سيرة النبي، صلى الله عليه وسلم، تعطي القدوة في جميع الشؤون التي يرغب الناس اتخاذ النبي قدوة فيها، فالإسلام لم يترك جانبًا من جوانب الحياة إلا وقدّم له علاجًا وحلًا.
هذا هو الطريق الأقوم في إنهاض الأمم التي أزالت عن أبصارها غشاوات الوهم، أما تلك التي لا تزال مرتكسة في غياهب الجهالة، فربما راجت لديها دعوى الوحي والعصمة والاستمداد من عالم الغيب، بل يغلو دعاتها إلى أسمى مرتقى من الدعاوي والمزاعم.
والنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، لم يكن مجرد نبي – بمعني أنه لم يكن رجل دين بالمعنى الذي عرفته النصرانية في العصور الوسطى – وإنما كان – أيضًا- رجل دولة ومشرّعًا، وزوجًا، وأبًا، وقاضيًا، وقائد حرب، وأخذت الرسالة النبوية أبعادًا جديدة لم يكن من الممكن أن تأخذها وقت سيدنا عيسى عليه السلام، فقد شملت العلاقات الاجتماعية دون أن تفقد أبعادها الروحية أبدًا، وقد قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ) (الرعد:11) هكذا كانت الخاصية القرآنية هي منهاج أخلاقي للعمل، فالدين الإسلامي يرفض ألبتة حياة الأديرة التي يكون فيها التأمل هو السبيل الوحيد والهدف الأسمى فقط.
فهذا الذي وجد إبراهيم بن أدهم يُقوِّم فكره واعتقاده، وهو نفسه قَبِل التقويم، لكن من القوم من يجد نفسه سيدًا على إخوانه مُقوِّما لهم، ولا يجوز لغيره تقويمُه، يرى في نفسه الفقه والعلم، ويرى غيره من الناس جهلاء آثمين، وقد يتطاول أمثال هؤلاء على غيرهم، بل يتطاولون على العلماء، وهم لم يبلغوا قدر أُنملة من هؤلاء العلماء.
إن التشدد في الدين، والميل لتغليب التحريم وجعله هو الأصل، من معطيات الأُميّة الفكرية، ولذلك فإن من وصفهم القرآن بالضلال وهم النصارى، قد حَرّموا كثيرًا مما أحل الله لهم، فمالوا إلى الترهبن والتنطع وتحريم زينة الله، وقد أمر الله نبيه، صلى الله عليه وسلم، أن ينهاهم عن هذا الغلو، فقال: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيل) (المائدة: 77)
والمتشدد بسبب أميته الفكرية لا يعرف أن الاجتهاد جائز إلا في أضيق الأحوال، ولا يدري أن الصواب قد يتعدد في بعض المسائل، وأن المجتهد إذا أخطأ في أسوأ الأحوال مأجور، ولا يعرف أن الصحابة مارسوا الاجتهاد بما فيه من صواب وخطأ، وأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، كان يكره الاجتهاد الذي يجلب المشقة، ويقر الاجتهاد الذي يجلب التيسير، ولا يعرف الأمي كذلك آداب الخلاف.
ومما يشهد لهذا القول قول النبي، صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلا مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا). فكان، صلى الله عليه وسلم، حقًا معلمًا ميسرًا؛ ولذلك ارتبط التشدد بأصحاب الجهل أو الحفظ بدون وعي، وارتبط التيسير بالفقهاء، فهذا حبر الأمة عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتفقه في الدين وتعلم التأويل يعرف برخصه، حتى أصبح علمًا لمدرسة التيسير، ونُسب إلى الإمام سفيان الثوري أنه قال: “إنما العلم الرخصة من ثقة، أما التشدد فيحسنه كل أحد”.
وحين يضعف الفقه فإن العاطفة تحتل المساحة الشاغرة، ومن ثمّ يندفع الشباب بحسن نية وبدافع الحرص على الإسلام وعلى تطبيق أوامره واجتناب نواهيه، يندفع إلى معاملة الفرعيات كالأصول والوسائل كالمقاصد، ويحرص على التفسير التآمري وتضخيم المنكرات، ويميل إلى تفعيل سد الذرائع أو فقه الطوارئ بصورة مضخمة، ويميل دائمًا إلى الأحوط من الأقوال، ولا يكتفي بنفسه بل يدعو غيره إلى ذلك بكل ما أوتي من قوة، وهذا كله يساعد على توسيع دائرة التعسير وتضييق دائرة التيسير. إن الإسلام قائم على التيسير لا التعسير، وتشدد المسلم المعاصر في المسائل الخلافية، وإثارتها في المجتمع دليل جهله وعدم فهمه للواقع. وهذه الآراء الخلافية يعيها المفكرون من أعداء الإسلام، ويروجون لها، ويثيرونها من حين لآخر، ليزرعوا في صفوف المسلمين الفرقة، وليحيوا آثار المذهبية، ويشتتوا العامة من المسلمين، فتارة يتحدثون عن ختان الإناث، وتارة أخرى عن نقاب المرأة، وثالثة عن فرضية اللحية … وهلم جرى، والمسلمون ينساقون وراءهم بين مجوز ومانع ناسين قضاياهم الرئيسة من الدفاع عن المقدسات الإسلامية في فلسطين، ونشر لدينهم الحنيف، ومواجهة الفساد واستبداد الأنظمة العربية.