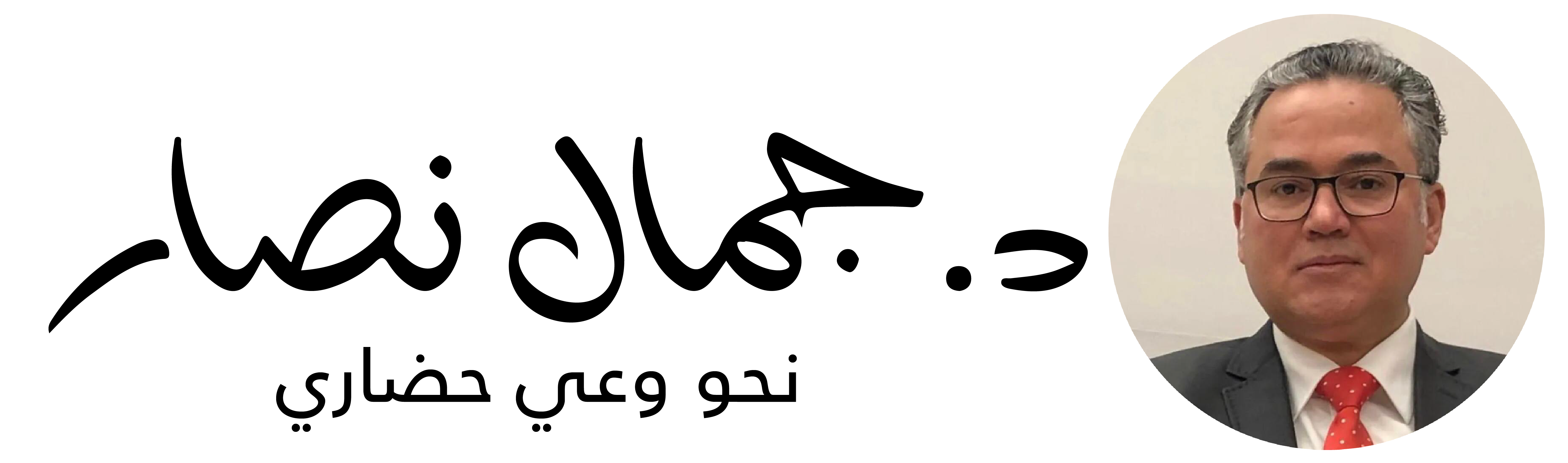الفترة القصيرة القادمة ستشهد تحولًا مهمًا في علاقة تركيا بالغرب، وخصوصًا بعد الانتخابات التركية المُبكرة؛ المزمع إجراؤها يوم الأحد الموافق 24 يونيو/ حزيران من العام الجاري، حيث إن هذه العلاقة تستقر أحيانًا، وتتوتر أحيانًا أخرى، وفي الغالب يكون التوتر هو سيد الموقف، نتيجة لمواقف الرئيس أردوغان القوية الداعمة لحقوق الشعوب المظلومة، متصديًا لتعنّت الغرب ودعمه للأنظمة المستبدة في المنطقة العربية، ومعبرًا عن رفضه لسياسات الغرب العدائية للمسلمين في أماكن مختلفة.
والسؤال الجوهري ماذا يريد الغرب من تركيا – أردوغان، وهل ترغب الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لتركيا موقفًا قويًا في منطقة الشرق الأوسط، أم أنها تريد لتركيا أن تكون تابعة وذليلة مثل باقي دول المنطقة؟!
تمثل تركيا أحد المفاتيح المهمة لفهم السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وذلك ليس فقط بسبب البعد الجيو – استراتيجي لتركيا والذي أعطاها ميزة تنافسية عالية، وإنما أيضًا بسبب قدرة تركيا الفائقة على تقديم نفسها للغرب والولايات المتحدة باعتبارها الشريك الأمثل الذي يمكن الاعتماد عليه في منطقة بالغة الأهمية والحساسية بالنسبة للغرب عامة والولايات المتحدة خاصة.
والمتتبع للواقع يجد أن هناك تغيرًا حدث في ديناميات البيئة الدولية في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وما فرضته من أدوار جديدة للقوى التقليدية ومنها تركيا، وبسبب إدراك الأتراك أنفسهم لطبيعة هذا التغير، وسعيهم للتعاطي معه وفق رؤية مغايرة وأدوات مختلفة زادت من حضورهم ورفعت من حظوظهم الإقليمية والدولية.
وكذلك التحول الذكي الذي مارسته حكومة “العدالة والتنمية” في سياساتها الخارجية بإعطاء مزيد من الاهتمام للشرق الأوسط ليس فقط باعتباره مجرد “حديقة خلفية”، وإنما باعتباره أحد المنافذ المهمة لتركيا في حال رفض الاتحاد الأوروبي عضويتها به.
وقد انطلقت تركيا في تعاملها مع الدول العربية والإسلامية من عدة أسس أهمها:
- محاولة التصالح مع الإرث الإسلامي والعثماني في الداخل والخارج، دون أن يعني ذلك محاولة أسلمة الداخل التركي، أو الدخول في تحالفات أممية على المستوى الخارجي، وإنما محاولة تصحيح الصورة العربية عن تركيا كقوة غربية مقطوعة الصلة بمحيطها الجغرافي والاستراتيجي.
- محاولة إيجاد مسافة واضحة مع التوجهات والسياسات الغربية في المنطقة، والاعتماد على الذات في تحسين العلاقة مع دول الشرق الأوسط بعيدًا عن العباءة الغربية.
- الدخول بقوة على خط الصراعات في المنطقة، ليس من أجل تفجيرها وإنما لمحاولة تهدئتها والقيام بدور الوسيط “المبرّد” للخلافات المتصاعدة في المنطقة
- تجنب الدخول في لعبة الاصطفافات والمحاور الإقليمية مع الانفتاح على كافة اللاعبين بما يعظّم الصورة التركية كوسيط محايد، مع تجنب الانزلاق لمعارك دينية أو مذهبية في المنطقة.
كل هذا زاد من حدة التوتر بين الغرب وتركيا، التي تريد أن تتبوأ مكانتها وتسترد قوتها وعافيتها. ويمكن القول إننا نعيش إرهاصات علاقة جديدة آخذة في التشكُّل، تكون فيها تركيا أبعد عن الغرب، من دون قطيعة معه، وأقرب إلى روسيا من دون تحالف تام معها؛ فتركيا تعيش في محيط جيو- استراتيجي مُعقّد، وتحالفاتها الغربية، بصيغتها السابقة، لا تضمن لها المظلّة الحمائية التي ترجوها، ومن ثمّ فإنها تجد نفسها مضطرة إلى مجاراة تَبدّل التحالفات والخصومات في المنطقة.
لكن من الواضح أن العلاقات الأميركية – التركية تحديدًا، على الرغم من بعدها الاستراتيجي والحيوي للطرفين، لم تعد محكومة بالقواعد الناظمة لها في فترة الحرب الباردة، فواشنطن لم تعد تتصرف وكأنها تقود حلفًا أو محورًا بقدر ما تتصرف انطلاقًا من مصالحها وأجندتها الخاصة، حتى لو تعارضت مع مصالح الحلفاء.
كما أن تركيا اليوم ليست كما كانت في السابق، مجرد شرطي أو مخفر أمامي للولايات المتحدة والحلف الأطلسي، فلأردوغان تطلعاته وطموحاته التي تخدم بلده والمنطقة، وتتجاوز حدود الرؤية الأميركية، وبين التحولات في الحالتين ثمة تفكيك لبنية العلاقة القديمة، من دون معرفة إن كان ما سبق سيؤدي إلى تفكيك هذه العلاقة التاريخية، لكن الثابت أنها انتقلت إلى مرحلة جديدة لجهة الدور والوظيفة.
وعلى الجانب الأخر لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تتخلى عن تركيا، على الأقل في المدى المنظور، لأن البديل هو ترك فراغ يملأه الحلف الروسي- الإيراني في المنطقة.
تركيا – أردوغان والأيادي الخفية
نجاح أردوغان في السنوات الماضية حطّم ما صاغه الغرب، وسعت إدارات تلك الدول لتخويف شعوب العالم من الإسلاموفوبيا، ولذلك كان لا بد من إيجاد تنظيم متوحش يتموضع في أهم منطقة حضارية “سوريا – العراق”، ويعطي صورة سلبية عن الإسلام، وقد لعب تنظيم “الدولة” هذا الدور المرسوم له على أكمل وجه.
كما عملت الأنظمة العربية وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية على دعم الثورات المضادة، وخصوصًا في مصر وليبيا، وتفجير اليمن، ودعم النظام الفاشي في سوريا، وإحداث اضطرابات في تونس، حتى لا تستقر دول الثورات العربية وتنال حريتها التي سعت إليها.
ورأت هذه الأنظمة أن نهاية الربيع العربي لا تكون بنهاية الثورات وإعادة إنتاج الأنظمة الاستبدادية فحسب، بل لابد من إنهاء النموذج الملهم لها المتمثل في تركيا، وهذا يتسق تمامًا مع الرغبة الصهيونية التي لا تريد للشعوب العربية الحرية والاستقلال.
وهذا التدخل السافر من تلك الدول في الشأن الداخلي التركي بدأ وتضخّم منذ أحداث ساحة تقسيم 2013 والتي عمل الإعلام التابع لهذه المنظومة على تصويرها على أنها ثورة ضد أردوغان، ثم جاء دعم التنظيم الموازي، وعلاقة غولن ببعض الدول العربية، فضلاً عن إقامته في أمريكا، ثم كان الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز 2016.
ومن المعروف أن الانقلابات العسكرية هي إحدى أساليب وكالة الاستخبارات الأميركية السي آي إيه والسلاح الذي تهدد به أمريكا خصومها، وقد بدا الإعلام التابع لمدبري الثورات المضادة في العالم العربي داعمًا لذلك الانقلاب ومبشرًا بنهاية أردوغان! وظهر ذلك جليًا في الإعلام المصري المأجور والمدعوم من دولة الإمارات، وعندما فشل الانقلاب كان لابد من ورقة أخرى، ورقة الأكراد ودعم حزب العمال الكردستاني ( PKK ) في سوريا بالمال والسلاح وصناعة جيب انفصالي جنوب تركيا، ومن ثمَّ استنزاف تركيا والعمل على تقسيمها لإنشاء دولة كردية ضمن رؤية هذا الحزب الانفصالية .
ومن الأسباب الجوهرية أيضًا وعلينا عدم إغفالها تتمثل بوجود دولة سنية قوية تشكل مرجعًا للسنة أو شعورًا بالحماية، وظهر ذلك من مواقف تركيا الداعمة للشعوب المسلمة في كل مكان، وهذا السعي لا ترغب فيه الولايات المتحدة الأميركية بقيادة ترامب، لأنها تريد أذنابًا وأتباعًا ووكلاء لها من السنة، تقوم بتقليم أظافرهم وتكبدِّهم خسائر هائلة كما فعلت مع السعودية!
إن نجاح أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة علامة مهمة لاستقرار تركيا وازدهارها في جميع المجالات، وتبوئها المكانة التي تستحقها، وسيربك حسابات الدول التابعة للنفوذ الأميركي الصهيوني في المنطقة، ويجعل الأموال الطائلة التي ينفقونها تذهب هباءً، وتكون خزيًا وعارًا وحسرة ًعليهم، وخصوصًا أن حزب العدالة والتنمية شَرُف بالفوز في 5 انتخابات عامة، وفي 3 استفتاءات، و3 انتخابات محلية، وفي انتخاب رئاسي واحد، والسر خلف هذه النجاحات هو أنّ الجميع عندما كانوا يقدِّمون التهاني للرئيس أردوغان لفوزه في استفتاء 16 أبريل/ نيسان 2017، كان يردّ ويقول لهم: “الأمر المهم هو انتخابات 2019”.