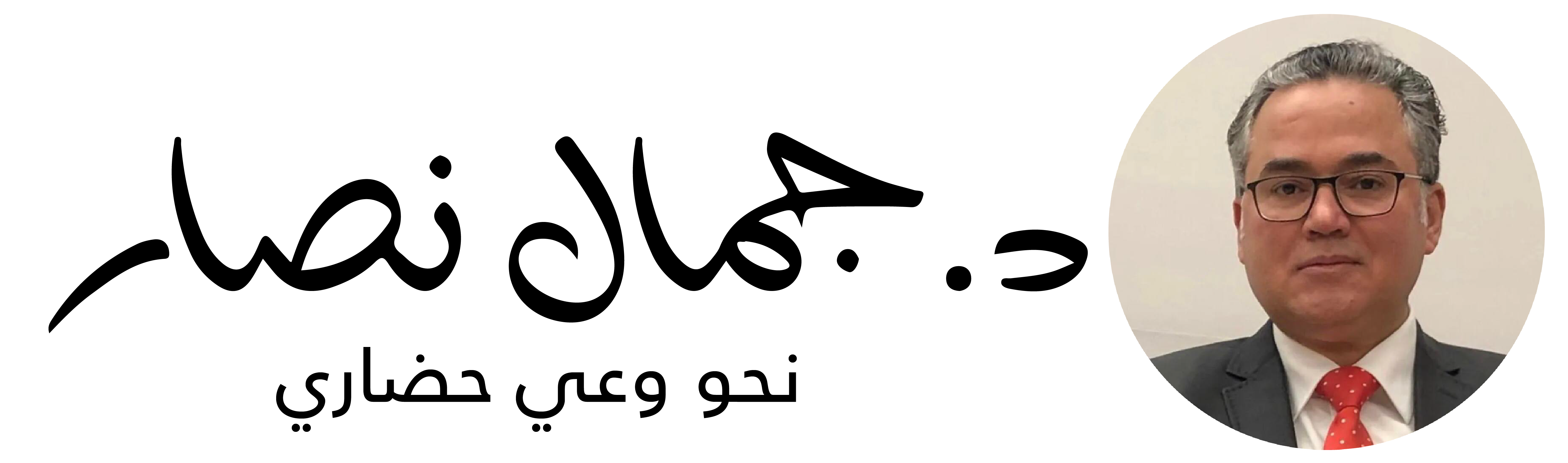في معرض حديث القرآن عن النشأة الأولى للوجود الإنساني يسوق الله الناس جميعًا سوقًا واحدًا؛ إذ يشملهم بضمير جمع واحد، يوحدهم في أصل النشأة ومراحل النشوء على السواء: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا) (غافر: 67). فالناس مخلوقون من تراب، مُزِج بالماء فكان طينًا يجسد المبدأ المادي للإنسان الأول: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب) (فاطر: 11)
فكانت وحدة الأصل، ثم أراد الله لهذا الأصل التنوع، فخلق منه الأنثى، ثم كانت مشيئة الله أن جعل البشرية من التقاء الأصل الأول بالجزء المأخوذ منه، فكان الإنسان من نطفة أمشاج ومن عظيم آيات الله خلق الإنسان من نطفة، وأقرب شيء إلي هذا الإنسان نفسه، وفيه من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى.
ولا يستثنى من هذا الأصل إنسان، وإن يكن من زمرة المصطفَين الأخيار: (قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) (إبراهيم: 11)، وإن كان الأنبياء اختصوا ببعض الصفات التي تؤهلهم لحمل أمانة التبليغ، قال بعض حكماء الإسلام: “إن الإنسان لو لم يكن في نفسه وبدنه مخصوصًا بخواص شريفة علوية قدسية، فإنه يمتنع عقلاً حصول صفة النبوة فيه”.
أسس التمييز بين البشر
التمييز بين البشر على أساس خِلْقي، أو مادي، أو وفق معيار مصطنع أمر غير مُبَرَّر في المنظور الإسلامي، بل يصادم وحدة النفس التي ينصبها القرآن مبدأ وجوديًا يتلاقى عليه الناس أجمعون: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) (النساء: 1)، من نفس واحدة، وهي آدم، عليه السلام “وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا” وهي حواء، عليها السلام، خُلقت من ضِلعه الأيسر من خلفه وهو نائم، فاستيقظ فرآها فأعجبته، فأنس إليها وأنست إليه.
وهذه النفس الواحدة هي المعنى الأهم والأجمع الذي يثيره القرآن أمام التصور الإنساني، مشيرًا إلى وحدة الطبيعة الإنسانية، على رغم الزوجية التي تستنبطها (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) (الحجرات: 13).
ووحدة الأصل هذه تدعو الإنسان إلى التفكر والتدبر، كيف بالبشرية اليوم تتناحر وهم إخوة، كيف بهم يقتل بعضهم بعضًا وهم أبناء أب واحد، وأم واحدة! إن وحدة الأصل تدعو البشرية مهما اختلفت أديانهم أو مللهم إلى الاتحاد في إقامة عمران وصنع حضارة.
لذلك – تأسيسًا على مبدأ وحدة الأصل- كان التكريم في المنظور الإسلامي “لازم من لوازم الوجود الإنساني، أي أن الإنسان ليس مجرد مخلوق ككثير من المخلوقات بل هو مخلوق مُكرّم، شريف نفيس وذو امتياز نوعي، والكرامة نعت لصيق به منذ مفتتح وجوده، وقصدي أن معنى التكريم قضاء حاصل في ضمن أمر التكوين الذاتي لهذا الجنس من المخلوقات، ودونك النصَّ الذي يقرر هذه الحقيقة بمنطوقه، وصريح دلالته: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ) (الإسراء: 70)، فالفعل كرّم جاء بالتضعيف، أي: جعلنا لهم شرفًا وفضلا، وهذا الكرم هو كرم نفي النقصان عن بني آدم”.
تكريم الله للجنس البشري
قضاء الله بتكريم جنس البشر لحظة إيجادهم، تكريمًا من حيث الصورة والمعنى، وقضى لهم بأسباب الرفعة والفضل قضاء مبرمًا: (وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) (الإسراء: 70)، والتفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الإنسان ربه ويفهم كلامه، ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله، إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب.
وليس التفضيل في هذا السياق مرادفًا للتكريم، بل هو مخالف له من جانب العموم والخصوص، فالتكريم منظور فيه إلى تكريم الإنسان بذاته، أي بما فيه من خصائص ذاتية، أما التفضيل فمنظور فيه إلى تشوفه من بين سائر الكائنات، وما أودع الله فيه من قوة تعلم؛ إذ كل إنسان يستطيع أن يضيف إلى العلم شيئًا، فتكثر العلوم، وتقوى الفضائل والمعارف؛ ولكي يحقق الإنسان هذا المقصد ذلل الله له كل شيء وسخره، حتى صار الإنسان في المعمورة كالرئيس المخدوم.
ذلك، وقد خصّ الله الإنسان في خِلقته دون سائر خلقه؛ فقد خص الملائكة بالقوة الروحية العقلية الحكيمة دون الشهوة، وخص البهائم بالشهوة دون القوة الروحية العقلية، ولم يخص الجمادات والنباتات بشيء من ذلك، وخص الإنسان أن زوده بالقوة العقلية الحكيمة التي توصله بربه، وبالشهوة التي تؤهله لعمارة الأرض وسكنتها.
فقد فضّل الله الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية، مثل: العقل والنطق والصورة الحسنة والقامة المديدة، ثم إنه تعالى عرَّضه بواسطة ذلك العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة، والأخلاق الفاضلة، فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل. وعلى هذا، يكون التكريم والتفضيل كلاهما معنيين متكاملين، يكمل أحدهما الآخر، لا مترادفين سِيقا لمجرد التوكيد فحسب.
قيمة العقل لحياة الإنسان
إمداد الإنسان بالعقل والإدراك للبحث والنظر في نفسه، وفيما يحيط به من ملكوت السماوات والأرض فينمو شعوره الفطري ويمتلئ قلبه بنور الإيمان، فيسلك السبيل الواضح الذي لا غموض فيه ولا التواء، سبيل الأمن والاطمئنان، سبيل الحياة الطيبة، والسعادة النفسية الراضية، ويصل في الوقت نفسه ببحثه ونظره إلى معرفة أسرار الكون، وما أودع فيه من وسائل التقدم، ومواد العمارة لهذه الأرض، التي جعله الله خليفة فيها.
لكن الأوهام التي كانت تملكه في أوقات غفلته، وضعت على عقله حجابًا كثيفًا منعه من التوجه إلى هذا الكون وخوض غماره، وبذلك ربط نفسه بالخرافات والأوهام، فسلب فائدة العقل والإدراك ، وانقاد لما لا يسمع ولا يبصر، وظل يدور حول نفسه، لا يعرف في الحياة إلا ما يلبي غرائزه الحيوانية، وميوله النفسية الفاسدة، فيرسل الله الرسل لتعيده إلى جادة الطريق: (أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) (النحل: 36).
ورسم له الطريق التي تسير على وتيرة واحدة، ليتتبع الأسباب، ويبني الحضارات؛ تلك السنن الإلهية والقوانين الربانية التي تحكم مسيرة الحياة على المعمورة، وتجري وفقها المجتمعات والحضارات تقهقرًا وشهودًا، لم يكن العرب ليهتدوا إليها في نظامهم القبلي الذي كان يحكمه السلاح، بل إن تلك السنن وهذه القوانين نقلة بعيدة في تاريخ البشر، لم تنبع من معيشة العرب البدوية، ولم تنشأ مقتضيات حياتهم العربية في ذلك الزمان، وإنما هي نقلة بعيدة في تاريخهم وتاريخ البشرية، حملتها إليهم العقيدة الإسلامية، التي ارتقت بهم في فترة وجيزة.
ومن ثمّ لو فهم الإنسان طبيعة خلقه، ومهمته في الحياة التي من أجلها خلقه الله، لما كانت كل هذه الصراعات والحروب التي تُهلك الحرث والنسل، ولو علم الظالمون عاقبة ظلمهم واستبدادهم لما فعلوا ذلك أبدًا!