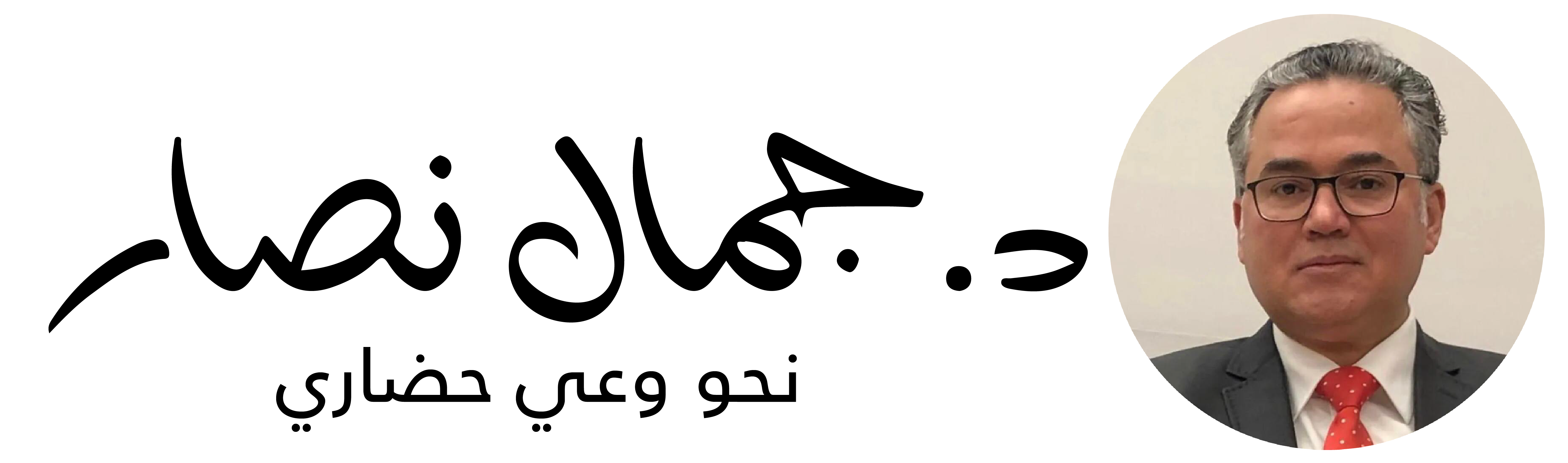قامت فكرة القمة العربية في الأساس، منذ تأسيسها في العام 1946 من أجل فلسطين، وتحريرها، وحماية مقدّساتها من الاحتلال الإسرائيلي، ومن كل أعمال التهويد التي يمارسها الصهاينة على مر العصور، وكذلك كان الهدف من منظمة التعاون الإسلامي التي أُنشئت في عام 1969، بغرض النظر إلى القضية الفلسطينية، وقت حَرْق المسجد الأقصى، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية والدفاع عن المسلمين والإسلام في جميع أنحاء العالم، كما كان تأسيس مجلس التعاون الخليجي في العام 1981 من أجل مواجهة التحديات التي تقابلها تلك الدول، وإيجاد صيغة للتعاون المشترك فيما بينها.
ومن المُفارقات العجيبة أن فلسطين غابت عن قمم مكّة الثلاث بشكل كامل، واحتلّت المقاعد الخلفيّة فيها، وحلّ محلها التطبيع مع دولة الاحتلال تحت مظلّة أمريكيّة معزّزة بحاملات الطائرات والقاذفات والمدمرات البحريّة، مع استمرار الحصار الظالم لدولة مؤسسة لمجلس التعاون الخليجي (قطر)، وحصار الشعب الفلسطيني وتجويعه، وتوطين الاستبداد والفساد في المنطقة.
مواجهة إيران
ولم يكن الهدف من كل هذه القمم إلا مواجهة إيران العدو المُصطنع، والبعبع الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية لابتزاز الدول الخليجية، للسيطرة عليها، وجرِّها للانصياع الكامل للمخطط الأمريكي في المنطقة بتمرير ما يسمى (صفقة القرن).
ولا أعتقد أن مواجهة إيران تحتاج إلى ثلاث قمم، لأنّ هذه المسألة خلافيّة، ولا تحظى بأيّ إجماع، أو حتّى شبه إجماع إسلامي، أو عربي، أو حتّى خليجي، ولذلك فإنّ مُعظم المُشاركين فيها شاركوا من باب مُجاملة السعودية، الدولة الداعية، لا أكثر ولا أقل، ويُظهرون ما لا يُبطنون من مواقف وآراء.
والملاحظ أن جميع القمم العربيّة والخليجيّة والإسلاميّة التي انعقدت في السنوات الأخيرة، كانت هزيلة على مستوى الحضور، وعلى مُستوى النتائج، ولم تزد عن كونها حفل عشاء أو عذاء جماعي، وبعض الخطابات الانشائيّة المُملّة، وسط حُضور مُعظمه يغط ّبالنّوم، ولفترة زمنية لم تزد عن ساعات محدودة، ولا أظن أنّ قمم مكّة الثلاث كانت استثناء في ظِل حالة الاستقطاب والانقسام التي تسود المنطقة العربيّة، مع زيادة وتيرة التآمر الثلاثي المتمثل في (ابن زايد، والسيسي، وابن سلمان)
وللأسف هذا التوتّر الراهن والمُتصاعد في منطقة الخليج العربي يعود في الأساس إلى رغبة الإدارة الأمريكيّة الحاليّة لممارسة كُل الضّغوط السياسيّة والاقتصاديّة والعسكريّة المُمكنة من أجل إجبار إيران للتخلّي عن كُل طُموحاتها النوويّة، وجرِّها للتفاوض والإذعان، للحفاظ على التفوّق العسكريّ الإسرائيليّ، وإبقاء (إسرائيل) دولة نوويّة وحيدة، ومُتفوّقة، تُهدّد جميع جيرانها في منطقة الشرق الأوسط، وتكرّس احتلالها للأراضي العربيّة ومُقدّساتها.
أقول إن أيّ قمم عربيّة، أو إسلاميّة، أو خليجيّة لا تتصدّى لمُؤامرة تهويد القدس المحتلة، والمسجد الأقصى، ووقف الحُروب في سورية واليمن وغزّة وليبيا، وتنتصر للقضيّة العربيّة المركزيّة الأولى، وهي قضية فلسطين، وتُعلن موقفًا رافضًا واضحًا لصفقة القرن، ومشروع إقامة إسرائيل الكُبرى، ولا تُحرّم التّطبيع مع المُحتل، وتدعم رغبات الشعوب في التحرر والكرامة الإنسانية والعيش الكريم، لا تستحق اسمها، ولا حتّى انعِقادها في مكّة المكرّمة، أطهر بِقاع الأرض، وأكثرها قدسيّة عند المسلمين.
عسكر السودان على خطى سيسي مصر
في فجر أخر ليلة من رمضان أقدم المجلس العسكري في السودان على فض اعتصام الثوار أمام القيادة العامة، بطريقة وحشية، وأضرموا النار، وأطلقوا الرصاص على الثائرين لإجبارهم على فضّ الاعتصام، وللانقلاب على ثورة الشعب السوداني، مما أدى إلى قتل العشرات، وإصابة المئات، حتى الآن.
هذا العمل الإجرامي ذكّرنا بجريمة القرن في رابعة العدوية وأخواتها التي ارتكبها عسكر مصر، بقيادة الجنرال السيسي، ولم تظهر هذه النية الخبيثة لعسكر السودان إلا بعد الجولات لدول الثورات المضادة في المنطقة (مصر، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية)، حيث استقبلوهم بكل حفاوة كرؤساء الدول، وليسوا كعسكريين يخوضون مخاضًا صعبًا مع شعوبهم الرافضة لبقائهم على رأس السلطة.
وأعتقد أن هذه الجريمة لم تكن مفاجئة، بل جرى التمهيد لها بإجراءات عدة اتخذها العسكر، من ضمنها التصعيد في اللهجة ضد قوى الحرية والتغيير، واتهامها بالتجرد من السلمية، وطرد قناة الجزيرة من السودان وغلق مكتبها، لتغييب المشاهد عن المجزرة التي يجري الإعداد لها.
وقد ظهرت أيادي القاهرة والرياض وأبو ظبي في تلك الجريمة، التي جرى بحثها في العواصم الثلاث، مع الدعم المالي السخيّ، والحصول على الموافقة من قبل قوى دولية كبرى، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
أقول: لا يمكن الرهان على العسكر، في تحقيق التغيير الذي تريده، وتنشده شعوب المنطقة العربية، بما فيها السودان والجزائر، الذين يقرأون من نفس الكتاب الأسود للانقلابات العسكرية في المنطقة، فالواقع والتاريخ خير مثال على ذلك، والأمل الوحيد هو وعي تلك الشعوب بما يُخطط لها، والسعي بكل السبل السلمية لاقتلاع هذه الأنظمة الفاسدة التي جثمت على صدورها لعشرات السنين.
وهناك عدة سيناريوهات يمكن أن ترسم مستقبل السودان، في الفترة القادمة:
الأول: أن يتم فرض حكم العسكر كما حدث في مصر، ومواجهة الثوار بكل عنف، وتشويه صورتهم، واعتقال قياداتهم، وتغييب وعي الشعب بإعلام مأجور، والسيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة بفرض الأمر الواقع.
الثاني: أن تتحول السودان إلى دولة فاشلة كما هو الحال في ليبيا واليمن، وهذا سيناريو لا تعارضه أبو ظبي أو الرياض، بحجة مواجهة الإرهاب (المُصطنع)، ولكن مصر لا ترغب في هذا السيناريو؛ لأن ذلك سيؤثر عليها بحكم الجوار.
الثالث: أن يعيد السودانيون إنتاج ثورتهم من جديد ويقفوا في وجه العسكر؛ الذين يسعون بكل السبل للسيطرة على مقاليد الأمور، وبذلك يصل السودانيون ببلدهم إلى حيث يريدون، لا إلى حيث يريد العسكر ومن يقف وراءهم.
وعليه يجب ألّا تترك قوى الحرية والتغيير، والقوى السياسية في السودان المشهد للعسكر الذي يُدار من العواصم الثلاث (القاهرة، وأبو ظبي، والرياض)، بل عليهم استخدام كل الخيارات السلمية مثل: العصيان المدني، والإضراب المفتوح في كل مؤسسات الدولة، وتوعية الشعب السوداني بخطورة المرحلة، وضرورة تكاتف كل الجهود لتحقيق أهداف الثورة كاملة.
أقول، مرة أخرى، لن يحقق الشعب السوداني آماله وطموحاته إلا بعد إزاحة كل العسكر التابعين والمتآمرين على الثورة السودانية، وبذل كل الجهود لتوحيد صفوف قوى التغيير، لتحقيق أهدافهم من الحرية والكرامة والعيش الكريم، من خلال الدولة المدنية التي ينشدونها.
وكما قال الشاعر:
عناية الله لا تُبقي على دولٍ يلقى الخلائق منها الويل والحربا
ترى الشّعوب عبيدًا لا ذمام لها وتحسب الحقّ في الدّنيا لمن غلبا
لا بد للشّعب والأحداث تأخذه من غضبةٍ تفزع الأفلاك والشُّهُبا