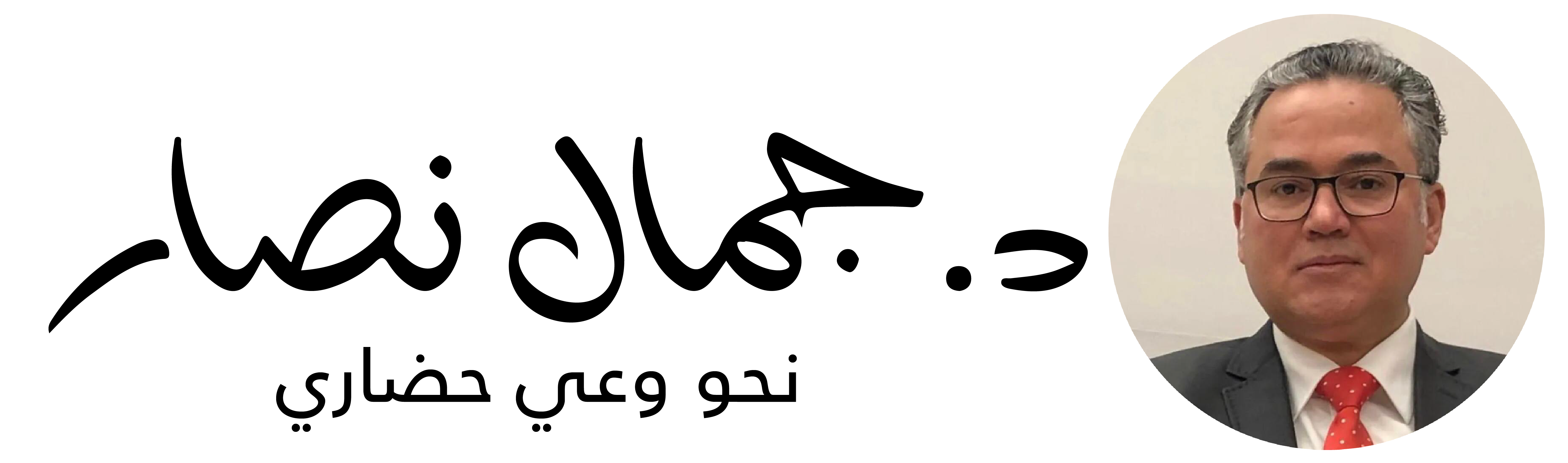د. جمال نصار
جاء انتخاب قيس سعيد لرئاسة الجمهورية التونسية على غير التوقعات، حيث إنه لا ينتسب لأي حزب سياسي، ولم يكن له سابق دراية بالعمل السياسي، وكل مؤهلاته أنه أستاذ جامعي في القانون، ويتحدث اللغة العربية بطريقة غير معهودة على المتحدثين والممارسين للسياسة في الوطن العربي.
ولم يخطر ببال من انتخبوه أن يصل بتونس إلى ما وصلت إليه الآن، وكان الدافع الأساس للشعب التونسي هو التغيير من النخبة السياسية الحاكمة التقليدية التي ملّ منها التونسيون إلى وجه جديد علّه ينقذ البلد من التخلف الاقتصادي، والتجاذب السياسي بين الأحزاب بشتى أشكالها وأيدولوجياتها.
ولم يتوانَ سعيد أثناء حملته الانتخابية عن انتقاد النخبة الحاكمة، كما أثار الجدل برفضه قانون المساواة في الميراث بين الذكور والإناث. كذلك كرر مقولته: “قضاء مستقل خير من ألف دستور” مرارًا، ويؤمن بأن الشعب نفسه هو من يجب أن يضع الخطط والاستراتيجيات الفكرية والاقتصادية التي تحرك الوطن بعد الثورة، قائلًا في حوار صحفي، “السلطة ستكون بيد الشعب الذي يقرر مصيره ويسطّر خياراته”.
وانطلق برنامجه في تقديم تصور جديد للمجتمع ويقوم هذا التصور من المحلي إلى الجهوي ثم إلى المركزي حتى تكون التشريعات الوطنية تشريعات تعبر عن إرادة الشعب، كما تحدث عن تعديل الدستور، ومكافحة الفساد.
وما إن استلم السلطة بعد فوزه بالانتخابات في العام 2019، أراد أن يعيد تشكيل الحياة السياسية بطريقته التي لم تتواكب مع الواقع السياسي في تونس، واصطدم مبكرًا مع الأحزاب السياسية، ،خصوصًا النهضة ذات الأغلبية في مجلس النواب، ولم يستقر به المقام إلا بعد اختياره لرئيس الوزراء بنفسه، ووقع اختياره على القاضي هشام المشيشي، الذي كان مستشارًا له في القصر الرئاسي.
ومع ذلك لم تستقر الأوضاع في تونس، وامتنع عن اعتماد التشكيل الوزاري بحجة احتوائها على بعض رموز الفساد من النظام السابق، وشعر بعد ذلك أنه مُهمّش من قبل البرلمان والحكومة، وانتهى به الأمر إلى الانقلاب على الحياة الديمقراطية بمجملها، في 25 يوليو/ تموز الماضي، وأجبر رئيس الحكومة الذي اختاره على الاستقالة، وجمّد أعمال البرلمان لمدة 30 يومًا، ووضع سلطة النيابة العامة تحت إمرته وسلطته المباشرة، بحيث أصبحت السلطة التنفيذية، بجناحيها الرئاسي والحكومي، وصلاحياتها كافة تحت سيطرته.
ويرى قيس سعيد أن ما قام به لا يُعدّ انقلابًا على النظام الديمقراطي، أو خروجًا على القانون، وأنه تصرّف في حدود ما تقضي به المادة 80 في الدستور التونسي، ولكنه فسّرها بطريقته الخاصة، لتبرير انقلابه على المسار الديمقراطي، مع العلم أن معظم الدستوريين والقانونيين في تونس أدانوا تفسيره وأفعاله. واستنكر يوم الاثنين الماضي 45 من القضاة، في بيان لهم، بشدة الإجراءات التي أعلنها الرئيس في الخامس والعشرين من يوليو/ تموز الماضي، معتبرين أنها غير اعتيادية، وغير مسبوقة على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين.
من وراء انقلاب قيس سعيد على ديمقراطية تونس؟!
تعتبر تجربة التحول الديمقراطي في تونس، الوحيدة التي أفلتت من كوارث ألمّت بتجارب مماثلة انطلقت مع “ثورات الربيع العربي” منذ أكثر من عشر سنوات، حيث نجحت في إقامة نظام ديمقراطي مكتمل الأضلاع، يتضمن دستورًا تمّ تبنّيه بالتوافق والرضى العام، ورئيسًا للدولة منتخبًا بالاقتراع المباشر، وسلطة تشريعية ممثلة لأغلب التيارات السياسية والفكرية في المجتمع التونسي.
والأهم أن هذا النظام الديمقراطي استطاع، على الرغم مما مرّ به من تقلبات وتجاذبات ومنعطفات حادّة، توفير مناخٍ من الحريات العامة، وكفالة حقوق الإنسان تحسُده عليه كل الدول والأنظمة العربية الأخرى. ولكن سرعان ما تبيّن أن توفر معظم متطلبات الشكل الديمقراطي في النظام الحاكم لا يضمن، بالضرورة، قوة الدولة التي يديرها هذا النظام، ولا فاعليتها وكفاءتها، ما أدّى إلى تعرّض الدولة التونسية، خصوصًا في ظل استمرار جائحة كورونا، إلى هزّاتٍ تنذر بانهيارات سياسية واجتماعية وصحية حادّة، وتفسّر، إلى حد كبير، لجوء الرئيس إلى الإجراءات والقرارات الاستثنائية التي أقدم عليها أخيرًا، حسب زعمه.
وتشير أصابع الاتهام إلى أن الإمارات العربية المتحدة، وراء “انقلاب” الرئيس قيس سعيد على الدستور، لأنها مصممة على إنهاء الربيع العربي، الذي انطلق من تونس عام 2011، وهذا ما فعلته في مصر بالتحضير للانقلاب العسكري، ودعمه بكل الإمكانيات على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث بشكل ديمقراطي. وهذا ما أشار إليه سعيد نفسه في أحد تصريحاته؛ أن هناك بعض الدول في المنطقة تدعمه ماليًا وعسكريًا!
وكان آخرها زيارة أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي السابق، مع وفد رفيع المستوى، يوم الأحد الموافق (8-8-2021)، الذي صرّح بأن “الإمارات تتفهم القرارات التاريخية لرئيس الجمهورية وتدعمها، وهي تدرك أيضًا أهميتها للحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة شعبها”.
فالإمارات تحاول منذ فترة حصار ومحاربة التيار الإسلامي في كل ربوع العالم العربي، ولم تدّخر أي جهد إلا وفعلته، وأنفقت مليارات الدولارات لتحقيق أهدافها، وأخذت على عاتقها السعي للقضاء على فكرة الربيع العربي التي بدأت في تونس مثلما انطلقت منها.
والغريب أن الإمارات من أكثر الدول المطبِّعة مع (إسرائيل)، والرئيس سعيد في أكثر من تصريح وموقف، قال: “من تكون له علاقة مع الكيان المغتصب فهو خائن وخيانته خيانة عظمى”، فكيف يتم فهم هذا التحول الجذري في المفاهيم، وهل لا يزال التطبيع خيانة عظمى بالنسبة له؟!
وكان لزيارة قيس سعيد للقاهرة، في وقت سابق، تهيئته للانقلاب على التجربة الديمقراطية، طالما أن الإسلاميين يتصدرون المشهد السياسي، وتأكيد ذلك بزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري في الآونة الأخيرة، واحتفاء الإعلام المصري والإماراتي بهذه التحركات، والقرارات التي صدرت عن الرئاسة التونسية، واصفًا ما حدث في تونس “بالانتفاضة التونسية والاستقلال الجديد للتخلُّص من الإخوان المسلمين”.
وكذلك زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل الفرحان لتونس وإعلانه وقوف المملكة بجانب هذه الإجراءات، ناهيكم عن صمت المجتمع الدولي على هذا الإجراءات التي تخالف الديمقراطية، وتمهِّد لحكم الفرد والاستبداد، وعدم شجبه أو إدانته بالشكل المطلوب، بل وصل الأمر ببعض الدول، مثل فرنسا إلى الإشادة والدعم.
السيناريوهات المتوقعة بعد انقلاب سعيد
جاءت خطوة سعيد المفاجئة بعد يوم من الاحتجاجات ضد الحكومة وحزب النهضة؛ عقب الزيادة الكبيرة في الإصابات بفيروس كورونا، وتزايد الغضب من الخلل السياسي المزمن والمشكلات الاقتصادية، ويُشكل هذا أكبر تحدٍّ حتى الآن لتونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة “الثورات العربية”، وأطاحت بالحكم المطلق لصالح الحكم الديمقراطي لكنها فشلت في تحقيق الحكم السليم أو الرخاء.
ولعل المشهد العام في تونس حتى اللحظة يُنبئ بأن السيناريوهات المتوقعة يمكن أن تدور في ثلاثة أطر أساسية، وأظن أن الرئيس لن يتراجع عن قراراته، وستشهد الأيام والشهور القادمة إلى أي السيناريوهات تسير تونس:
السيناريو الأول: يمكن أن يكون من خلال البحث عن مخرج دستوري أو استفتاء على قرارات الرئيس، أو انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة، وهذا أمر يدور حوله الصراع الآن، وهذ الحل يعني العودة إلى نقطة الصفر، والابتعاد عنه يعني غياب خطة العمل، وبالتالي وجود أزمة سياسية مع القوى والأحزاب السياسية بكل أشكالها، وكذا المجتمع المدني. وهذا السيناريو يعتبر أخف الأضرار.
السيناريو الثاني: إطالة الأزمة وفرض حالة الطوارئ، وتعطيل الحياة السياسية والمدنية خلال فترة رئاسة سعيد لتونس، وهو الخيار الأمثل لقوى الثورة المضادة، وهذا ربما يجنبها الكلفة المرتفعة، وتحمُل كامل التبعات الاقتصادية والسياسية، ويعتبر أقل صدامية مع المجتمع الدولي، لحين البحث عن مخرج أو حل. ولكن هذا السيناريو سيشكل أزمة سياسية ومجتمعية في تونس.
السيناريو الثالث: الذهاب إلى انقلاب عسكري كامل وصريح، مثل النموذج المصري، وقمع الحريات، وتكميم الأفواه، وهذا مكلف اقتصاديًا وسياسيًا، ويحتاج إلى ممولين لأمد طويل، وأظن أن ذلك ممكنًا، وخصوصًا مع دعم الإمارات والسعودية للثورات المضادة، ومن ثمّ يتطلب قدرًا كبيرًا من الوحشية والقمع، وهذا بالتالي يؤدي إلى الفوضى، لإمكانية اعتراض المجتمع المدني التونسي لهذا السيناريو. ولا أستبعد ذلك شخصيًا، لحالة الانتقام التي تتمتع بها الثورة المضادة في القضاء على ما تبقى من الثورات العربية.
فهل سيكون للشعب التونسي رأي آخر ويُعطّل كل هذه السيناريوهات، ويكون هو السيد على الأرض، ويمتلك القدرة على الحفاظ على مكتسباته بنفسه؟، وهل تستطيع القوى والأحزاب السياسية التغاضي عن خلافاتها وتتوحّد في مواجهة هذا الانقلاب الذي سيزداد يومًا بعد يوم، وتفرض أجندتها للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية؟، أم أن الثورة المضادة بكل عنفوانها، وما تقدمه من دعم لقيس سعيد سيكون لها الغلبة في نهاية المطاف؟!
أتمنى، بطبيعة الحال، أن يكون للشعب التونسي الريادة في قلب الموازين لصالحه، ويُخيّب آمال أمراء الثورة المضادة، مثلما حدث في تركيا، حينما انتفض الشعب التركي، لمواجهة الانقلاب العسكري في 15 من يوليو/ تموز العام 2016، وقدّم التضحيات لاسترداد ديمقراطيته بنفسه، وعدم الاعتماد على الخارج، وآمن بأن الحرية لا توهب، ولكنها تنتزع.
وفي الختام أقول: إن الاستبداد هو فرض إرادة الفرد وحاشيته على المجتمع، وكسر إرادته، وتفريغ روحه، وتدمير إمكانيات التقدم لديه، ويزيل إرادة الشعب، ويلغي مبرر وجوده، واستباحة أموال الناس وأعراضهم وعقولهم ووعيهم، ويكمم الأفواه، ويصادر الحريات، وهو قرين الفساد الذي يقضي على الأخضر واليابس.