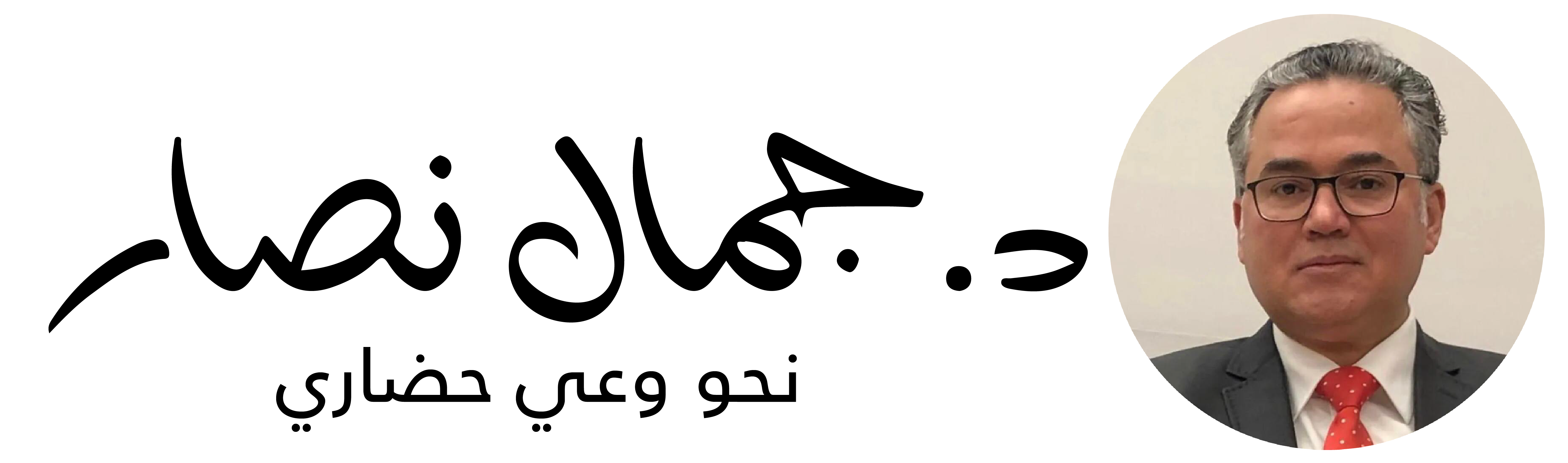د. جمال نصار
من القضايا التي كانت، وما زالت، وسوف تبقى محل جدل ونقاش على مستوى واسع قضية المرأة في الإسلام، البعض يرى أنها، مع تعاليمه مهانة، والبعض يرى أنها، مع التعاليم، مصونة مكرّمة، وما التعاليم إلا حفظ لهذا الحق وهذه الحرية، وبين هذا وذاك تحار العقول والأفكار، ويحتدم الجدل والنقاش إلى حدٍ بعيد.
لا أدرى على أي المصادر اعتمد من قالوا بإهانة المرأة في الإسلام، وما دليلهم على تلك الفرية العظيمة، إلا أن تكون إهانة في لغتهم تقابل تكريمًا في لغتنا، وإلا كان الحديث عن ذلك من قبيل “رمتنى بدائها وانسلت”؟!
لمحة عن وضع المرأة قبل الإسلام
إن المرأة لم تكن ذلك الإنسان الذي يحيا شريكًا في هذا العالم، شريكًا في الحلم، شريكًا في الحب، شريكًا في الأسرة، “فلو نظرنا إلى المرأة قبل الإسلام، لوجدنا أن اليهودية المحرّفة تعتبر حواء، ومن ثم المرأة عمومًا سببًا في شقاء الإنسانية؛ وذلك لأنها أخرجت آدم من الجنة، في زعمهم، وعرضت الجنس البشرى للتعب والشقاء، لذا نجد أن المرأة عند اليهود لا ترث إذا كان لها أخ ذكر.
وقد اقتبست المسيحية المحرّفة هذه النظرة عند اليهود، فنظرت إلى المرأة باحتقار، حتى إن المجتمعات المسيحية حتى نهاية القرون الوسطى كانت تبحث في إنسانية المرأة، إذ لم يكن هذا المبدأ قد تقرر نهائيًا بعد.
أما البرهمية فتعتبر الابتعاد عن المرأة شرطًا لدخول الجنة، وتنظر إلى المرأة على أنها مخلوق دنس، لا يستحق أن ينال شيئًا من الحقوق؛ لذا فقد كان عليها أن تحرق نفسها إذا مات زوجها. وقد وجد الاستعمار البريطاني في الهند صعوبة كبيرة في القضاء على هذه العادة. وقد كانت أهلية المرأة ناقصة حسب القانون الروماني، فقد كانت الأنوثة من أسباب الحجر، تمامًا كالصغر والجنون” (معالم الثقافة الإسلامية، د. عبد الكريم عثمان، ص271).
و”القدماء المصريون كانوا يجيزون أن يتزوج الرجل أمه وبنته وأخته… وكان أهل أثينا وإسبرطة يسمحون بتزوج الأخت غير الشقيقة، أما الأخت الشقيقة فكانوا يحرمون زواجها، وكانوا يترددون في زواج بنت العم” (عظمة الإسلام، محمد عطية الإبراشي، 2/ 233).
أما المجتمع الجاهلي في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، فلم يكن وضع المرأة فيه بأحسن حالاً من أولئك المتخبطون، حيث كانت المرأة في المجتمع الجاهلي تعنى الفقر والعار؛ لذا فقد كان الدفن حيًا، في سابقة من نوعها خلت من كل معاني الإنسانية والعقل، هو الحل المعضلة؛ حلاً لوجودها، ومعضلة للمجتمع، ورغم أن وأد البنات لم يكن سائدًا على نطاق واسع، إلا أن مجرد وجوده وصمة عار على جبين هذه الحياة.
كذلك ونتيجة لحياة القبيلة، فقد كثرت الحروب والغارات على بعضهم البعض، وكانت تقوم لأتفه الأسباب، فهم:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا
فاستحر القتل بين الرجال، وكثر السبي في النساء، فكانت تسبى لتصبح خادمة ليس لها من الحقوق شيء، ويكفي الإنعام عليها بنعمة الموت التي تحياها. وغير ذلك إذا عاشت المرأة، وكانت ذا حظ عظيم، ولم تقع في الأسر، وتزوجت ومات عنها زوجها، فإنها لا ترث، فليس لها شيء، ليس هذا فحسب، بل إنها تصير ضمن الممتلكات التي تركها الزوج الراحل إلى الجحيم، لتصبح إرثًا يتداوله الأبناء والأخوة، وكأنها والحيوان سواء!
هذا فضلاً عن حرية الرجل في أن يتزوج ما يشاء من النساء دون الرجوع إلى أزواجه، فكانوا يتزوجون بلا حساب، متنازلين بذلك عن أهم ما يميزهم… إنسانيتهم.
نحن هنا وبعقلية القرن الحادي والعشرين لا نصدق حدوث ذلك، نقرأ ذلك وكأننا نتابع أسطورة من أساطير ألف ليلة وليلة، أو مغامرة من مغامرات “أليس” في بلاد العجائب، ولكن الطامة الكبرى للإنسانية أن ذلك كان واقعًا مريرًا.
الإسلام رفع شأن المرأة
في هذه الظروف، وتلك الأوضاع ظهرت عقيدة النور إلى هذا المجتمع المهلهل الأوصال، المفكك الروابط، حيث اتخذ الإسلام وسائل عدة في العمل على تحرير المرأة ورفع مكانتها، وحرص منذ فجر الدعوة على أن تنال حريتها كاملة، فينزل القرآن في كثير من آياته؛ ليؤكد أن: (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً) (الأحزاب: 35) ، وقال تعالى أيضًا: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ) (آل عمران: 195)، فالمرأة كالرجل، وعلى هذا جاء الخطاب القرآني، وما جاء منه مباشرة للرجل كان على سبيل التغليب فحسب؛ فالإنسان، رجل أو امرأة، روح وجسد، الروح واحدة وعليها تقع التكاليف، وهى التي تتنعم بالجنة، أو تشقى في النار، والجسد مختلف؛ لحكمة الله في استمرار النوع. فالقرآن يؤكد على المساواة أمام التكاليف الشرعية والثواب الجزيل، فهذه النصوص وغيرها تعيد للمرأة مكانتها، وترد إليها حريتها، وتطالبها بالعمل الدؤوب والسعي الحثيث للفوز بالجنة والنجاة من النار، وتضع على كاهلها القيام بأعباء تلك الحرية.
وبناءً على هذه النصوص القرآنية، قررت السنة المبدأ الإنساني الذي يستحق أن يكتب بحروف من نور على جبين الزمان، وفى ذاكرة التاريخ “النساء شقائق الرجال”. ونظرًا لأن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع الإسلامي، فقد كان لزامًا عليها أن تساهم بشكل فعال في صنع هذه الحضارة، والدفاع عن هذا الدين، فكانت تخرج للصلاة في المسجد، تتلقى العلم عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وكان شرطًا من شروط صحة عقد الزواج أن تُستأذن وتوافق على هذا الزوج، وجعل لها الحق في التصرف بالمال، وكانت تمارس حقها في الدفاع عن الدين، وتخرج في الحرب، تداوي الجرحى، وتسقى الماء، بل تدافع عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
هذا الحق، وتلك الحرية، وذاك التكريم امتد إلى “أجرنا من أجرت يا أم هانئ” ليكون إكليلا من أكاليل التكريم على جبين المرأة التي لم تكن إنسانًا حتى عهد قريب، وكأنها مع الإسلام ولدت من جديد.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فالمرأة في الإسلام ليست نصف المجتمع كما يتشدقون، بل هي المجتمع كله. لقد وضع الإسلام المرأة في كفة، ورجال الأرض كلهم في أخرى. وضع الإسلام المرأة على ثغر لو اجتمع أهل الأرض على القيام به وحمايته ما استطاعوا، إنه ثغر البيت والتربية والمدرسة التي تخرِّج العظماء في هذا العالم. إنه لا يقل خطرًا عن مجالات الحياة الأخرى، بل إنه الأخطر؛ لأنه المنبع الذي تقتات عليه الحياة، فإذا فسد المنبع وتلوث مات الناس عطشًا وشقاوة.
مواقف معبرة في إنصاف المرأة
لقد قامت المرأة بالدور على أكمل وجه، ولم تكتف بموقف المتلقي لهذا الإنعام ساكنًا، وإنما كن مبادرات، لهن دور ريادي، وقد حفظ لنا التاريخ نماذج رائعة مدهشة من نساء كان لهن الدور الفعال في مساندة هذا الدين، فهذه السيدة خديجة التي واجهت الموقف، وتصدت منفردة لهذا السيل الجارف، أعطت النبي، صلى الله عليه وسلم، حين منعه الناس، وآوته حين طرده الناس، وواسته بمالها حين حرمه الناس، فكانت خير معين في هذا الطريق.
وتلك هي أم سلمة التي ضربت أروع النماذج في التضحية والفداء مع زوجها أبى سلمة، حتى كافأها الله، عز وجل، بالمصطفى، صلى الله عليه وسلم زوجًا، وجاء دورها الذي لن ينساه التاريخ حين أنقذت الموقف يوم الحديبية، فأشارت على الرسول، صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ بنفسه أولاً فيحلق، فإذا رآه الناس امتثلوا، وقد كان، ورب رأى خير من ألف سيف.
وتلك هي الشابة الواعية، ذاكرة الأمة، وحافظة التراث التي حفظت لنا حياة النبي، صلى الله عليه وسلم، وسنته وعاداته وصفاته وسلوكه في معاشه ومعاده، فحفظت لنا أكثر أحاديثه، صلى الله عليه وسلم، فقامت بالدور خير قيام فاستحقت: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة.
وغير ذلك كثير من النساء اللواتي حملن الدعوة على كاهلهن، وقمن بالدور كاملاً، انطلاقًا من الحرية التي أقرها لهن الإسلام، رحمهن الله ونفعنا بهن.
هذه هي الحقيقة، وهذا ديننا وتاريخنا، إلا أن ذلك لم يرض المستعمر الغاصب الذي “نسب إلى الغرب احترام المرأة، وإلى الإسلام احتقارها، وهكذا رمتني بدائها وانسلت، وظهرت تلك الدعاوى في كتب “تحرير المرأة”، و “المرأة الجديدة” لقاسم أمين، وناصرته في ذلك هدى شعراوي، ومن على شاكلتها. وقام في وجه هذه الدعاوى التيار المحافظ ومنه طلعت حرب، وكتابه “تربية المرأة والحجاب”، ومن أنصار هذا الاتجاه زينب الغزالي، وملك حفني ناصف “باحثة البادية” (المرأة في التصور الإسلامي، د. عبد المتعال الجبرى، ص 153).
وبذلك استطاع المحتل أن يطمس معالم ثقافتنا، ويضرب بعضنا ببعض، ليزرع في أرضنا ومن أبنائنا مخلصين له، منفذين لخططه وبرامجه، ورغم أنه عجز عن السيطرة على أرضنا، إلا أنه نجح في السيطرة على أجزاء منا وبعض عقولنا.
ويأبى الله إلا أن يتم نوره على امتداد العصور؛ ليثبت صلاحية منهجه على امتداد الزمان والمكان، فإتاحة الفرصة للرجل بالزواج بأكثر من واحدة كانت محل نقد للمنهج الإسلامي، رغم أنها سمة مميزة له تساعد على استمرار الأسرة وتماسكها، فإن كره المسلم العيش مع زوجته جاز له أن يتزوج بأخرى، ويحافظ على أسرته الأولى، أما الآن فقد لمسنا في أوروبا أن القانون المدني لا يسمح إلا بزواج امرأة واحدة، ولهذا كثيرًا ما يترك الرجل زوجته وأولاده وأسرته ليعيش مع خليلة أخرى أو أكثر بغير زواج، فكثر اللقطاء والأبناء غير الشرعيين في معظم البلاد الأوربية.
هذه حرية المرأة في إسلامنا الحنيف، ولها أن تعمل، ولها أن تسافر، ولها أن تلي الناس وتستأمر، كل ذلك في الإسلام، وله أطره وضوابطه المميزة التي تحافظ على هذه الحرية ولا تضيق بها.