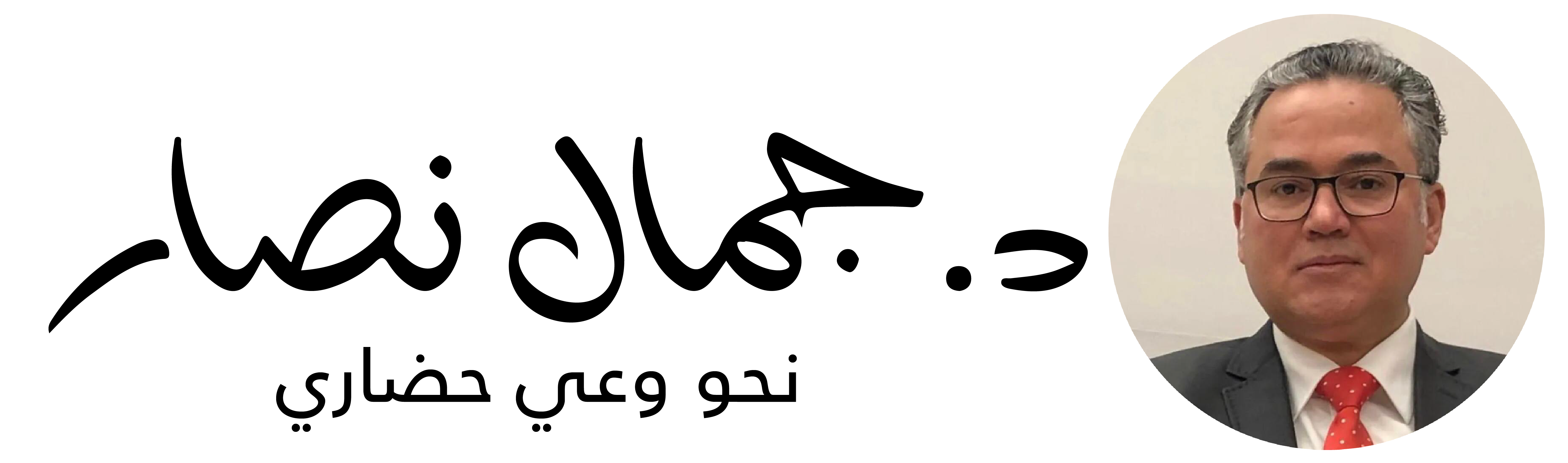كتب عبيدة عامر
لم تكن البداية في أرض الأبراج الشاهقة العربية، وإنما كانت على بعد آلاف الكيلومترات في أوروبا، هناك، وفي أقاصي الأرض خارج القارة العجوز أيضا يعرف أغلب المحامين ودارسو القانون ونشطاء حقوق الإنسان التالي: لا ينال أي عابر تشريف “لودوفيك تراريو (Ludovic Trarieux)”، الاسم الذي تعرف به الجائزة الموصوفة بأنها “أوسكار حقوق الإنسان العالمية”، أوسكار يطلقه العشرة الكبار في أوروبا، ثمانية منهم هم مجالس المحاماة في كل الدول الكبرى للقارة تقريبا، وبرغم أن الجائزة تذهب حصرا لمطاردي الأرض فإنها في عامنا الحالي نالت بريقا خاصا بشدة.
في (مايو/أيار) الماضي ظهر اسم الفائز بأوسكار لودوفيك لـ 2017، رجل قمحي البشرة متوسط العمر، ذو ابتسامة هادئة ومحببة كما يبدو في صورته الأشهر، لكن الرجل لم يكن حاضرا لتسلم الجائزة، وإنما كان قابعا محاطا بجدران خراسانية ونظام مراقبة يوصف بأنه غير قابل للاختراق، لم يكن المكان غريبا وإنما يعرفه الإماراتيون جميعهم: معتقل “الرزين”، أو كما يطلق عليه “جوانتانامو الإمارات العربية المتحدة”.
يعرف المنخرطون في مجال حقوق الإنسان اسم محمد الركن جيدا، الليبرالي اليساري تصنيفا، والمحافظ موضوعا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإمارات، وأحد أهم المشتغلين العرب بحقوق الإنسان. في عام 2012 فاض الكيل بنظام رجل الإمارات القوي محمد بن زايد ولي العهد وحاكم الإمارات الفعلي، وقرر نظامه أنه حان موعد اجتثاث اسم الركن من دولة الأبراج بكاملها، لذا في )يوليو/تموز( من العام المذكور قامت الشرطة الإماراتية بحملة اعتقالات واسعة طالت عددا كبيرا من النشطاء الحقوقيين المحليين، من بينهم ابن البروفيسور محمد نفسه ثم لم تختلف نسخة الأحداث كثيرا عن السيناريو المتوقع: ذهب الرجل للإبلاغ عن اختفاء ابنه، ليفاجأ بعدد من السيارات تطوقه مباشرة، ثم تأخذه إلى مكان مجهول، ليخفيه نظام أبوظبي لثمانية أشهر كاملة مختطفا إياه “قسريا”، ليحوله من عراب حقوق الإنسان في الإمارات إلى مجرد رقم مختطف آخر.
كان خطأ الركن في أعين نظام ابن زايد فادحا بتوقيعه على عريضة الإمارات الإصلاحية الموقعة من 133 حقوقيا وأكاديميا إماراتيا آخرين، والمطالبة بإجراء حزمة إصلاحات داخلية على رأسها حدوث انتخابات مباشرة للمجلس الاتحادي الحاكم، ليقوم النظام بحملة اعتقل فيها العشرات، ثم ليختفي الدكتور الركن تماما من (يوليو/ تموز) 2012 وحتى (مارس/آذار) 2013، وليظهر حينها فجأة في محاكمة جماعية لـ 94 معارضا إماراتيا في المحكمة الاتحادية العليا، منهم منتسبين لجماعة “الإصلاح” الكيان الإماراتي المتهم دوما بالارتباط بجماعة “الإخوان المسلمين” في القضية المعروفة بـ “الإمارات 94”.
جرت المحاكمة بشكل شبه صوري، لذا خرجت الأحكام بالسجن ما بين 7: 15 عاما للجميع، ونال الركن نصيبه بعشرة أعوام كاملة، لم تكن تلك المحاكمة الأولى أو الأخيرة في ظل نظام آل زايد المعروف بتوجهاته، وتوجهات رأسه ولي العهد والحاكم الفعلي محمد بن زايد ضد كل ما يمت بصلة لما يتعارف عليه بـ “الإسلام السياسي”، لكنها تمثل نقطة انطلاق لمحاولة فهم كراهية ابن زايد العميقة لـ “الإسلام السياسي”، والتي ينفق من أجلها أموالا طائلة، محاولا ترويج نسخته الخاصة مما يطلق عليه مجازا “الإسلام المعتدل”.
جذور الكراهية
جذور الكراهية
لم يكن عام ١٩٦٢ هو ميلاد محمد الركن وحسب، بل يمكن اعتباره الميلاد الحقيقي للإمارات العربية المتحدة بأكملها، عندما ظهر النفط فجأة في “ساحل القراصنة” كما أسماه البريطانيون المسيطرون على إمارات الساحل المتصالح السبع. في ذلك العام اكتشف العالم النفط، واكتشفت الإمارات نفسها، وبدأت تنتقل إلى مستوى آخر من اللعبة.
في ذلك الوقت شهدت الأرض الخليجية الجديدة بضعة طلبة عائدين([1]) من مصر والكويت في نهاية الستينيات، حاملين بعقولهم الأفكار العربية الأكثر رواجا وجدلية في القرن العشرين تقريبا: “أفكار الإخوان المسلمين”، مدفوعين بحلم جماعة تنشئ مؤسساتها وتغرس بذور تربيتها الفكرية في المجتمع الوليد، ووجدت أرضا خصبة مكّنتها من تشكيل إحدى أقدم الجمعيات الأهلية في الإمارات -حتى قبل اتحادها- تحت اسم “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي”.
كان الكل يكبر معا، محمد الركن ومحمد بن زايد و”الإصلاح” والإمارات نفسها، وبدأ الجميع ينضج بالتقارب حينا، وبالتدافع أحيانا، وبدأت ملامح “التحديث الإماراتية” تظهر مقابل مشاريع “الإصلاح” التي أعلنت في العام الثالث من اتحاد الإمارات عن جمعيتها بشكل علني تحت إمرة رسمية لشيخ دبي وقتها راشد بن سعيد آل مكتوم، مقابل مجرد قبول رمزي لنفس الأفكار والمشروع في أبو ظبي المنافسة التي منح شيخها وشيخ الإمارات أرضا للجمعية ولكن دون فرع رسمي، في توجس مكتوم للشيخ المشهور بالكرم.
لم يتضارب المشروعان أو يتواجهان بداية، فالدولة الناشئة لم تكن تحتمل ذلك بعد، فدخل “الإصلاحيون” في الحكومتين الأولى والثانية، لكنهم برزوا في الحكومة الثالثة عندما عاد سعيد سلمان إليها كوزير للتربية والتعليم، ورئيس لجامعة الإمارات بعد تأسيسها بسنتين عام ١٩٧٩، وبدأت ما قد يصفه خصومهم بـ “السيطرة” على إدارة المناهج، حيث تولى الرئيس السابق لفرع جمعية الإصلاح برأس الخيمة -والمعتقل منذ عامين ونصف في قضية “الإمارات٩٤” السابق ذكرها- الشيخ سلطان بن كايد القاسمي إدارة المناهج في الدولة لسبع سنوات حتى نهاية عام ١٩٨٣، أصدروا خلالها ١٢٠ مقررا دراسيا هي درة ما أنجزوه.[2]
بدأت قوة “الإصلاحيين” في الازدياد، وتنازلت الجمعية عن المسار السياسي لصالح الاجتماعي الذي دخلته من بوابة التعليم، وأصبحوا في الثمانينيات بلا منافس في ساحة التعليم العام وإدارة المناهج والتأليف، وفي الاتحادات الطلابية التي انتصروا في معاركها الفكرية الكلاسيكية بين “الأفكار الإسلامية” وخصومها. كان محمد الركن طالبا في السنة الثانية في جامعة الإمارات في العين عندما كان “الإصلاحيون” في قمة أوجهم، وكان من أبرز وجوه الجمعية في ساحاتها ومعاركها، حيث استلم رئاسة أول اتحاد طلبة، مؤسسا لهيمنة “إصلاحية” ستستمر عشر سنوات تالية.
بصمت وهدوء، كان شيخ الإمارات يشرف على مسيرة “التحديث” التي بدأت ملامحها تزداد خشونة فوق الصحراء، وكان -بالعين الأخرى- يراقب ذلك الصعود التدريجي للإصلاحيين في ملعبهم المفضل، ومراقبا لمعارضتهم الدائمة لما يرونه معاكسا لنهجهم، بمعارضة بلغت ذروتها عام ١٩٨٧ بمواجهة مشروع التعليم الأساسي، مشروع اعتبره الإصلاحيون “برنامجا تغريبيا”، غير مدركين أن ما أرادته الحكومة به إبعادهم بهدوء عن إدارة المناهج، مما اضطرهم عام ١٩٨٩ إلى التهدئة، ولكن بعد أن بدا للشيخ زايد أن أشواك هذه الصبارة الصحراوية قد تقف يوما ما في طريق الأبراج والأنفاق.
بدأ التشذيب إذن، وجاءت أولى الضربات بوقف اللسان الرسمي للجمعية مجلة “الإصلاح” لستة أشهر، لترجع أكثر هدوءا في محتواها سعيا لعدم إغضاب الرقيب مرة أخرى، فأصبحت القضايا التي تتطرق لها المجلة اجتماعية بحتة، مثل ترشيد السياحة وخطر الأجانب على الثقافة الخليجية المحلية، مع انتقاد لبرامج وسائل الإعلام المحلية والعودة ما بين فينة وأخرى إلى ملف التعليم ولجنة مراجعة المناهج.
لم تكف هذه التضحية، وتأكد للأمراء أن مشروع “التحديث” لا يمكن أن يمر إلا فوق “الإصلاحيين” لا بجانبهم، فحلت الحكومة عام ١٩٩٤ مجلس إدارة جمعية “الإصلاح” كاملا، ثم قلصت أنشطة فروع الجمعية الداخلية والخارجية، وقامت الحكومة بإسناد الإشراف عليها ككل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
مرت تسع سنوات صعبة من تاريخ الحل، مشوبة بالتوتر الصامت والضغوط الناعمة وضبط النفس والرسائل المتبادلة، اعتمد فيها “الإصلاحيون” على حماية بعض الحكام انطلاقا من تقاليد العشيرة والوجاهة المجتمعية، ومقابل بعض التضحيات الداخلية مثل إبعاد بعض الرموز “الإخوانية” من غير الإماراتيين، وأشهرهم المنظر “الإخواني” العراقي محمد أحمد الراشد على وقع الانهيارات الخارجية مثل هجمات الحادي عشر من (سبتمبر/أيلول) عام ٢٠٠١، والتي أدى تورط إماراتيين بها إلى الضغط على الحكومة لتثبت أنها لن تتسامح مع أي شكل من أشكال التشدد الديني، ودفعها نحو جانب آخر من “الدين” وتعزيز دوره كمضاد من داخل الميدان نفسه.
في عام ٢٠٠٣ بدأت عملية نقل واسعة، داخل وزارة التربية والتعليم، لأكثر من 170 من أعضاء جمعية “الإصلاح”، بررها المسؤولون الإماراتيون بأنها تأتي “ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى نقلة كبرى في التعليم العام، تتماشى مع التحولات الكبيرة الاقتصادية والثقافية التي تمر بها البلاد منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي”، ولم يكن عراب النقل هذه المرة شيخ المصالحة والإمارة زايد، بل أحد أبنائه العسكريين الذين كبروا شيئا فشيئا مع هذه الحكاية.
قلب الكراهية
قلب الكراهية
بعيدا عن أرض الأبراج الشاهقة بأكثر من عشرين ألف كيلومتر وأكثر من عشرين سنة، ظهر الخصم الأول للإصلاحيين ولكل الإخوان المسلمين للمرة الأولى بشكل علني عام ١٩٧٩ في لندن، وتحديدا في أكاديمية “ساند هيرست” العسكرية، بالغا عامه الثامن عشر، وببدلة عسكرية تليق بالأكاديمية العسكرية العريقة، وبحضور والده الشيخ زايد آل نهيان وعدد من الأمراء والمشايخ. عاد الشاب محمد إلى الإمارات، والذي تركز تدريبه في “ساند هيرست” على الطيران العمودي والتكتيكي والقفز المظلي، ليصبح القائد الأعلى لقوات الجو في إمارة أبو ظبي، ثم يصعد تدريجيا -متجاوزا إخوته الأكبر- ليصبح فريقا ركنا طيارا عام ١٩٩٤ بعد عامين من توليه رئاسة أركان القوات المسلحة.
ربما لا ينافس محمد بن زايد في خلفيته وصعوده العسكريين في الإمارات المتحدة أحد، فمن بين الأمراء جميعا، باستثناء أخيه -غير الشقيق- سلطان بن زايد، ومحمد بن راشد آل مكتوم (نائب رئيس الدولة ووزير الدفاع وحاكم إمارة دبي) لم يدرس أحد في “ساند هيرست” ولا في بريطانيا كلها، بما سيترك دلالته العملية على تحركه إذا وضعناها بجانب أفكاره الموصوفة بـ “التنويرية والليبرالية”، والتي أصبحت واضحة بعد تأسيسه “مجلس أبو ظبي للتعليم” عام ٢٠٠٥، عاكسة اهتمامه الكبير بالشراكات مع المؤسسات التعليمية والمراكز الفكرية العالمية التي أعلن عن قيام عدد منها في أبو ظبي، ليضعه كله ذلك في قلب المعركة السياسية الاجتماعية مع الإصلاحيين: التعليم.
تفرغ محمد بن زايد بنفسه لهذه المعركة، وبدا وكأنه يخوضها بمناصبه الثلاثة معا، كولي للعهد وكنائب وزير الدفاع وكرئيس مجلس أبو ظبي للتعليم، ويقاتل بها بشخصه وأفكاره مقابل الأفكار الأخرى. وبدا كأن أبوظبي وأميرها أخذوا على عاتقهم مواجهة “الإخوان المسلمين” وتقليص نفوذهم، والسماح للتيارات الإسلامية الأخرى بالظهور، مثل: الصوفية وجماعة التبليغ والدعوة، والسلفية العلمية، وارتبط منع أبو ظبي لسيس الجمعية في السبعينيات بما تعتبره “تأكيدا لتجربة الإمارات مع التحديث الذي خاضت غماره منذ عام ١٩٩٤”، والذي لم يكن ليتم بحسب وجهة نظر أبو ظبي وأميرها على لسان مركزها “المسبار” إلا بـ “خلو دولة الإمارات العربية المتحدة من نفوذ إسلامي مسيَّس، سواء كان تيارا أم تنظيما أم حزبا قادرا على حشد الأتباع، وهو ما سمح لها بخوض تجربتها مع التحديث دون أي معوقات تعاني منها دول إسلامية وعربية أخرى، نابعة من تسرطن المد الديني والفكر الإخواني”.[4]
بعد سحب أرض الوقف الممنوحة في أبوظبي لـ “الإصلاح” للتأسيس، وبمرافقة الخطوات المتسارعة الأخرى، بدا أن الحكومة الإماراتية الاتحادية تنظر لـ “الإصلاح” على أنهم “خونة” أو خارجون على الدولة، وأكدت ذلك -بجانب الضغوطات الأمنية والإعلامية التي فرضتها على أفرادها- بطرحها قضية “البيعة” التي يقدمها المنتسبون للتنظيم، والتي يؤكدون أنها لا تعدو كونها إجراء رمزيا، لكن الدولة رأتها “تضاربا في الولاءات وخيانة للوطن” خاصة مع الاتهامات بارتباط “الإصلاح” بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وهو ما نفوه مرارا وتكرارا.
قرر الإخوان الاستجابة للضغوط عام ٢٠٠٣ مع كثرة الاتهامات وتضرر الكوادر بسبب “البيعة”، وقرر الإصلاحيون عدم استقطاب أي من العاملين في القطاع العسكري أو التواصل مع أي عضو التحق بالجيش، وألغو أخذ البيعة بشكل نهائي.
بدا أن هناك أملا بأن تعود الأمور لمجاريها، فقد التقى محمد بن زايد بنفسه، رغم كراهيته، ثلاث قيادات من “الإصلاحيين” عام ٢٠٠٣ في ثلاث لقاءات مختلفة، أكد فيهم أن الطريق الوحيد هو “الحل”، أي حل الجمعية بأكملها والعمل ضمن مؤسسات الدولة. ووعدته قيادات “الإصلاحيين” بالتفكير في الأمر، متأثرين بظلال حل التنظيم في قطر، وبالتقاطع مع دعوة المفكر الإسلامي المخضرم الكويتي عبد الله النفيسي لحل التنظيمات في الخليج. لاحقا سيصف قيادات “الإخوان” هذه اللقاءات بأنها كانت “ربيعا لن يتكرر”، وقد كانت كذلك بالفعل: “ربيعا عابرا” لتنظيم “بلا أرض”، ربيعٌ لم يتكرر بالفعل.
لم تقنع الجماعة المولودة قبل الاتحاد نفسه بما يريده الأمير الشاب، فعاد سلطان بن كايد القاسمي (رئيس جمعية “الإصلاح” برأس الخيمة) إلى مجلس محمد بن زايد وفي يده بيان موقع من زعماء التنظيم يوضح له أن “الجماعة تمتلك شعبية كبيرة وقبولا في المجتمع الإماراتي، ولها امتدادات في الداخل والخارج، وأن الجماعة هي الجهة المنظمة القادرة على التأثير، ولا يمكن لأي سلطة أن تقلص من نفوذها وتأثيرها”، مما دفع ابن زايد للدفع قدما بخطط “إصلاحه” الشخصية، وبدء حملة جديدة من التصعيد تمثلت عام ٢٠٠٦ بإبعاد عشرات المعلمين، رد عليها “الإصلاحيون” بتجمعات احتجاجية وضغط إعلامي مضاد.
مرة أخرى، وبعد أربعين عاما ستصل رياح الشرق الأوسط إلى الإمارات المتصالحة، ومرة أخرى ستصل هذه الرياح من حيث بدأت، ولكن الفرق أنها بذكريات سجون عبد الناصر لا بأحلام الأفكار الكبرى، فقد عاد شبح “التنظيم الدولي” من مصر ليهيمن على الأمير الإماراتي الليبرالي.
في عام ٢٠٠٩ (العام الذي خاضت به إسرائيل حربها الأولى على غزة لمحاولة إنهاء “حماس” المتهمة بانتمائها للإخوان المسلمين كذلك)، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قائمة بأسماء 36 متهما في ما سمّي بقضية “التنظيم الدولي للإخوان”، شملت القائمة ثلاثة رجال أعمال، ذكرت اللائحة أنهم من الإخوان المسلمين الإماراتيين، واتهموا بالقيام بتهريب أموال إلى داخل مصر، وأشار الاتهام إلى أنه قد سبق وأُلقيَ القبض عليهم بمطار الإسكندرية وبحوزتهم أموال تمت مصادرتها، فيما يشبه التكرار العكسي لملابسات قرار حل الجمعية عام ١٩٩٤، الذي جاء بعد قرار تقدمت به الحكومة المصرية للإمارات في العام نفسه بادعاء أن أفرادا متورطين بعمليات “إرهابية” من جماعة الجهاد المصرية قد تلقوا تبرعات مالية عبر لجنة الإغاثة والأنشطة الخارجية لجمعية “الإصلاح” الإماراتية، وهو ما تم تبرئتهم منه خلال العام نفسه، لكنه كشف وراء غموض ابن زايد عن أبعاد المعركة، وإلى أين يمكن أن تصل، وعلى أبواب حلقاتها الأخيرة.
تعلم محمد بن زايد درس الربيع العربي، وتذكر أيام “الربيع الإصلاحي” القصيرة، وبدا أنه لن ينسى للإصلاحيين تفويت الفرصة التي منحهم إياها، وقرر أخذ الأمر بشكل شخصي، لأجله ولأجل مشروعه “التحديثي الليبرالي”، منتظرا خطوة أخيرة ينهي بها كل شيء.
كانت لحظة الربيع العربي، إذ دخل الإصلاحيون -مرة أخرى- مدفوعين ومتحمسين ومندفعين بأحلام الربيع العربي، فأصدر ١٣٣ أكاديميا وحقوقيا غالبهم من “الإصلاح” مطلع عام ٢٠١١ وثيقة دعوا بها إلى انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الاتحادي، ولمنحه صلاحيات تشريعية، ترافقت مع صعود “الإخوان المسلمين” في مصر. كان الأمر أشبه بالكابوس لمحمد بن زايد، إذ ذكره بصعود “الإصلاحيين” في السبعينيات والثمانينيات، ووقوفهم في وجه المشروع “التحديثي”، وبدا أنه لن يسمح بتكرار الأمر مجددا، وللأبد.
ردت الحكومة على العريضة الإصلاحية باعتقال خمسة من الناشطين، تصدى للدفاع عنهم الدكتور الركن رغم ما يعلمه ويخبره من أنظمة المراقبة والقبضة الأمنية التي طالته بعد ذلك بعام تقريبا مع رفاقه (وهم تقريبا الصف الأول والثاني لـ “الإصلاح”) في محاكمة جماعية في (مارس/آذار) ٢٠١٣ قبل شهور من الانقلاب العسكري في مصر.
حد الهوس
حد الهوس
لا يبدو أن الأمر انتهى للأمير الشاب على هذا الحد، فابن زايد الذي يتربع في كبار قائمة مستشاريه محمد دحلان (القيادي السابق في حركة فتح والمتهم بتعذيب معتقلي “حماس” في سجون السلطة الفلسطينية) وتوني بلير (رئيس الوزراء البريطاني السابق وأحد المتورطين الرئيسين في غزو العراق) لا يزال -على ما يبدو- مهووسا بـ “الإسلام السياسي” على المستوى الإقليمي والعالمي.
تقول النظرية الروسية الشهيرة: “ما لا تستطيع إنجازه بالعنف؛ تستطيع إنجازه بعنف أكبر”، وهو مبدأ يتبعه أبناء زايد في السياسة المحلية والعالمية على صعيد آخر، وهو أن ما لا تستطيع إنجازه بالمال، تستطيع إنجازه بمال أكثر، مالكين ما يكفي منه وزيادة، ومنفقين له بلا قوانين مراقبة من أي نوع، دون أن تتأثر مشاريع “إعمار” المستمرة لديهم، أو يتوقف تحطيم الأرقام القياسية بحفلات رأس السنة عند برج خليفة. بهذه الإستراتيجية بدأ الأمير الذي يحمل عداوة شخصية مؤكدة مع كل ما يمثله مصطلح “الإسلام السياسي” بأكبر حملة ضد “الإخوان المسلمين” و”الحركات الإصلاحية والثورية” بتأمين غطاء قانوني وضعت به الإمارات قائمة من ٨٣ حركة “إسلامية” وعربية وعالمية، مدنية وعسكرية، في قائمة “الإرهاب” الخاصة بها بلا معايير واضحة، وإنما بمعايير خاصة لا يعرفها إلا النظام نفسه.
تاليا، وضعت الإمارات الغنية ثقلها المالي وراء الثورات المضادة وإفشال مشاريع وحركات الإسلام السياسي، إذ بلغ مجموع نفقات الإمارات على الجنرال المنقلب عبد الفتاح السيسي ١٢ مليار دولار بهدف تثبيته في الحكم[5]، وهو ما يوازي المساعدات الإماراتية لمصر منذ عام ١٩٧١ حتى عام ٢٠١٤[6]، منها ثلاثة مليارات دولار أودعتها الإمارات بالبنك المركزي حال استلام السيسي للحكم، ثم مساعدات بقيمة ٤,٩ مليار دولار في (أكتوبر/تشرين الأول) من العام نفسه.
أما في ليبيا فقد دخلت الإمارات بكل ما لديها لصالح الجنرال خليفة حفتر الذي استلم زمام الثورة المضادة هناك، كما تدخلت في اليمن لصالح الثورة المضادة أيضا خشية وصول “الإصلاح” للحكم، وصولا إلى متابعة الانتقادات الشخصية، حيث وصل الأمر إلى دفع الأردن لاعتقال زكي بني ارشيد نائب المراقب العام للإخوان المسلمين هناك لكتابته منشورا ينتقد فيه الإمارات على “الفيسبوك”.
بلا حد جغرافي أو سياسي أو منطقي، اندفع الأمير بتصدير “الكراهية” وصولا للديمقراطيات الغربية، معتمدا على مزيد من النفوذ المالي والسياسي، وسعيا لتصنيف “الإخوان المسلمين” كحركات إرهابية في كل من أميركا وبريطانيا اللتين خلق نفوذه بهما عبر مجموعات الضغط، حيث أبدى محمد بن زايد -شخصيا- لرئيس الوزراء البريطاني حينها ديفيد كاميرون انزعاجه من وصول الإخوان المسلمين للحكم أثناء ترتيب صفقة أسلحة بمليارات الجنيهات الإسترلينية[7]، تبعه تهديد خلدون المبارك (مالك نادي “مانشستر سيتي” البريطاني والذراع الأيمن لابن زايد) للسفير البريطاني في أميركا بأن هناك “علما أحمر” ضد بريطانيا قد يؤدي لإلغاء صفقة الأسلحة معها بسبب عدم تغيير سياساتها تجاه “الإخوان”، وهو ما دفعها لمناقشة قانون يفضي لتعريف الحركة بـ “الإرهابية”.
أما في أميركا، فقد ملأ السفير الكاريزمي الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة بريد فيل جوردون (كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط) برسائل رسمية مليئة بالغضب من الإخوان المسلمين وداعميهم في قطر[8]، كما وصل به الأمر أخيرا إلى دعم الانقلاب العسكري في تركيا -عبر دحلان-[9] عن طريق حليفه الشيخ “المعتدل” فتح الله جولن وجماعته[10]، إذ يرى ابن زايد في تركيا أيضا عدوا سياسيا كونها امتدادا لمشروع “الإسلام السياسي” لخصومه في المنطقة، ومنافسته على الفضاء الاجتماعي في التصوف، مما هيأ إعلام الإمارات ليكون الناطق الرسمي باسم “الانقلاب” حينها قبل فشله.
مثل شركات العقارات الإماراتية، ومثل الشركات النفطية العاملة فيها، كانت كراهية محمد بن زايد للإسلام السياسي “عابرة للحدود”، وغير مفسرة في أحيان كثيرة، لكن الواضح والمثير للاهتمام أن هذه الكراهية كانت مغلَّفة ومغلِّفة لنوع آخر وشكل آخر من “الإسلام السياسي” أيضا، اتفق محمد بن زايد مع العالم هذه المرة على تسميته بـ “الإسلام المعتدل”، وسيشق طريقه في المجتمع والسياسية على طريقة داعمه وعرابه في المنطقة، وربما في العالم كله كذلك: بهدوء وصمت وتوجس، وبالمال.
“الإسلام المعتدل“
“الإسلام المعتدل”
مجددا، بعيدا عن الإمارات، وعلى مسافة قصيرة من البيت الأبيض، لم يكن عشرات الباحثين الدينيين والسياسيين يناقشون تبعات احتلال العراق، أو الآثار الاقتصادية للحرب الأميركية على الإرهاب، أو أفكار كيسنجر أو حتى الرئيس نيكسون نفسه، في مركز الأبحاث الذي أسسه على اسمه ليكون مختصا بـ “السياسة الواقعية”، بل كانوا يناقشون أسماء مثل ابن عربي وجلال الدين الرومي في جلسات بحثية مطولة في قلب واشنطن، لا أمسيات شعرية أو ثقافية أو أدبية.
في عاصمة الفردوس الأرضي -كما يسميه الدكتور عبد الوهاب المسيري-، ومن قلب الحضارة الأكثر مادية في تاريخ الإنسانية، وفي واحد من أكثر المراكز البحثية واقعية سياسية والمرتبط بالرئيس الذي خاض حرب فيتنام، كان المجتمعون يناقشون “الصوفية” بما يتوافق مع كل هذا النسق، فكان النصف الآخر من اسم الجلسة هو: “وأثرها على السياسة الأميركية”. لقد كان الأمر ليبدو غريبا لولا أن الاجتماع كان بعد عامين فقط من هجمات الحادي عشر من (سبتمبر/أيلول)، والتي بدا بها العالم مصابا بهلع من الإسلام ككل -ومن السلفية والوهابية كاتجاهات تحديدا- بعد أن ارتبط المشهد المرعب لسقوط برجي التجارة العالميين في الأذهان باللحى الطويلة والملابس الأفغانية، في لحظة تاريخية مليئة بالرعب والإسلاموفوبيا والكراهية والكراهية المضادة.
كان ضيفا اللقاء الرئيسين في “مركز نيكسون” البحثي هما: المستشرق الشهير بيرنارد لويس، صاحب المقالة الشهيرة “جذور الغضب الإسلامي”[11]، والمعروف بدعواته لتقسيم الشرق الأوسط على أسس طائفية[12]، واللبناني الأميركي هشام قباني، نائب زعيم “الجماعة الصوفية النقبشندية”، وحلقة الوصل بينها وبين الإدارة الأميركية والأوساط الفكرية هناك.
عند الوهلة الأولى، سيبدو أن مؤتمر “الصوفية وأثرها على السياسة الأميركية” [13] سيتعمق في الأفكار الصوفية التاريخية، ويقارب بينها وبين الاتجاهات الروحانية الأخرى، لكن المثير للاهتمام أن المؤتمر لم يكن للحديث عن الصوفية وحسب، بل بالأكثر عن خصمها الفكري والسياسي: “السلفية” و”الوهابية” تحديدا.
قارن لويس بين حركة “كو كلوكس كلان” المتطرفة في أميركا التي “فشلت لحسن الحظ بالاستمرار، بعكس السلفية التي استطاعت -مغسولة بأموال النفط- أن تسيطر على مكة والمدينة وتصبح مركزية في التاريخ الإسلامي”، في حين ابتدأ قباني كلمته بقصيدة للرومي، وقصيدة لابن عربي، ثم اختتمها بقوله إنه “لا يوجد سلفية منذ القرن الثالث الهجري، وإنما هو مصطلح أعاد الملك فهد استخدامه في الثمانينيات لاكتساب الشرعية، ووجد صداه لدى الحركات الإسلامية الراديكالية مثل الإخوان المسلمين وحزب التحرير”، متسائلا: “هل نحن كأميركيين سنتعامل مع الصوفيين أم مع الوهابيين، بما قد يضعنا في خطر دعم الإرهابيين؟ الجواب بسيط جدا: يجب أن تتعامل الولايات المتحدة مع غير الوهابيين إن أرادت الانتصار في المعركة، ولن تخسر أبدا”.
كانت هذه لحظة تاريخية نادرة للأفكار الصوفية، فلم تأت بلحظة يريدها الغرب في ظل “خوائه الروحي بسبب المادية الطاغية” بحسب ما يصفها الدكتور إسماعيل الفاروقي وزوجته لمياء في كتاب “أطلس الحضارة الإسلامية”، بل وجدت أن الغرب يحتاجها كمضاد شيطنة الإسلام السياسي والسلفية والوهابية تحديدا، وربطها جميعا بالعنف بعد أحداث الحادي عشر من (سبتمبر/أيلول)، فقدم دعمه لها “كمضاد” من داخل الإسلام نفسه بعد أن فشلت الأفكار المضادة من خارجه في إلغائه من السياسة والمجتمع.
بعد هذا المؤتمر بثلاثة أعوام فقط، أصدرت مؤسسة “راند” أحد أهم المراجع وخطط العمل حول هذا الموضوع، وهو بحثها الشهير “بناء شبكات الإسلام المعتدل”. حين نفتح الكتاب سنجد في الشكر أحد الشخصيات التي أصبحنا نعرفها جيدا، وللمفارقة فلن تكون محمد بن زايد نفسه كما هو متوقع، بل الدكتور محمد الركن في الإمارات، الذي ساعد باحثي “راند” في هذه الدراسة، والآتية بعد تمهيدها ودعوتها المباشرة إلى تشجيع الصوفية لمواجهة الخطاب السلفي الوهابي[14].
في خطة عمل “شبكات الإسلام المعتدل” تدعو “راند”[15] إلى بناء شبكة من “الإسلاميين المعتدلين” الذين يشملون العلمانيين، والليبراليين، و”التقليديين المعتدلين”، كـ “الصوفية” مثلا، كتتويج لخطاب كامل وطويل ودعوات متكررة من الباحثين الغربيين، مثل بيرنارد لويس ودانييل بابيس وستيفن شوارتز، التي تدعو إلى دعم الصوفية كبديل للإسلام السياسي والسلفية الجهادية، مترافقة مع سلسلة من المؤتمرات العالمية لحشد الصوفية “السياسية” وحركات الصوفية العابرة للحدود في كل أنحاء العالم، بدءا من “المؤتمر الثاني للطريقة الشاذلية” بالتعاون مع اليونسكو، ثم عدد من المؤتمرات العالمية في العراق وليبيا والجزائر وفرنسا وغيرها من أنحاء العالم.
لقد بدا أن انتقاد لويس للوهابية كان لأنها “مغسولة بالنفط”، لكنه لم يلتفت -عمدا أو سهوا- إلى أن الفكرة التي دعا لها لم تكن أقل “غسلا بالنفط” إن جاز التعبير، وإلى أن كل زملائه كذلك مغسولون به، وإن كان من نوع آخر وبلد آخر، فقد كانت أبرز الانتقادات للسلفية والوهابية تصدر من جهات مدعومة من الإمارات، سواء من شبكة “إم بي سي” السعودية التي تحتضنها وتبثها دبي، أو من “مركز المسبار” الإماراتي الذي اختص بهذا، كما سنجد في المقابل أن “الصوفية السياسية” ليست مجرد أفكار جميلة مثالية معتدلة تنتشر وحدها، بل تسير -وكما وضع لها- ضمن شبكات وترتيب وتنسيق محدد وممدد في شبكة واسعة يقبع في قلبها شيخ شهير ببسمته الواسعة ولكنته المميزة ودموعه الحاضرة، والأهم عمامته الصوفية، وتقديره واحتفائه اللازمين لـ “سمو الأمير محمد بن زايد، وللإمارات هذا البلد الطيب” كما يقول دوما.
الشبكات
الشبكات
على صغر عمره يبدو تأثير المريد الصوفي الحبيب علي الجفري متجاوزا للغته العذبة وكلماته العاطفية ودعائه الحاضر، وعلى بساطة معرفته وخبرته تجد أن “وراء الكلمة ما وراءها”، فالمريد اليمني الذي نشأ في الحجاز -منفيا عن اليمن- في وسط صوفي محض دون احتكاك مع الأوساط الأخرى المتاحة، كان يعيش في بيت سياسي بامتياز، فوالده هو عبد الرحمن الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، وساند الحزب الإشتراكي اليمني في محاولة الانفصال التي أشعلت حرب عام ١٩٩٤، ووضع إثرها في قائمة الـ١٦ للحكومة اليمنية، كما كان نائبا لرئيس حكومة الانفصال علي سالم البيض، المدعوم اليوم إماراتيا كورقة للانفصال، الذي يدعو له الحبيب علانية كحل أخير لأزمة اليمن.
رأى الجفري بعينيه فشل الاشتراكية السياسي، مثلما شاهد العالم عجز العلمانية والليبرالية عن اختراق المجتمعات العربية بما يكفي، وبدا مثل محمد بن زايد مدفوعا بطموحات وأحلام كبرى، وخلافات تصل حد الكراهية مع السلفية التي يعاديها ويعلن حربه عليها فكريا وعقديا، ومع الإسلام السياسي الذي كان فرعه “الإصلاح” في اليمن مقربا من الحكومة.
اتفق محمد بن زايد الليبرالي والحبيب علي الجفري الصوفي على “الكراهية المعتدلة”، ووجد كل منهما حاجته لدى الآخر، فالحبيب الطموح الباحث عن شق طريقه لم يكن ليستطيع ذلك في ظل الدولة السعودية السلفية، كما لن تستطيع جرافات الأمير الليبرالي اجتثاث “الإسلام” بسبب نسخته “السياسية” التي يمثلها “الإصلاح” في مجتمع محافظ قائم على علاقات ووشائج المشايخ والعوائل الكبرى، وفي لحظة تاريخية مثالية جاءت لصالحهما.
تقاطعت الصوفية والليبرالية واللحظة التاريخية، وتمثلت على شكل مبنى فخم قرب مسجد الشيخ زايد الأبيض الشهير في مدخل أبو ظبي تحت اسم “مؤسسة طابة”، برعاية رسمية مفتوحة من ابن زايد، وبإشراف فكري ومؤسساتي مباشر للحبيب علي الجفري، الذي حرك أذرعه واستخدم علاقاته لحشد “الصوفية السياسية”، أو “الكراهية المعتدلة”، تحت المؤسسة المعنية بـ “إعداد الدراسات والكوادر والمؤسسات لتطوير خطاب إسلامي واضح وإيصاله للعالم بأسره بطريقة تؤدي للإدراك”، أي أنها مسؤولة عن “مد الشبكات”، لنجد في مجلسها الاستشاري الأعلى (مرجعيتها الشرعية) تحت رئاسة الشيخ السوري محمد سعيد رمضان البوطي أسماء صوفية كبيرة كرئيس مركز التجديد والترشيد بلندن الشيخ عبد الله بن بيه، الذي سيقنعه الجفري لاحقا بالاستقالة من “اتحاد علماء المسلمين”، ومفتي مصر السابق علي جمعة، ومفتي الأردن السابق محمد نوح القضاة، وشيخ الجفري الذي درس على يديه الحبيب علي حافظ، في حين يشارك الجفري في اللجنة الأكاديمية الاستشارية عدد من الباحثين والأكاديميين من بلدان مختلفة، أبرزهم عارف نايض في ليبيا وجهاد براون من الولايات المتحدة.
يمكن القول إن “طابة” كانت النواة الرئيسة لتشبيك “الصوفية” كتمهيد لتسييسها الذي سيصبح أوضح وأجلى خلال السنوات اللاحقة، عندما يصبح المشايخ الصوفيون الذين يؤكدون على رفضهم “تسييس الدين” هم ساسته وكهنة مستبديه وانقلاباته.
“الكراهية المعتدلة“
لم يكتف الجفري بإدارة “طابة” وتصدر الشاشات التي يمكن وصفها بالليبرالية، وتصديره خطابا مليئا بالحب والسلم والاعتدال تمثّل في مهرجان “جوائز المحبة” الفارِه الذي يشرف عليه بشكل مباشر برعاية رسمية من محمد بن زايد، بل وسّع أذرع شبكته التي جاءت الحاجة لها أخيرا بجانبها السياسي بعد أن قامت بما عليها بتصدير نسخة “معتدلة” من الإسلام اجتماعيا وغربيا.
ومثلما كانت لحظة ما بعد الحادي عشر من (سبتمبر/أيلول) لحظة مثالية لـ “التصوف السياسي”؛ جاءت لحظة الربيع العربي فارقة في الوجدان والوعي الجماعيين، وبقدر ما سقطت أنظمة سياسية مستبدة تساقطت أقنعة علنية، وتكشفت المشاريع عن حقيقتها، وكشف خطاب “الحب” و”السلم” و”الاعتدال” اللا مسيس عن “كراهيته السياسية”.
لم يكن أحد يتخيل أن الشيخ عبد الله بن بيه الذي كان على يمين الشيخ يوسف القرضاوي (أحد كبار الشخصيات الإخوانية في العالم العربي) طيلة سنوات -كان من بينها خطبة احتفائية بالثورات العربية والدفاع عن الحقوق- سيصبح الوجه المعادي الأول لهذا الخطاب، وسينجح الشاب الجفري بجره إلى مساحة ربما لم يكن ليرغب بها أو يجيدها، لكن السلم يغري أكثر من الحرب، خصوصا إذا علمنا أن الشيخ الموريتاني الكبير بن بيه يؤمن أن “العفو مقدم على العدالة”، وهو ما دفعه لتأسيس “منتدى تعزيز السلم” الذي سيصبح غطاء وظلا لمؤسسات دينية ستدخل في سجالات مباشرة مع خصوم الإمارات السياسيين، يجمعهم أمر واحد مثلما جمع ليبرالية محمد بن زايد وصوفية الجفري كراهية “الإسلام السياسي”.
هذه الكراهية حشدت في صفها مجموعة من المتناقضات ضمن شبكات أخرى أصغر وأكثر تناقضا واضطرابا، إذ وجد بقايا ما يمكن تسميته بـ “اليسار السياسي” حاجتهم بدعم إماراتي في مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” التي شيطنت الحركات “الإسلامية السياسية” تحت اسم “أنسنة الإسلام”، كما وجد عدد ممن يسمون أنفسهم بـ “التنويريين” مثل عدنان إبراهيم ومحمد شحرور والسيد ولد أباه حاجتهم ومطلبهم هناك، ففتحت لهم شاشاتها ومؤسساتها وأموالها ليصدروا الخطاب التنويري، بجانب عدد من الدعاة الأصغر مثل الداعية الأردني -الحاصل على الجنسية الإماراتية- وسيم يوسف.
اجتمعت شبكة “الكراهية المعتدلة” إذن، وصارت اللحظة مواتية مرة أخرى بسقوط الإخوان المسلمين بتسهيل من الذراع الإماراتي الخشن لها بالعسكرة والمال، وبمباركة من الذراع الناعم لها بالشرعنة الدينية ودعم الثورات المضادة وتخوين وتكفير “الإخوان المسلمين”، والدعوة لقتلهم لعرابي هذه الشبكة الذين كانوا حاضرين دائما في محافل السيسي والداعمين لإيقاف “التخريب” و “الإرهاب” الذي حملوا وزره للربيع العربي، فانتقل اللعب إلى مستوى آخر مختلف تماما.
بعد عام واحد من الانقلاب المصري وصعود الثورات المضادة في اليمن وسوريا وليبيا حضر الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى أبوظبي ليعلن عن “لحظة تاريخية في هذا الشهر الكريم (رمضان) والبلد الطيب (الإمارات) يجتمع بها علماء وحكماء العالم الإسلامي، ويدعون إلى ترك الشقاق والخلاف والاقتتال الداخلي في الحروب الصغيرة الدائرة بين الأهل والبلد الواحد بسبب أجندات سياسية داخلية”، في كلمات قالها في حفل إطلاق “مجلس حكماء المسلمين” الذي أكد أنه “مستقل ولا يعبر عن أي سياسات قـُطرية ولا عالمية، وقد ولد مستقلا وسيظل مستقلا” بحسب تعبيره.
بطبيعة الحال، لا يمكن لشيخ “الاعتدال” بنسخته الإماراتية أن يعلن المعركة، خصوصا أن رئاسة “مجلس حكماء المسلمين” مشتركة مع رئيس منتدى “تعزيز السلم” عبد الله بن بيه، فتركوها للحاضرين والمتابعين القريبين من دوائر الحكم الإماراتية، ليكشفوا عن الأهداف الحقيقية للمجلس، متمثلة في “سحب البساط من تحت أقدام الحركات والأحزاب والتنظيمات التي تسيّس الإسلام، وخصوصا حركة الإخوان المسلمين”، إضافة لوظيفة “دينية” أخرى للمجلس متمثلة في تعرية ضمنية لما يسمى باتحاد علماء المسلمين، ساعية أن يحل “التصوف السياسي” مكان “الإسلام السياسي”[16].
بعد عامين، بتصدر ذات الوجوه في المعركة تحت القيادة نفسها التي تمنح التمويل والتسهيل والعسكرة[17]، ستنتقل “الشبكة” التي بدأت صغيرة في أبو ظبي إلى مرحلة أخرى عالمية، وهذه المرة بمواجهة عدو جديد، وبذات الخطاب المتناقض الذي يسيّس الدين تحت ذريعة عدم تسييسه، وهذه المرة باستضافة كريمة وتحمل الكثير من الدلالات لأحد أكبر أذرع داعمي الاستبداد في العالم، الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، الموصوف بأنه دمية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كانت طائراته حينها تسوي حلب والمدن الثائرة الأخرى في سوريا بالأرض.
لثلاثة أيام سيجتمع المشايخ “المعتدلون” في غروزني، تحت مسمى “مؤتمر أهل السنة والجماعة”، ليناقشوا سؤالا يبدو ظاهره دينيا مجردا حول من هم أهل السنة، ويصلوا إلى نتيجة غريبة سابقة في التراث والتاريخ الإسلاميين، مفادها أن أهل السنة هم: “الأشاعرة والماتريدية والصوفية”، معتبرة بمعنى آخر -بحسب ما رآه الباحثون- أن السلفية والوهابية ليسوا من أهل السنة، في تهديد مباشر لجوهر وجود السعودية نفسها القائمة على تحالف الدين بالسياسة.[18]
سبحة صوفية طويلة، خرزها لحظات تاريخية فارقة، وقوامها كراهية “الإسلام السياسي” والسلفية، ويسبح بـ “اعتدالها” مشايخ ذوو خطاب ديني وفكري في الظاهر، لكنهم لا يعدون أن يكونوا أكثر من أدوات في معركة وتضارب لمشاريع سياسية، لأمير طيار ليبرالي، لم ير مشكلته بالشق الأول من “الإسلام السياسي” وحسب، بل خشي من الشق الثاني الذي رأى أنه يمكن أن يقف عثرة في وجه طموحاته، فسعى لضربه من داخله بهدوء و”سلم” و”اعتدال”، وفي لحظة تاريخية قد تكون الحلقة الأخيرة في السبحة “المعتدلة” التي خسرت جوهر وجودها ومعناه عندما تحول مشايخها ومفكروها ورموزها إلى كهنة سلطان كما يبدو، متناسين أو ناسين ما يدعون إليه دوما في برامجهم ومحاضراتهم لوقت غير معلوم، وربما للأبد.
المصدر: موقع ميدان – الجزيرة نت
1الإخوان المسلمون في الإمارات: التمدد والانحسار
2لقاء خاصمع الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي
3مقال: سفارات بريطانيا والسؤال الغبي
4الإخوان المسلمون في الإمارات التمدد والانحسار
5الإمارات أكبر داعم للسوق المصرية بعد 30 يونيو
6مصر أكثر الدول حصولاً على المساعدات الإماراتية
7UAEtold UK:crack down on Muslim Brotherhood orlose arms deals
9UAE ‘funnelled money to Turkish coup plotters’
10The Gulf’s UAE is a Good Match for Turkey
12NewBernard Lewis Plan will Carve up The Middle East
13Understanding Sufism and its Potential Role in Us Policy
14Five Pillars of Democracy:How the WestCan Promote anIslamic Reformation?
15Building Moderate Muslim Networks
16انطلاق مجلس حكماء المسلمين في أبوظبي لإطفاء حرائق الأمة
17الخليج الجديد” تمويل مؤتمر الشيشان.. الإمارات في دائرة الاتهام