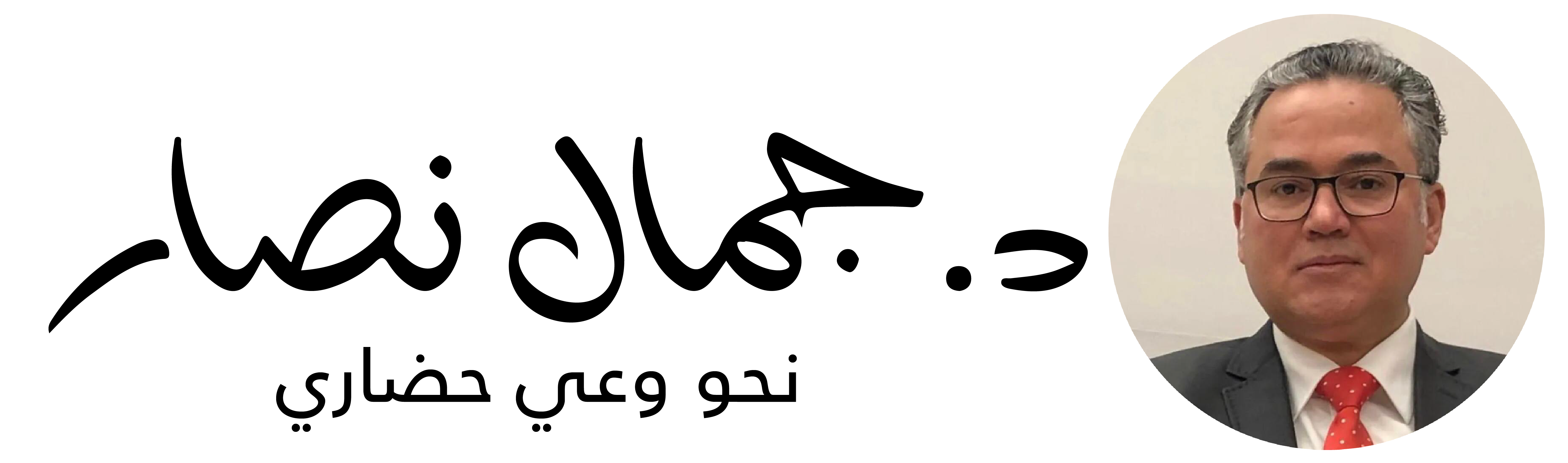هناك نماذج عملية فريدة في الاختلاف على مر العصور منها، ما وقع بين الصحابة – رضوان الله عليهم – كما حدث بين الصديق أبو بكر وعمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – وما حدث بين عمر وعبد الله بن مسعود – رضي الله عنهما – وكذلك ما كان في العصور التالية لعصر الصحابة والتابعين، وهذه الاختلافات لم تؤدّ إلى بغض أحدهما للآخر، بل أدّت إلي زيادة الحب فيما بينهم، مع التوقير، والاحترام المتبادل.
كما أن الأئمة – رضوان الله عليهم – قد اختلفوا في كثير من الأمور الاجتهادية، كما اختلف الصحابة والتابعون قبلهم، وهم جميعًا على الهدى مادام الاختلاف لم ينجم عن هوى، أو شهوة أو رغبة في الشقاق، فقد كان الواحد منهم يبذل جهده وما في وسعه، ولا هدف له إلا إصابة حق، وإرضاء الله – جل شأنه – ولذلك فإن أهل العلم في سائر العصور كانوا يقبلون فتاوى المفتين في المسائل الاجتهادية ما داموا مؤهلين، فيصوّبون المصيب، ويستغفرون للمخطئ، ويحسنون الظن بالجميع، ويسلمون بقضاء القضاة على أي مذهب كانوا، ويعمل القضاة بخلاف مذاهبهم عند الحاجة من غير إحساس بالحرج، أو انطواء على قول بعينه، فالكل يستقي من ذلك النبع وإن اختلفت الدلائل، وكثيرًا ما يصدّرون اختياراتهم بنحو قولهم: (هذا أحوط – أو أحسن – أو هذا ما ينبغي – أو هذا لا يعجبني)، فلا تضييق ولا اتهام ولا حجر على رأي له من النص مستند، بل يسر وسهولة وانفتاح على الناس لتيسير أمورهم.
لقد كان منهم، رضوان الله عليهم، من يقرأ البسملة، ومنهم من لا يقرأها ومنهم من يجهر بها، ومنهم من يُسرّ، ومنهم من يقنط في الفجر، ومنهم من لا يقنط فيها، ومنهم من يتوضأ من الرعاف والقيء والحجامة، ومنهم من لا يتوضأ من ذلك، ومنهم من يرى في مس المرأة نقضًا للوضوء، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل، أو ما مسته النار مسًا مباشرًا، ومنهم من لا يرى في ذلك بأسًا.
هذا كله لم يمنع من أن يصلي بعضهم خلف بعض، كما كان أبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأئمة آخرون يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وغيرهم، ولو لم يلتزموا بقراءة البسملة لا سرًا ولا جهرًا، وصلى “الرشيد” إمامًا وقد احتجم فصلى الإمام (أبو يوسف) خلفه ولم يُعد الصلاة مع أن الحجامة عنده تنقض الوضوء.
وكان الإمام مالك – رحمه الله – أثبت الأئمة في حديث المدنيين عن رسول الله – صلي الله عليه وسلم – وأوثقهم إسنادًا، وأعلمهم بقضايا عمر، وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابهم من الفقهاء السبعة – رضوان الله عليهم أجمعين – وبه وأمثاله قام عِلم الرواية والفتوى، وقد حدّث وأفتى – رضي الله عنه – وألف كتاب الموطأ الذي توخى فيه إيراد القوي من حديث أهل الحجاز، كما نقل ما ثبت لديه من أقوال الصحابة وفتاوى التابعين، وبوبه على أبواب الفقه، فأحسن ترتيبه وأجاد، وقد اعتبر الموطأ ثمرة جهد الإمام مالك لمدة أربعين عامًا، وهو أول كتاب في الحديث والفقه ظهر في الإسلام، وقد وافقه على ما فيه سبعون عالمًا من علماء الحجاز، ومع ذلك فحين أراد المنصور كتابة عدة نسخ منه، وتوزيعها على الأمصار، وحمل الناس على الفقه الذي فيه حسمًا للخلاف، فكان الإمام مالك أول من رفض ذلك .
فقد روي عنه أنه قال:”يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سبقت لهم أقاويل، وسمعوا أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم ما سبق إليهم، وعملوا به، ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله – صلي الله عليه وسلم – وغيرهم، وإنّ ردهم عمّا اعتقدوه شديد، فدع الناس، وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم، فقال أبو جعفر: لو طاوعتني على ذلك، لأمرت به”.
فأي رجل هذا الإمام الجليل الذي يأبى أن يحمل الناس على الكتاب الذي أودع فيه أحسن ما سمع من السنة، وأقوى ما حفظ وأدرك من العلم الذي لا اختلاف فيه عند أهل المدينة وذلك الحشد من علماء عصره. تلك هي اختلافات الأئمة فيما بينهم، فمن حاد عن هذا الطريق، فقد أخطأ جادة الصواب، وانحدر في الخلاف المذموم الذي يتحكم فيه الهوى.
ومن النماذج المشرفة، أيضًا، التي تدل على أدب الاختلاف ما أُثر عن الإمامين الجليلين (مالك بن أنس) (179 هـ) إمام دار الهجرة، و(الليث بن سعد) (175 هـ) إمام أهل مصر، في رسائل متبادلة بينهما بأساليب عالية، وعلوم جمة، حيث كان لكل منهما رأي في بعض المسائل الخلافية، فتراسلا في ذلك:
1ـ رسالة الإمام مالك إلي الليث بن سعد – رحمهما الله ورضي عنهما – في فضل أهل المدينة، وترجيحه على علم غيرهم، واقتداء السلف بهم: “من مالك بن أنس إلى الليث بن سعد، سلام عليكم، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، أما بعد، عصمنا الله وإياك بطاعته في السر والعلانية، وعافانا وإياكم من كل مكروه”. واعلم رحمك الله، أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مختلفة، مخالفة لما عليه الناس عندنا، وببلدنا الذي نحن فيه، وأنت في أمانتك وفضلك، ومنزلتك من أهل بلدك، وحاجة من قبلك إليك، واعتمادهم على ما جاءهم منك حقيق بأن تخاف على نفسك، وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه، فإن الله تعالي يقول في كتابه: (والسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأَنصَارِ والَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ وأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ) (التوبة: 100)،وقال تعالى: (فَبِشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الأَلْبَابِ) (الزمر: 17 – 18).
ثم يأخذ الإمام (مالك) في تبيين القواعد والأصول التي يكون عليها العمل، وبها الاستدلال، مبينًا سر الاختلاف بينه وبين الإمام الليث. ثم يختم رسالته قائلا:”فانظر رحمك الله فيما كتبت إليك لنفسك، واعلم أني أرجو ألا يكون قد دعاني إلى ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله وحده، والنظر لك والضن بك، فأنزل كتابي منزلته، فإنك إن تعلمت تعلم أني لم آلك نصحًا، وفقنا الله وإياك لطاعته، وطاعة رسوله في كل أمر، وعلى كل حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هكذا يختم (الإمام مالك) رسالته بتأكيد إخلاصه في النصيحة، وصدقه في حب الخير لأخيه (الإمام الليث)، ثم يدعو له بالتوفيق وطاعة الله ورسوله. ولصدق الرسالة، وإخلاص كاتبها، ولهذا الأدب الجم، الذي عبّرت عنه، تقع من الإمام الليث بأحسن موقع، فيجيبها بمثلها.
2ـ رسالة الليث بن سعد إلى الإمام مالك بن أنس – رحمهما الله ورضي عنهما: يعرض عليه فيها وجهة نظره في أدب جم رفيع حول كثير مما كان الإمام مالك يذهب إليه ويخالفه فيه، ونظرًا لطول الرسالة نقتطف منها ما يشير إلى الأدب الرفيع الذي اختلف في ظله سلف هذه الأمة، وكرام علمائها، يقول الليث بن سعد: “سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو أما بعد، عافانا الله وإياك، وأحسن لنا العاقبة في الدنيا والآخرة، وقد بلغني كتابك تذكر فيه من صلاح حالكم الذي يسرني، فأدام الله ذلك لكم، وأتمه بالعون على شكره، والزيادة من إحسانه …. ” ثم يقول:”وإنه بلغك أني أفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه الناس عندكم، وأني يحق على الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي على ما أفتيهم به، وأن الناس تبع لأهل المدينة التي كانت إليها الهجرة، وبها نزل القرآن، وقد أصبت بالذي كتبت به من ذلك – إن شاء الله تعالى – ووقع مني بالموقع الذي تُحب، وما أجد أحد ينسب إليه العلم أكره لشواذ الفتيا، ولا أشد تفضيلا لعلماء أهل المدينة الذين مضوا، ولا آخذ لفتياهم فما اتفقوا عليه مني والحمد لله رب العالمين لا شريك له”.
ثم يمضى الإمام الليث بن سعد في رسالته موردًا أوجه الاختلاف بينه وبين الإمام مالك – رحمهما الله تعالى – حول حجية عمل أهل المدينة مبينًا أن كثيرًا من السابقين الأولين الذين تخرجوا في مدرسة النبوة، وحملوا إلى مشارق الأرض ومغاربها، وهم يجاهدون، ما تعلموه من كتاب الله وسنة نبيه – صلي الله عليه وسلم – وبيّن أن التابعين قد اختلفوا في أشياء وكذلك من أتى بعدهم من أمثال (ربيعة بن أبي عبدالرحمن)، حيث يذكر بعض مآخذه عليه، ثم يقول: “ومع ذلك – بحمد الله – عند ربيعة خير كثير، وعقل أصيل، ولسان بليغ، وفضل مستبين، وطريقة حسنة في الإسلام، ومودة صادقة لإخوانه عامة، ولنا خاصة، رحمه الله وغفر له وجزاه بأحسن ما عمله”.
ثم يذكر من أمثلة الاختلاف بينه وبين الإمام مالك قضايا عديدة مثل: الجمع ليلة المطر – والقضاء بشاهد ويمين – ومؤخر الصداق لا يقبض إلا عند الفراق – وتقديم الصلاة على الخطبة في الاستسقاء … وقضايا خلافية أخرى، ثم قال في نهاية الرسالة :”وقد تركت أشياء كثيرة من أشباه هذا، وأنا أحب توفيق الله إياك، وطول بقائك، لما أرجو للناس في ذلك المنفعة، وما أخاف من الضيعة إذا ذهب مثلك، مع استئناسي بمكانك وإن نأت الدار، فهذه منزلتك عندي ورأيي فيك فاستيقنه، ولا تترك الكتاب إلي بخبرك وحالك وحال ولدك وأهلك، وحاجة إن كانت لك، أو لأحد يوصل بك فإني أُسرّ بذلك، كتبت إليك ونحن معافون والحمد لله، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر ما أولانا، وتمام ما أنعم به علينا. والسلام عليكم ورحمة الله”.
والرسالتان فوق ما فيهما من فوائد علمية، ونظرات أصولية، فيهما على حد تعبير الشيخ أبو زهرة: “أدب جم، وبحث قيم، ومودة صادقة، ومخالفة في طلب الحق هادية لا لجاج فيه ولا خصام، بل محبة وولاء ووئام”.
هذه هي النماذج الفريدة التي يجب أن نتحلى بأخلاقها وآدابها في الاختلاف فيما بيننا، لا أن نتنابز بالألقاب، ويُكفِّر كل مِنّا الآخر، ويرى نفسه يمتلك كامل الحقيقة، وغيره على ضلال.