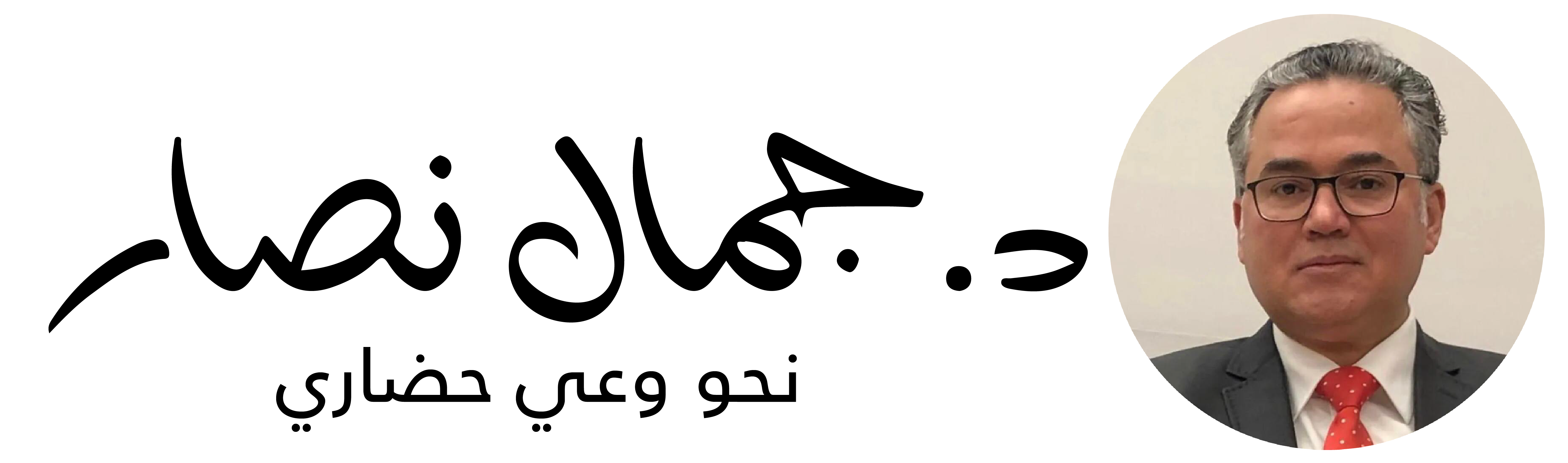الليبرالية من الناحية الفكرية تعني حرية الاعتقاد والتفكير والتعبير، ومن الناحية الاقتصادية تعني حرية الملكية الشخصية، وحرية الفعل الاقتصادي المنتظم وفق قانون السوق، وعلى المستوى السياسي تعني حرية التجمُّع وتأسيس الأحزاب واختيار السُّلطة، وهكذا نلاحظ أن مقولة الحريَّة لا تشكِّل فقط مبدأً من جملة مبادئ، بل هي مرتكز لتأسيس غيره من المبادئ.
ونستنتج من ذلك أن الليبرالية تُقدِّس الحرية الفردية وتقدمها على ما سواها، فهي مذهب إنساني مادي ينطلق من الإنسان ويتوجه إليه وينتهي به، معليًا من قيمة الإنسان فلا يكون تابعًا إلا لنفسه، ولا ممنوعًا من شيء إلا من تلقاء ذاته.
في مقابل ذلك نجد أن مفهوم (الدين) يقوم على مبدأ التسليم والانقياد والطاعة للإله والتذلل والخضوع للرب المعبود على اختلاف واسع بين أرباب الديانات السماوية، فجميع هذه الديانات تحدد الطاعات والعبادات التي يتقرب بها العبد لربه، وأنه لا بد أن يأتمر بما أمره به الرب من الالتزام بالتعاليم الدينية في الحياة.
وإذا تتبعنا جذور الليبرالية نجد أنها نشأت في كنف الفكر الغربي، إبّان ثورته على مظاهر الاستبداد في أوروبا المتمثل في (الإقطاع، والكنيسة، والملوك)، حيث ظهرت الليبرالية الاقتصادية للتحرر من تسلط الإقطاع، وظهرت الليبرالية الفكرية للحد من تسلط الكنيسة، وظهرت الليبرالية السياسية في مقابل تسلط الملوك والنبلاء.
ولم تعرف أوروبا من الدين سوى دين بولس المحرّف عن مسيحية عيسى، عليه السلام، والذي تبنته الكنيسة الكاثوليكية بعد مجمع نيقية المسكوني سنة (325م)، واستمر هذا التحريف على يد رجال الكنيسة المتحكِّمين في الناس باسم الحق الإلهي الممنوح لهم، ولمن يمنحوه من الملوك وذوي السلطان.
فقد ورد في بيان البابا نقولا زيادة: “إن البابا ممثل الله على ظهر الأرض يجب أن تكون له السيادة العليا والسلطان الأعظم على جميع المسيحيين حكامًا كانوا أو محكومين” (ول ديورانت، قصة الحضارة، 14/352).
وقال الحبر وليام تامبل: “من الخطأ الفاحش أن نظن أن الله وحده هو الذي يقدم الديانة أو القسط الأكبر منها” (محمد علي يوسف، الجفوة المفتعلة بين العلم والدين، ص11).
وقد عاشت أوروبا على هذا الفكر قرونًا عديدة إلى أن جاء (مارتن لوثر) في القرن السادس عشر، بثورته الاحتجاجية التي أسماها الإصلاح الديني، والتي أسقط من خلالها الكثير من العقائد المسلّمة للكنيسة الكاثوليكية في ذلك الوقت، وتولّدت على إثرها البروتستانتية، التي كان لها فيما بعد الدور الأكبر في نشأة الليبرالية.
وما إن أعلن مارتن لوثر عن أفكاره الاحتجاجية على الكنيسة الكاثوليكية إلا وتسابق الناس على تأييده والإيمان بما جاء به، للتخلص من هيمنة وطغيان الكنيسة الذي جثم على صدورهم لقرون، ومن ثمّ تخلوا عن الدين، بالرغم من تحريفه نكاية في الكنيسة التي سيطرت على مقاليد الأمور وقيدت حرياتهم.
يقول رونالد سترومبرج: “لا خلاف أن انفجارات الإصلاح الديني مزقت الوحدة الدينية إربًا إربًا، وقذفت أوروبا إلى متاهات الفوضى والاضطراب، وولدت مذهبًا شكيًّا ترعرع على اشمئزاز المفكرين والأدباء من التعصب اللاهوتي”.
وحدثت صراعات بالغة العنف بين الدين والعلم التجريبي من جهة والدين والعقل من جهة أخرى، حيث شكّل الصراع بين العلم والدين مشكلة تُعدّ من أعقد المشكلات في تاريخ الفكر الأوروبي حقق فيها العلم التجريبي انتصارات متتالية على حساب الدين بمفهومه الكنسي، لسببين:
الأول: تحريف حقائق الوحي الإلهي من قبل الكنيسة وخلطها بكلام البشر، حيث تحولت الخرافات الوثنية، والمعلومات البشرية إلى عقائد إلهية في صلب الدين وصميمه.
الثاني: فرض الوصاية الطاغية من قبل الكنيسة على ما ليس داخلًا في دائرة اختصاصها، حيث توهمت أن في قدرتها امتلاك الحقيقة العلمية دون اعتبار للتجربة المحسوسة، أو النظر العقلي السليم، إذا لم تكن التعاليم الكنسية قد جاءت به.
ومع مرور الوقت زادت الثقة بقيمة النظريات المخالفة لما تدعيه الكنيسة، وهو ما أفقد الكثيرين ثقتهم في الكنيسة، وأدت إلى التشكيك في معلوماتها. يقول هوايتهد: “ما من مسألة ناقض العلم فيها الدين إلا وكان الصواب بجانب العلم والخطأ حليف الدين”.
وهذا شجع جون لوك ليطالب بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض قائلًا: “من استبعد العقل ليفسح للوحي مجالًا فقد أطفأ نور كليهما، وكان مثله كمثل من يقنع إنسانًا بأن يفقأ عينيه ويستعيض عنهما بنور خافت يتلقاه بواسطة المرقب من نجم سحيق” (توفيق الطويل، قصة النزاع بين الدين والفلسفة، ص214).
وكان (هوبز) أكثر جرأة وشذوذًا في كتابه الرئيسي (لوياثان)، فيقول: “إن الدين اخترعه الناس بسبب اعتقادهم في الأرواح وجهلهم بالعلل وعبادتهم لما يهابونه” (عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، 2/560).
ومع حلول عصر التنوير في القرن الثامن عشر انحسرت دائرة الدين، وضاقت في مقابل اتساع دائرتي تقديس العقل والطبيعة، فالعقل لم يعد مقيدًا بثنائية ديكارت، بل أصبح حرًا من كل قيد وحاكمًا على كل شيء. أما الطبيعة فكان ذلك العصر هو عصر تأليه الطبيعة التي حلّت بديلا لله ومعبودة من دونه.
ثم تطور المذهب الطبيعي إلى دين الإنسانية الذي نادى به الفيلسوف أوجست كونت (1798-1857) في القرن التاسع عشر، ومنه انبثقت المذاهب المادية ذات الإنكار المطلق الصريح للوحي.
هذا الصراع بين دين الكنيسة والعلم والعقل اقتصر على الطبقات المثقفة والفلاسفة والعلماء دون جماهير الناس وعامتهم حتى وقعت الثورة الفرنسية في عام (1789م) التي كانت في أساسها ثورة دينية، غير أنها تمخضت عن نتائج بالغة الأهمية، فقد ولدت لأول مرة في تاريخ أوروبا المسيحية دولة جمهورية لا دينية تقوم فلسفتها على الحكم باسم الشعب وليس باسم الله، وعلى حرية التدين بدلا من الكثلكة، وعلى الحرية الشخصية بدلا من التقيد بالأخلاق الدينية، وعلى دستور وطني بدلًا من قرارات الكنيسة.
ولم تهتم الليبرالية بالجانب الأخلاقي، حيث لم تعد لها قيمة في النظرية الليبرالية، بل مجرد قيم تجارية تقاس كميًا بمبدأ المنفعة، ومردودها الفردي. “لذا يصح القول إن الفلسفة الأخلاقية الليبرالية هي في جوهرها لا أخلاقية، بل لن نبالغ لو قلنا إنه لم يسبق لمذهب فلسفي أن ابتذل الأخلاق وقاس قيمها بأوراق البنكنوت مثلما فعلت الليبرالية” (الطيب بوعزة، نقد الليبرالية، ص140).
ولذا أصبح من عقيدة الليبرالية نسبية الحقائق والقيم والأخلاق، وتطورها لكونها نابعة من ذات الإنسان المتغيرة بحسب الزمان والمكان، ولهذا السبب لم يعد هناك قداسة لأي فكرة أو عقيدة أو تعاليم خلا الحرية الفردية.
وهكذا وجدت أوروبا نفسها تعيش بلا دين سماوي وتتنكر لكل وحي إلهي وتفاخر بدينها الإنساني الوضعي، ولم يعد بمقدور المجتمع أن يضع حدودًا أو ضوابط للسلوك والأخلاق، أو يوجد ضوابط للأدب، أو الفن، أو الجنس، أو الإجهاض، ولا يحال بين الإنسان وبين التعبير عن رأيه ونشره بكل وسيلة يتمكن منها، مهما كان هذا الرأي أو الفكر، ما لم يتعارض كل ذلك مع حرية الآخرين