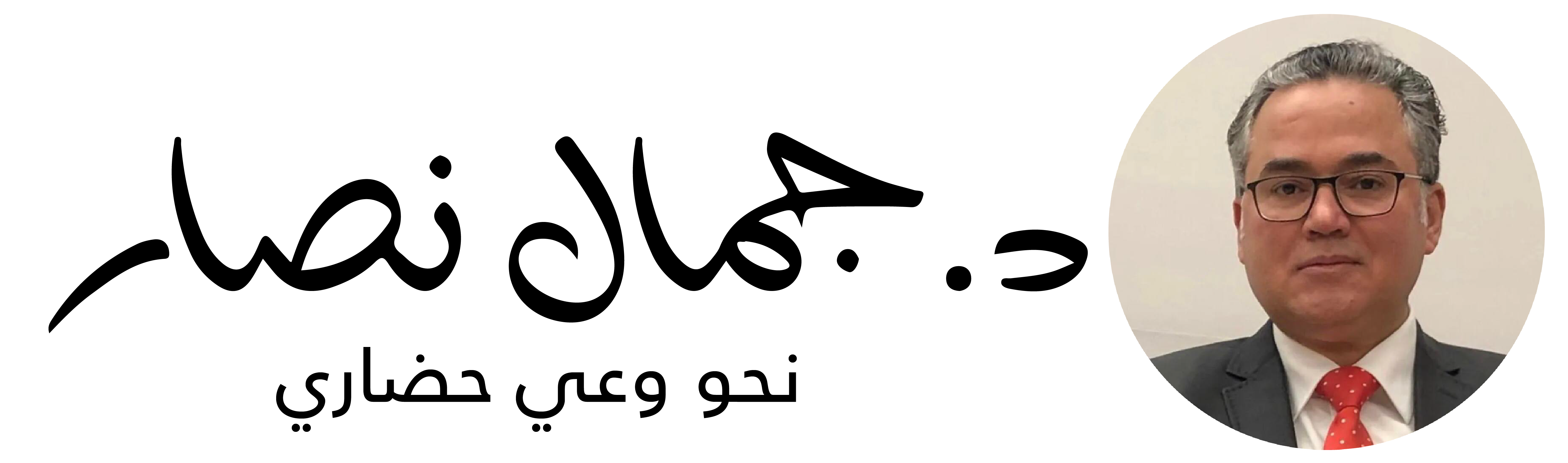د. جمال نصار – عربي بوست
هذا العالم لا يسير جزافًا، ولا يتحرك اعتباطًا، بل كل شيء فيه بقدر، وكل حركة فيه وفق قانون، وهو الذي يسميه القرآن: سنة، سواء أكانت سنة كونية أم اجتماعية. وأن هذه السنن ثابته لا تتبدل ولا تتحول، وأنها تجري على الآخرين كما جرت على الأولين، وأنها تتعامل مع أهل الإيمان كما تتعامل مع أهل الكفر: (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا) (فاطر: 43).
واستعادة حضارة المسلمين، مرة أخرى، لن تكون إلا بدراسة الأسباب التي أدت إلى زوالها، والعوائق التي تعترض العمل لذلك، وطبيعة الطريق الذي نسير فيه، وتلمس المقومات التي ترجع الأمة إليها، وإبراز المبشرات عن طريقها، وذلك كله في ضوء القرآن الكريم مع الاستعانة بأحاديث النبي العظيم، صلى الله عليه وسلم.
ويجب على المسلمين أن يفقهوا قانون الله في التغيير، فهو لا ينزع نعمة أنعمها على قوم حتى يكون منهم الإفساد والمعاصي، فإذا نزع سبحانه تلك النعمة فلن تعود إلا بالرجوع إليه، عزوجل، حسب سننه في الكون؛ وسنن الله لا تحابي أحدًا، فأيما قوم أخذوا بأسباب النجاح في الدنيا كُتب لهم. وإذا تم الرجوع الحقيقي من المسلمين إلى الله تعالى كان التمكين لهم: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (الرعد: 11)، ذلك أن الله استخلفنا في الأرض لنقوم بعمارتها بالعدل والحق والعمل الصالح: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) (هود: 61)، فمن بدل نعمة الله كفرًا جرى عليه قانون الاستبدال، وهذه سنة الله في التغيير التي ينبغي على كل مسلم أن ينطلق منها، ويجعلها أساس كل إنجازه الفكري، ويتخذ من قوله تعالى: “إن الله لا يغير..” قانونًا للتغيير بكل مستوياته، حتى يصل بالأمة إلى هدفها، وهو التمكين لدين الله في الأرض، ويبحث في وقائع التاريخ؛ ليؤكد للعالم أجمع وللعقل المسلم بصفة خاصة – باعتباره مخاطَبا بالآية – أن الله تعالى يعلمنا بها، وآيات القرآن كلها أن التغيير يخضع لسنن ربانية علينا أن نكتشفها ونوظفها في بنائنا الحضاري بكل مستوياته.
بهذا يستطيع الإنسان أن يحقق نصرة الله، فمن حقق نصرة الله حيث حقق مطلوبه عزوجل؛ بالالتزام بهذا الدين، ونشره، وتعليم الناس إياه، وبذل النفس والنفيس في سبيل إعلاء كلمته، بالجهاد والموت في سبيله، عندئذ يتحقق وعد الله الذي وعده عباده المؤمنين: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (النور55- 56). ذلك وعد الله للذين آمنوا، ووعد الله حق لن يتخلف، لكنه لا يتحقق إلا للذين آمنوا، والإيمان المقصود هنا هو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله، بخواطر نفسه، وخلجات قلبه، وأشواق روحه، وميول فطرته، وحركات جسمه، ولفتات جوارحه، وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعًا .. يتوجه بهذا كله إلى الله .. يتمثل هذا في قول الله سبحانه في الآية نفسها تعليلاً للاستخلاف والتمكين والأمن: (يعبدونني لا يشركون بي شيئًا)…. ذلك الإيمان منهج حياة كامل، يتضمن كل ما أمر الله به، ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب، وإعداد العدة، والأخذ بالوسائل، والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض .. أمانة الاستخلاف.
فالإيمان بهذا المعنى جهاد حقيقي، بمفهومه الكبير وفضائه الواسع، وهذا الجهاد هو سبيل الهداية إلى السنن الإلهية والقوانين الربانية، وهو من أخص شروط الحضور الميداني، وممارسة الفعل الحضاري (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ) (العنكبوت: 69).
والنفرة لهذا الجهاد الكبير، ومعرفة الواقع بكل مكوناته، ومحاولة تحليله، وإرجاعه إلى عوامل نشوئه، وأسباب علله هو من الفروض الحضارية التي تمنح الفقه والهداية والعبرة، وتقي الأمة من الإصابات: (قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ) (آل عمران: 37-38).
فهذا النص صريح في الدعوة إلى الانفتاح على المجتمعات الأخرى، والاستفادة من تجاربها الذاتية؛ لأن هذا السير يُعد مصدرَ معرفةٍ حضارية، وهو – بهذه الآية – من عطاء الوحي أيضًا، ولا بد من معيار دقيق يحكم هذا السير، حتى لا يكون الذوبان في عقائد غيرنا الفاسدة، وإذا تم هذا السير وفق معايير القرآن الكريم كان الهدف من التبادل المعرفي، وهو إغناء التجربة الذاتية من خلال الفضاء الحضاري.
وفكرة البناء الحضاري في القرآن الكريم تؤكد أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، مأمور بتعميرها وبناء الحضارات فيها على أساس مبادئ القرآن الكريم، وهنا يدرك الإنسان المعنى الشامل للإسلام، ويدرك معنى قوله، صلى الله عليه وسلم: “وَفِي بُضْع أَحَدكُمْ صَدَقَة”، وكيف جعل الإسلام الاستمتاع بالنساء والتلذذ بالشهوات – إن هي طُلِبَت من بابها – عبادة، فتجاذب مع الفطرة الإنسانية ولم يتصادم معها، في حين أن الأديان الأخرى حرمت على الملتزمين بها الاستمتاع بالنساء، فاحتال أتباعها على قوانينها وضوابطها، أو تخلّوا عنها.
كذلك يدرك الإنسان أن الإسلام قد شمل الإنسان بكل كيانه، وشمل حضاراته بكل ما فيها، وحوى الدنيا بأسرها، ولم يترك الإنسان يتخبط في غياهب الأوهام.
وعند تحقق هذا الاستخلاف في الأرض فسيكون استخلافًا راشدًا، سيكون استخلافًا مصحوبًا بقدرة على إعمار الأرض وإصلاحها، لا استخلافًا قائمًا على الهدم والإفساد، وسيكون تمكينًا يحقق العدل والطمأنينة، لا تمكينًا يقوم على الظلم والقهر، سوف يسمو هذا الاستخلاف بالنفس البشرية والنظام البشري نحو السماء، متعاليًا بالفرد والجماعة عن مدارج الحيوان!
فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض، وينشرون فيها البغي والجور، وينحدرون بالإنسانية إلى مدارج الحيوان .. فهؤلاء ليسوا مستخلفين، إنما هم مُبْتَلون بما هم فيه من نعيم أو مُلك، أو مُبْتَلَى بهم، ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها الله وعند تَمَلُّك هؤلاء المفسدين فإن النكسة ستتحقق للبشرية؛ لأن هؤلاء المفسدين غالبًا ما يُحكِّمون أهواءهم، ويتبعون نزواتهم، ويعملون لحساب أنفسهم: (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) (المؤمنون: 71)؛ ولذا كانت حكمة الله تعالى أن الإنسانية حين تصل في نكستها إلى السفح يأذن الله لدينه أن ينبعث من جديد ليؤدي دوره.
إن التمكين في الدين الإسلامي ليس الانتصار على الأعداء فحسب، ولا القضاء على معتنقي الأديان الأخرى، فيما يبدو لنا من أعمال معتنقيها، وكذلك ليس في اغتصاب الأرض وطرد أهلها منها، كما هو حادث اليوم على أرض المسلمين في شتى بقاع الأرض، وإن كان الناس اليوم يقصرون معنى النصر على هذه الصور المادية المعهودة لهم، قريبة الرؤية لأعينهم، بل الانتصار الحقيقي هو انتصار عقيدة المؤمن في نفسه أولاً، فقد يفارق المسلم الحياة ولم ير ثمرة من ثمار عمله، ولم ير نصرًا على أعداء الله لكنه في الحقيقة انتصر؛ لأن صور النصر شتى، وقد يتلبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة .. فإبراهيم عليه السلام وهو يُلقى في النار فلا يرجع عن عقيدته ولا عن الدعوة إليها .. أكان في موقف نصر أم في موقف هزيمة؟ ما من شك في منطق العقيدة أنه كان في قمة النصر وهو يلقى في النار، كما أنه انتصر مرة أخرى وهو ينجو من النار، هذه صورة وتلك صورة، وهما في الظاهر بعيد من بعيد، فأما في الحقيقة فهما قريب من قريب!