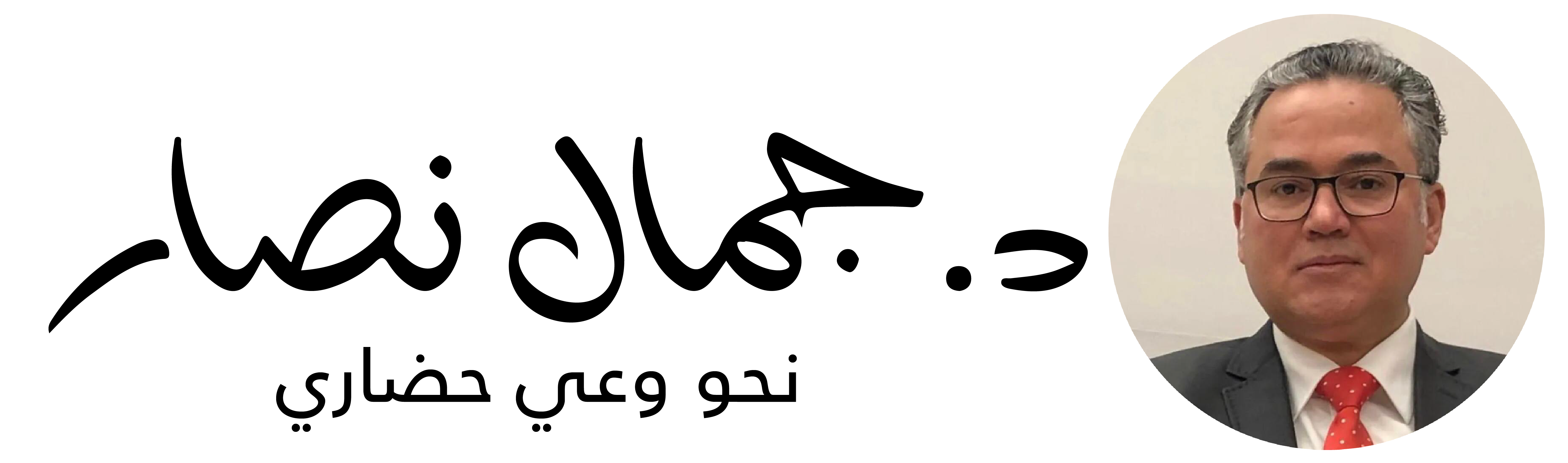د. جمال نصار
كثيرة هي تلك القضايا التي تمر دون مراجعة وتمحيص كافٍ حتى تغدو من المسلمات التي نبني عليها القوانين والنظريات، وكثيرًا ما نعمم هذه القضايا وتلك النظريات. إننا بحاجة، حقًا، لمراجعة كل مناهج البحث، وكل النظريات المستنبطة المبنية على هذه المناهج.
تخيل أن رجلا يجلس في مكتبه المريح، ينعم بمكيف الهواء النقي، يمسك قلمه ويحكم على حرب ضروس تدور رحاها في بقعة ملتهبة من الأرض، وتخيل رجلا يورد نصًا يستشهد به في قضية ما دون أن يحترم عقولنا، ويورد السياق الذي ورد فيه هذا النص، فالسياق له دور كبير في الوقوف على دلالات النص، وتفسير معناه؛ فقد قال الله، سبحانه وتعالى، على لسان نبيه في أهل بدر: اعملوا ما شئتم، وقال تعالى للمعرضين (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ) (فصلت: 40). إنّ الذي يفصل بين كلا الجملتين هو السياق الذي وردتا فيه، ففي الحديث سياق مدح وعطاء، وفى الآية سياق تهكم وسخرية.
هذه الكلمات آثرت أن أبدأ بها؛ لتكون الصيحة التي تفيق من يقول إن التعليم في الإسلام كان دينيًا فحسب، أقول أولاً وقبل كل شيء، إن الإسلام حرص على حضّ المسلمين وتشجيعهم على التعلم، فكان أول ما نزل (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) (العلق: 1)، و(ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) (القلم: 1). إن دينًا تكون أولى تعاليمه الحضّ على العلم والتعلّم لهو دين يدعو إلى التصديق بالقلب والعقل، لا يقبل إيمانًا ظاهرًا هشًا. إن دينًا تكون هذه أولى تعاليمه لهو دين العلم والعلماء، وليس بدين لاهوتي. إن دينًا تكون هذه أولى تعاليمه فهذا منهجه، وهذه مبادئه.
وامتدادًا لهذه التعاليم قصر الله، سبحانه وتعالى، الخوف منه على العلماء، فقال: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء) (فاطر: 28)، بل إنه، سبحانه وتعالى، ليضع المؤمنين مع الذين أوتوا العلم في ميزان واحد، وكفة واحدة، فيرفعهم درجات كثيرة، فيقول: (َيرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) (المجادلة: 11)، وليس هذا موضع استغراب في ديننا، فالدين والعلم شيء واحد، والمؤمنون هم العلماء، وما العلماء إلا المؤمنون.
وامتدادًا لذلك قال النبي، صلى الله عليه وسلم: “فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب” (أخلاق العلماء، الآجري، ص10)، بل إن موت الإنسان ليُوقف تعداد حسناته إلا ثلاث، منها: “أو علم ينتفع به”. بل ذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك حين فرض طلب العلم على كل مسلم ومسلمة، ليرتفع بذلك إلى درجة الصلاة والزكاة وغيرها من الفرائض.
وإنك لتعجب أكثر حين تعلم أن هذا الاهتمام لم يكن في بيئة العلم والمعرفة، ولم يكن في زمن العلماء فيه يحكمون ويسودون على من عداهم، بل كان هذا الاهتمام في مجتمع الجهل سمته، والضلال شعاره.
جاء الإسلام وعدد محدود من العرب يجيدون القراءة والكتابة، بل كان أكثرهم يعتمدون على الحفظ والرواية، فشجّع المسلمين على العلم وطلبه، واتخذ كل الوسائل الممكنة في ذلك، حتى كان فداء أسرى بدر أن يعلم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، وكان زيد بن ثابت كاتب وحى النبي، صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء المتعلمين، وبذلك أقرّ الإسلام التعليم ودعا إليه على ما كان يعانيه المجتمع آنذاك من الجهل والتعصب.
ولم يكن التعليم في الإسلام دينيًا فحسب، وإن كان هذا هو أساسه، أن ينطلق من مبدأ ديني، وحين قال المصطفى، صلى الله عليه وسلم: “طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة” (سنن ابن ماجة، 1/269)، لم يكن يقصد علمًا بعينه، وإنما أراد التعميم. وقد قسّم الفقهاء العلم إلى قسمين:
علم ديني: وهو كل العلوم التي تتصل بالدين الإسلامي من علوم القرآن، والحديث، وغيرها.
علم دنيوي: وهى تلك العلوم التي تتصل بالحياة العملية كالرياضيات، والفلك، والفلسفة، والطب، وغيرها.
إلا أنني أميل إلى تأكيد التواصل بين العلوم، فالكل علم. إن الرياضيات وعلوم القرآن علم واحد، انطلاقنا إليها من تشجيع الإسلام، وغايتنا فيها الوصول إلى الحقيقة، والتعبد بها إلى الله. إن ديننا الحنيف يُقر أن المشتغل بالكيمياء، أو الطب، أو غيره من العلوم هو متعبد بها لله، عز وجل، طالما يبتغى مرضاته، أرأيت شريعة تقرر أن المشتغل بالعلم يمارس عبادة جليلة يثاب عليها من الله، عز وجل، سوى الإسلام؟!
كذلك هناك من العلوم ما يكون تعلمه واجب كالعلم بالقرآن والحديث وما يتصل بالشريعة الإسلامية، لا إلى حد الإلمام بها، وإنما إلى حد المعرفة والعلم. ومن العلوم ما يكون تعلّمه فرض كفاية أي: ليس على كل المسلمين أن يتعلموه، وإنما واجب أن يتعلمه بعضهم، فيسقط عن الكل، بعكس العلم الواجب تعلمه على كل الناس وهو العلم بالدين، ومن أمثلة علوم فروض الكفايات الطب، والهندسة، والفلسفة، والفلك، وغيرها من العلوم الدنيوية.
يضاف إلى ذلك أيضًا علوم الحرف والمهن، فيجب على المسلمين أن يكون من بينهم الحائك، والنجار، والسائق، والكهربائي، وحتى الإسكافي، وأقول هذا واجب إذا قام به البعض يسقط عن الكل، أما إذا كان في مدينة ليس بها نجار مثلاً، فإن هذه المدينة آثمة كلها حتى يكون فيهم نجار.
وحين نقول إنها من فروض الكفايات لا نهبط بها إلى مرتبة دونية، وإنما نضع لها حكمًا وتوصيفًا إلهيًا، فالطعام والشراب من المباحات رغم أن عليهما عماد الحياة وقوام العيش.
إذن فالإسلام يحتم على الإنسان أن يكون له مهنة يمتهنها، وحرفة يتعلمها؛ حتى يكون منّا الصانع والفلاح وسائر أنواع الحرف التي نحتاج إليها. فالإنسان حرّ في أن يختار الثغر الذي يقف عليه، ليكون كفئًا وحارسًا على هذا الثغر، لتصل سفينة المجتمع إلى بر الأمان.
وأخيرًا يقول تعالى:(وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) (التوبة: 122)، كذلك لا يصح في ديننا أن ينفر الناس جميعًا للقتال، ولا أن يقعدوا جميعًا، فتنفر فئة وتقعد أخرى تعلم الناس، فلا يجوز أن يصبح المجتمع كله أطباء، ولا يمكن ألا يكون في المجتمع طبيب واحد. هذه هي حرية التعليم في ديننا الحنيف، فانظر أي الثغور تحب أن تكون عليه فأنشط إليه، وانظر هل ترى ذلك في شريعة أخرى؟!
فعلى المسلمين أن “يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفي وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها، لتقوم مصالحهم، وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم، وغاية ما يقصدون قصدًا واحدًا، هو قيام مصلحة دينهم ودنياهم” (تفسير السعدى، ص 355).