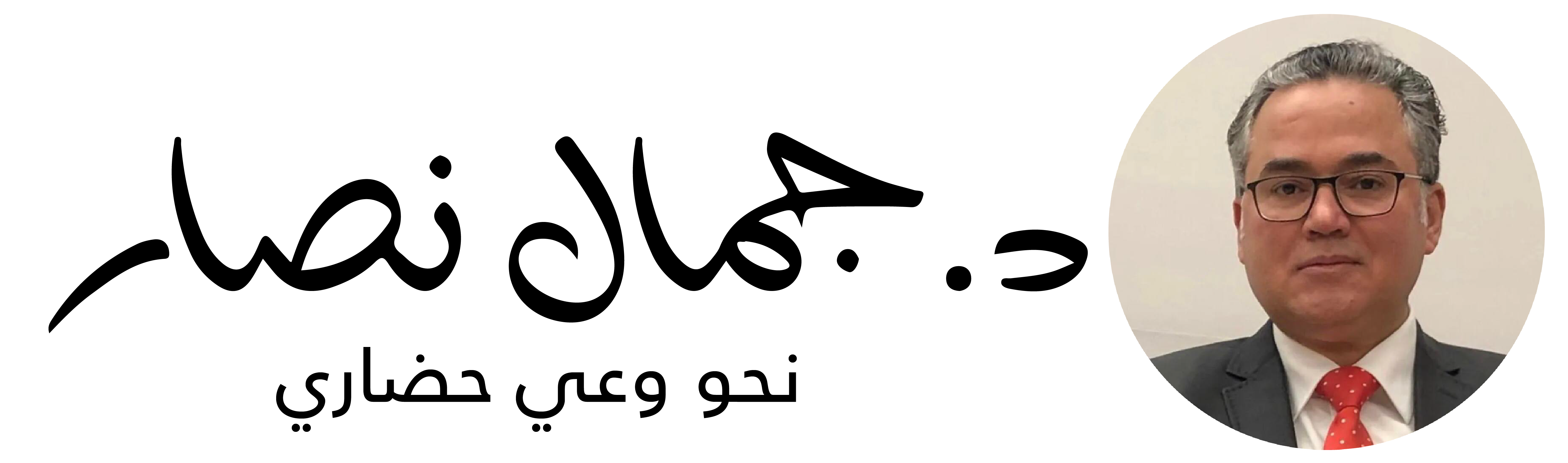د. جمال نصار
لقد تميز الإسلام بالسماحة واليسر وصلاحية التطبيق في كل زمان ومكان؛ فتعاليمه السمحة تنبثق من علم الله بطبيعة النفس البشرية. لكن ابتعاد الإنسان عن هدى الإسلام جرّ عليه الكثير من المفاهيم الخاطئة التي تطمس وجه الحق، وتزيّف الحقائق، وتقوّض أركان عقيدته، مما يوجب على علماء الأمة ضرورة تصحيح الصورة، والقيام بأعباء تلك الحرب الضروس، ووضع الأمور في نصابها.
ومن أهم هذه المفاهيم الخاطئة، القول بسبق النظم الوضعية، والثقافة الغربية بإقرار حقوق العدل والمساواة منذ انطلاق الثورة الفرنسية في 26 أغسطس 1789م التي رفعت شعارات: الحرية، والعدل، والمساواة.
وغاب عن نظر الكثيرين أن الإسلام سبق إلى إقرار هذه المبادئ منذ انطلاق دعوته؛ فقد قرر حرية العقيدة حين قال تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (البقرة: 256)، وقرر العدل حين قال تعالى: (وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى) (الأنعام: 152)، وقرر المساواة حين قال المصطفى، صلى الله عليه وسلم: “الناس سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى“، وبذلك سبق الإسلام زمنيًا النظريات الوضعية إلى إقرار هذه المبادئ. ليس هذا فحسب، بل إن ما “عرفته فكرة الحضارة الغربية حديثًا في باب حقوق الإنسان، قد عرفته الحضارة الإسلامية بل ومارسته قديمًا لا كمجرد حقوق للإنسان، وإنما كفرائض إلهية، وتكاليف وواجبات شرعية” (محمد عمارة، الإسلام والأمن الاجتماعي، ص83).
لا نقول هذا الكلام رجمًا بالغيب، ولا تقولاً على الله، عز وجل، فالله تعالى “جعل إقامة هذا الدين تكليفًا فرضه على الإنسان، وكما هو معروف أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن هذا الدين لا يقوم على الظلم، ولا يقوم مع الكيل بمكيالين، فإقامة الدين، وحفظ الضرورات الخمس، لا تقوم إلا على الحرية والعدل والمساواة وغيرها، لذلك فهي من الواجبات لا الحقوق” (عمارة، السابق، ص18).
بل ذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك حين قرر أن حفظ البدن والنفس مقدم على حفظ الدين؛ “لأن الدين لا يقوم إلا بالمحافظة على تلك النفس وهذا البدن، فعلى النفس تقع التكاليف الشرعية، الأمر الذي يستوجب المحافظة على صحة البدن وبقاء النفس للقيام بهذه التكاليف، والعمل على إقامة الدين” (محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان، ص16).
وبذلك ارتفع الإسلام بهذه المبادئ إلى درجة الضرورات التي لا يجوز لأحد أن يتنازل أو يتخلى عنها مكرهًا أو راضيًا، فكما لا يستطيع الإنسان أن يعيش بلا طعام أو شراب أو مسكن، فكذلك لا يستطيع العيش بلا حرية.
والإسلام السمح لا يقف عند هذا الحد، فإنه لا يكتفي بتقرير هذه المبادئ، وجعلها من ضرورات الحياة، بل يتعدى ذلك إلى إطلاق صفة العموم على هذه الضرورات، فمنحها لكل بني البشر بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الدين؛ ليثبت بذلك تهاوي العنصرية الغربية، وليجعل الجميع على قدم المساواة، لأننا نعيش في سفينة واحدة، فالربان والعامل يتكاتفان للوصول بها إلى بر الأمان.
هذا الكلام؛ لتوضيح حقيقة الأمر، ورغبة أكيدة في العودة إلى منابعنا ننهل منها ونكشف مزاياها، ولا نتسول الحرية والعقلانية عند من فقدها، ويدّعي أنها منه وإليه تعود “فما في النار للظمآن ماء”، وحتى لا نكون:
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول
وتلك خطوة في سلم إعادة استقراء إسلامنا، تحتاج إلى المزيد؛ لنصل معًا لا إلى سعادتنا، وإنما سعادة العالم بأسره، فتلك مهمتنا، وهذا قدرنا، وما رسالتنا إلا ذاك؛ لنملأ الكون عدلاً، كما جاوز الحد جورًا.
وللأسف من بني جلدتنا من ينكر ذلك، رافضًا الإسلام حكمًا، ويدّعى البناء والمعول في يديه، فعلينا أن نشحذ الهمم، ونحمل عبء هذه الرسالة على كاهلنا، فالطريق جد عسيرة، والرسالة لا بد لها من وصول، والغاية واضحة، والجنة غالية، “ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر”، و “البحر الهادئ لا يصنع ملاحًا ماهرًا”.
مفهوم الحرية في القرآن والسنة
من أبجديات الشريعة الإسلامية أن القرآن والسنة كفلا الحرية بصورها المختلفة، وتنوعت أشكال وطرق وأساليب تناولها وتقريرها، والسنة في ذلك وضّحت ما ورد القرآن الكريم؛ فالقرآن حمّال أوجه، والسنة فسرت ما جاء في القرآن الكريم.
ولأن القرآن ظني الدلالة، في آيات كثيرة، ولبعد الإنسان المعاصر عن فترة نزول الوحي، واحتمال أساليب اللغة لكثير من التأويلات والتفسيرات، التبس الأمر على كثير من المسلمين فيجدون أن الله منح الإنسان كامل الحرية باعتباره مسؤولاً عن أفعاله، ثم يجدون من الآيات ما يدل ظاهره أن الإنسان لا يملك الخيار، وأن الله قرر سلفًا الصالح والطالح، مما حدا بالبعض أن يرمي القرآن الكريم بالتناقض والغموض وعدم الوضوح!
والقرآن الكريم يعطي الحرية للإنسان والخيار في سلوك طريق الخير أو الشر، فالإنسان يستطيع بعقله أن يختار ما يرغب فيه، وما يناسبه، وله في ذلك الحرية الكاملة. قال تعالى: (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ) (الكهف: 29)، وقال: (إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً) (الإنسان: 3)، هذه الآيات، وغيرها كثير، تجعل الخيار بيد الإنسان، وتمنحه مطلق الحرية في اختيار الطريق الذي يتعين عليه تقبل عاقبة اختياره وتداعياته.
وعلى الجانب الآخر، نجد العديد من الآيات تشير إلى أن الإنسان لا يملك لنفسه هداية، وليس له حق الاختيار الذي هو بيد الله وأمره، إن شاء منحه، وإن شاء منعه. قال تعالى: (فَرِيقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ) (الأعراف: 30)، وقال: (فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ) (النحل: 36)، وقال: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ) (القصص: 56)، وقال: (مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُّرْشِداً) (الكهف: 17). وغيرها كثير مما يقول بأن الهداية من الله إن شاء هدى الإنسان إلى ينابيع الخير والإيمان، وإن شاء أماته عطشًا وما حوله إلا الماء.
في حين أن هناك آيات تقول بأن الله له المشيئة في ذلك، ولو أراد أن يهدي الناس جميعًا لفعل، ولو أراد أن يكونوا أمة واحدة لكان، مما حدا بالبعض أن يظن أن سعي الإنسان عبث لا طائل منه، قال تعالى: (وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَـكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم) (المائدة: 48)، وقال: (وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى) (الأنعام: 35). بل أكثر من ذلك، فالله، سبحانه وتعالى، يتجاوز عمن يشاء، ويعاقب من يشاء؛ قال تعالى: (فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (البقرة: 284).
كذلك فإن الله يزيد الضال ضلالاً، ويزيد المهتدي هدى، قال تعالى: (وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ) (الزخرف: 36)، وقال: (وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى) (مريم: 76).
فما هو وجه الحق؟! وهل ثمة تعارض بين الآيات؟! وهل المجال مفتوحًا للتوبة والإنابة؟! نجد أن السنة وضحت القرآن الكريم وفسرته، كما تناولت أنواع الحرية المختلفة، وباستقراء كتب السنة نعلم أن هناك الكثير من الأحاديث التي تناولت الحرية، وأقرتها، وجعلت لها أولوية خاصة؛ نظرًا لما يترتب عليها من مصالح إن هي طُبقت وفُهمت وفق المنهج الإسلامي، ومفاسد ومضار إن هي حُرّفت وبُدّلت، وكانت السنة في ذلك واضحة تمامًا، فالأحاديث يؤيد بعضها بعضًا، ويعضد بعضها بعضًا.
ففي حرية اختيار الحاكم، لم ينص رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صراحة على خليفة من بعده، رغم وجود أحاديث تشير ضمنًا إلى استخلاف أبي بكر، رضي الله عنه، وترك الرسول، صلى الله عليه وسلم، لأصحابه الحرية الكاملة في اختيار خليفته، فقد تربوا على تحمل المسؤولية، والقيام بالأمر خير قيام. وقرر المصطفى، صلى الله عليه وسلم، حرية إبداء الرأي وأثاب عليها، ولم يكن بالذي يستبد برأيه، وحضّ على قول الحق ورفض الظلم؛ فقال المصطفى، صلى الله عليه وسلم: “إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك ظالم فقد تُودِّع منهم” (مسند أحمد). وكثيرًا ما كان يشير على أصحابه ويقبل منهم، وأخبار الحباب بن المنذر في ذلك مشهورة حين أشار على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بتغيير مكان الجيش في بدر فقبل منه وأثنى عليه. وقرر كذلك حرية التملك التي شغلت كثيرًا العالم الغربي لإقرارها، فقال، صلى الله عليه وسلم: “إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله” (مسند أحمد).
من ذلك كله نفهم أن الإسلام قد أقرّ الحرية بأنواعها المختلفة، ورغم أن ذلك تشريف للإنسان إلا أن تقرير الحرية لا يعني إثبات شيء قد منح لنا، بل هو تقرير لمهمة علينا أن نعمل على تحقيقها. فالحرية تكليف خطير على الإنسان، عليه أن يسعى لاستغلالها الاستغلال الأمثل، فهي طريق النجاة، وسلم الوصول.
ولكن يجب التأكيد أن هذه الحرية سلاح ذو حدين، فيمكن أن تكون سببًا في تقدم المجتمع ورقيه، ويمكن أن تكون سببًا في هلاكه واضمحلاله. وعلى كل حال فالحرية هي القيمة التي ينشدها الإنسان والحيوان على حد سواء، ولا مجال للتخلّي عنها مهما كان الثمن.
إن إقرار القرآن الكريم والسنة النبوية لدعائم الحرية ليدل بما لا يدع مجالاً للشك على أهمية الحرية ودورها الفعّال في بناء المجتمع، فعليها تدور قيم كثيرة، وانطلاقًا منها تتبلور نظرة الناس للحياة والمجتمع.