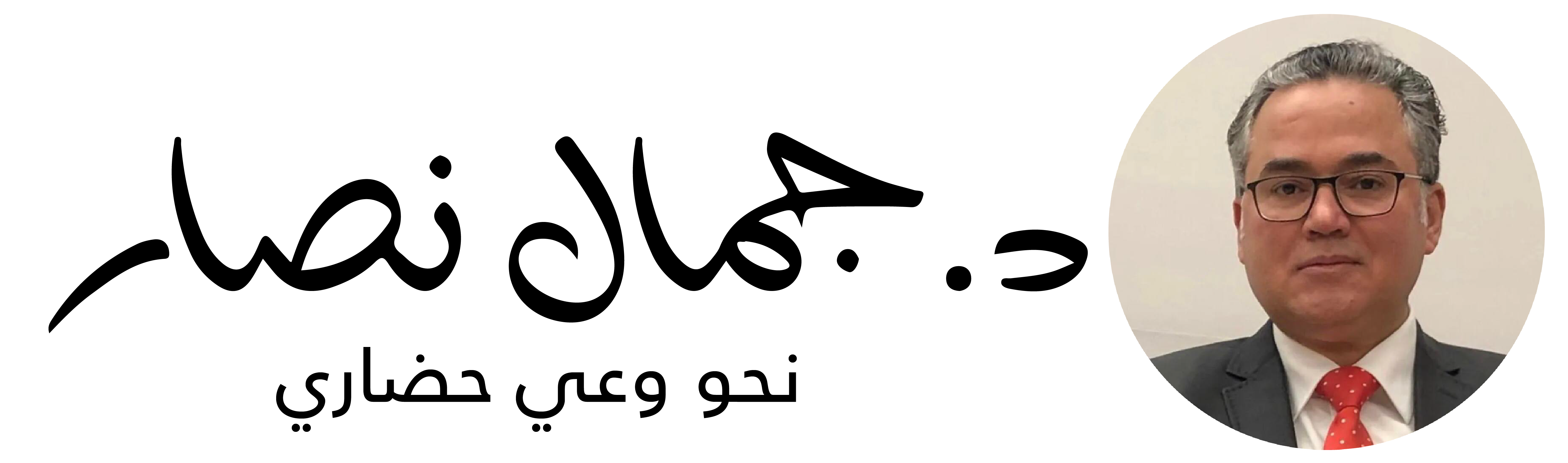د. جمال نصار – عربي بوست
منذ أكثر من عام وهناك حملة كبيرة من قبل الحكومة المصرية على الدروس الخصوصية، التي تسميها (السناتر) لتقوية الطلاب، وهذه الظاهرة موجودة منذ عقود، ومنتشرة في أرجاء وقرى ونجوع مصر، وأصبحت من ضرورات الحياة لكل أسرة.
فرب الأسرة كما يرصد مصاريف البيت والإيجار، وغير ذلك من تكاليف الحياة، أصبح منذ فترة يدخل ضمن قائمة المصاريف ما يتعلق بالدروس الخصوصية، ويمكن أن يكون هناك أكثر من شخص في الأسرة يلتحق بتلك الدروس، لأنه بطبيعة الحال، لا يستطيع رب الأسرة، في غالب الأحيان، أن يعطي درس خصوصي عن كل مادة، فالتالي يكون البديل المناسب مجموعات التقوية، أو السناتر.
ما الذي يدفع الطلاب وذويهم للدروس الخصوصية؟
أصل الحكاية هي أن مستوى التعليم في مصر وجودته وصل إلى مرحلة يندى لها الجبين، ولا تليق بمكانة مصر التي كانت في فترة من الفترات تُصدّر المعلمين والأساتذة في التخصصات المختلفة لكل الدول العربية، ومن ثمّ لن يكون لمصر موطئ قدم في النهضة دون الاهتمام بالتعليم، فبداية النهضة في كل مكان هو التعليم الجيد.
فمصر تعاني منذ فترة من إهمال كبير في التعليم، وعدم مواكبة الأنظمة التعليمية الحديثة، ولا يهتم القائمون على العملية التعليمية بوضع نظام يسمح بتطوير التعليم بداية من المدرس الذي يقوم بالتربية والتعليم، وانتهاء بالإمكانيات المتواضعة التي لا تتناسب مع الحد الأدنى للتعليم المناسب الصحيح، مما تسبب بتهالك المنظومة التعليمية المصرية تمامًا، وجعلها منظومة تعليم فاشلة تُخرّج خريجين غير مؤهلين للعمل في المؤسسات الأساسية، والمصالح الحكومية في الدولة.
ناهيكم عن تكدّس التلاميذ في المدارس بشكل مخيف، حيث يصل كثافة الفصل في المراحل الابتدائية في معظم المدارس الحكومية إلى أكثر من 100 تلميذ، ويلاحظ أن عدد غير قليل من التلاميذ يجلس على الأرض أحيانًا، لعدم استيعاب المقاعد لهذا الكم الكبير.
ينضاف إلى ذلك عدم الاهتمام بالمدرسين الذين يقومون بالعملية التعليمية، ويُناط بهم تعليم الأولاد بشكل مناسب، فرواتبهم لا تكاد تكفيهم لسداد مؤونة الحياة، مما يدفعهم دفعًا إلى العمل الإضافي من خلال دروس خصوصية في البيوت، أو في مجموعات تقوية في المدرسة أو خارجها. وبالتالي تكون التكلفة الفعلية للعملية التعليمية على كاهل أولياء الأمور الذين يعانون بشكل كبير من غلاء الأسعار، وضيق المعيشة في المجمل.
أين الحكومة ودورها في حل المعضلة؟
للأسف تتصرف الحكومات المتعاقبة منذ فترة طويلة مع هذه المسألة بطريقة غير لائقة، فلا هي تُحسِّن من جودة التعليم ورسالته، من خلال مناهج متميزة، كما لا تهتم أيضًا بالرفع من شأن المُعلم الذي يقوم بالعملية التعليمية، فلا يوجد في غالب الأحيان برامج تدريبية تُؤهّل المعلم للقيام بواجبه على أكمل وجه، ولا يحصل على مقابل يتناسب مع الجهد الذي يبذله.
والنتيجة في النهاية أن كل مفردات العملية التعليمة أصبحت مفككة لا تستطيع أن ترقى بمستوى التلميذ في المدرسة، أو الطالب في الجامعة، وعليه تخرج أجيال غير مؤهلة لمواكبة الحياة، وتصطدم بالواقع، ويؤثر ذلك بطبيعة الحال على مجمل مؤسسات الدولة بالسلب، وعدم الكفاءة.
وحينما أرادت الحكومة المصرية التدخل لمواجهة ظاهرة انتشار السناتر في عموم الجمهورية، فكان وسيلتها إما المنع والمواجهة، وإما التأميم لصالح وزارة التربية والتعليم.
فبدلًا من الاهتمام بأصل المشكلة، ومعالجتها بطريقة علمية، تلجأ إلى أسهل طريق، كما هو حادث في كل مؤسسات الدولة، بالمصادرة والمنع، وعدم الاهتمام بالتعليم بالشكل المناسب.
ومن أهم مظاهر المواجهة التي قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التعليم إصدار تعليمات للمحافظات بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية (السناتر)، وعدم السماح بأي مخالفات أو تجاوزات في هذا الشأن، حسب قولهم، ومن ذلك:
- 1. تكثيف الحملات من قبل الأحياء بالتنسيق مع الإدارات التعليمية لغلق أي سنتر مفتوح.
- 2. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي أنشطة تعليمية خارج المدارس من غلق وتشميع للمركز.
- 3. تحرير محضر وغرامة ضد المخالفين.
- 4. دعوة المواطنين إلى الإبلاغ عن مراكز الدروس “السناتر” للتعامل معها.
- 5. منع التجمعات بحجة الحفاظ على سلامة الطلاب.
كل هذه الإجراءات وغيرها لن تفيد في حل المشكلة من أساسها، بل ستخلق جوًا مضطربًا بين أولياء الأمور والمعلمين، وفي الغالب ستزداد التكلفة على كاهل رب الأسرة الحريص على مستقبل أولاده، مما يدفعه إلى تكثيف الدروس الخصوصية في المنزل، وبالتالي الزيادة الجنونية في أسعار الدروس، التي لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع الدخل الضعيف لمعظم الأسر في مصر.
المعيار الحقيقي لتقدّم الدول هو التعليم
دون الدخول في تفاصيل إدارة المؤسسات المختلفة في مصر، والاهتمام الزائد بالمشاريع التي تبني الحجر ولا تبني الإنسان، نجد أن الميزانية المخصصة للتعليم لا يمكن أن تساهم بشكل أو بآخر في إخراج جيل مميز يستطيع حمل الأمانة، أو المساهمة في تطوير البلد وازدهارها.
ولذلك نجد في الكثير من الإحصائيات أن ترتيب مصر في جودة التعليم يكون في وضع متدني للغاية لا يتناسب مع حجم وأهمية مصر، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن ترتيب مصر 139 على المستوى العالمي.
وإذا نظرنا إلى نموذج من الدول المتقدمة التي اهتمت بالتعليم، وكان سببًا مباشرًا لتقدمها، لأنها سلكت الطريق الصحيح لتطوير كل مفردات العملية التعليمية، سنجد أن من أبرز النماذج على ذلك دولة فنلندا، حيث تمكنت هذه الدولة الصغيرة من تحقيق نتائج باهرة جعلت العالم المتقدم يقف مذهولًا أمام إنجازاتها التربوية والتعليمية وتجربتها الفريدة من نوعها، التي أصبحت نموذجًا عالميًا في تبني نظام الجودة في التعليم.
حيث تقوم العملية التعليمية على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلّمين، فالمدارس حكوميّة مدعومة ومموّلة من الدولة، ولا فرق في المستوى بين مدارس المدن، أو الأحياء الميسورة والمدارس في مجمّعات قرويّة أو أحياء شعبيّة. والبداية الحقيقية من خلال التوافق والانسجام والتجانس التام بين ثلاثة عناصر رئيسية:
أولًا: الاهتمام بالطفل: حيث بدأت فنلندا الاهتمام بالأطفال وتعليمهم، وأطلقت حملة تحت شعار “لن ننسى طفل”، لتشجيع جميع الأطفال على التعليم، ونتيجة لذلك بلغت نسبة الفنلنديين الذين أنهوا التعليم الإلزامي 99%.
ثانيًا: مجانية التعليم حتى للأجانب: فالتعليم إلزامي على جميع المواطنين في مرحلة التعليم الأساسي، وتلتزم الدولة بمجانية التعليم حتى المرحلة الجامعية. كما تلتزم الدولة في مرحلتي التعليم قبل الابتدائي، والتعليم الأساسي بتوفير الكتب الدراسية، والوجبات اليومية، ووسائل النقل للطلاب المقيمين بعيدًا عن المدرسة بأكثر من 3 كيلومترات.
ثالثًا: المعلم أساس المعادلة: فليس من السهل أن تصبح معلمًا إذ إن خريجي الجامعات حديثي العهد لا يُرسلون لتشكيل عقول الأطفال مباشرة بعد التخرج، بل يجب على كل المعلمين (باستثناء معلمي الروضة) أن يكملوا برنامج ماجستير عالي التنافسية، ومدعوم بالكامل من الدولة. صحيح أن المعلم في فنلندا يخضع لتأهيل علمي وتدريب شاق قبل التدريس، إلا أن الأمر يستحق في مقابل ما يحصل عليه من مكانة وتقدير ووسائل تساعده على إتمام رسالته بنجاح.
وفي النهاية أقول إن السياسات التي تتبعها الدولة المصرية في التعليم للأسف، ستؤدي إلى انهيار العملية التعليمية، وسيكون الحصاد مرًّا على جميع المستويات والمؤسسات، ومن ثمّ ستخرج أجيال خاوية لا علاقة لها بالتطوير الذي نشاهده في العديد من مناطق العالم، بما فيها دول حديثة العهد في المنطقة العربية، حيث نجد أنها تميزت بشكل واضح في جودة التعليم، وتقدّمت على مصر بشكل ملحوظ.
وكما قال محمود سامي البارودي:
بِقُوَّةِ الْعِلْمِ تَقْوَى شَوْكَةُ الأُمَمِ فَالْحُكْمُ فِي الدَّهْرِ مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَلَمِ
كَمْ بَيْنَ مَا تَلْفِظُ الأَسْيَافُ مِنْ عَلَقٍ وَبَيْنَ مَا تَنْفُثُ الأَقْلامُ مِنْ حِكَمِ
لَوْ أَنْصَفَ النَّاسُ كَانَ الْفَضْلُ بَيْنَهُمُ بِقَطْرَةٍ مِنْ مِدَادٍ لا بِسَفْكِ دَمِ