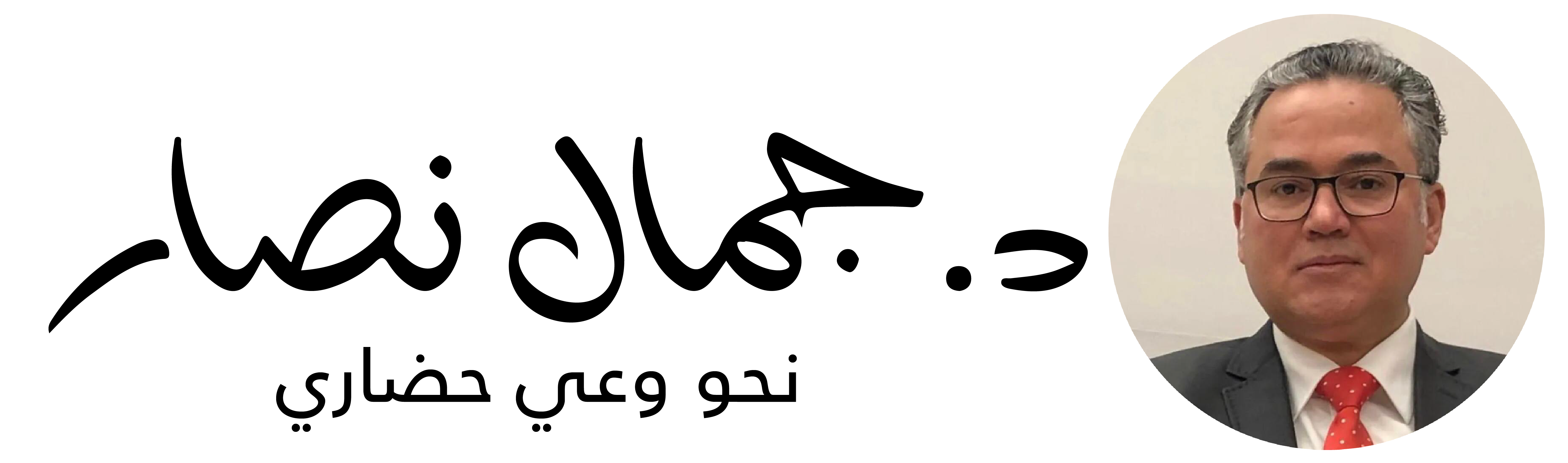د. جمال نصار
تدّعي الفلسفة الغربية أنها أصّلت لحرية الرأي والتعبير، ولم يسبقها أي نظام. وبالنظر إلى تلك الحرية نجد أنها غير منضبطة، وتتسم بالانفلات، وعدم مراعاة الآخر، وتُبنى على الحرية الفردية المطلقة التي تضر بالمجتمع في كثير من الأحيان. وخير شاهد على ذلك ما يقوم به الرئيس الفرنسي المأزوم ماكرون من التضييق على المسلمين، والإساءة للرسول بحجة حرية التعبير!
وبالنظر إلى منظومة الحرية في الإسلام، نجد أنها سبقت كل النظم والقوانين الوضعية فى الاهتمام بقضايا الإنسان وتحريره، وهذا الكلام لا يُبنى على التحيز بدون دليل، ولكن التاريخ والواقع يؤكدان ذلك.
ويخطئ من يظن، ويحيد عن الجادة من يعتقد أن الإسلام بدستوره وقواعده ألجم العقل بلجام؛ فهو يمنع حرية الفكر وإبداء الرأي ولكن بصورة جميلة رقيقة، لا تحمل الأمر المباشر، ولكن يفهم ذلك من النظرة الكلية للأمور!
لا أدرى على أي المصادر اعتمد هؤلاء المتأولون، وأجدني لا أملك إلا التسليم، بعد قراءة القرآن الكريم والسنة النبوية، بما أولاه الإسلام للعقل، وحضّه على إبداء الرأي.
فقد عاش العرب قبل الإسلام في جهالة، يتباهون بتقليدهم الأعمى للآباء والأجداد، هذا التقليد الذي أعمى البصر والبصيرة، وطبع على قلوبهم من أن ينظروا في أنفسهم والكون من حولهم. فمن السوء أن يجهل الإنسان، والأسوأ أن يتباهى بجهله هذا، غير عابئ بأنه تنازل عمّا يميزه عن الحيوان والجمادات، لذلك لم يجد العرب غضاضة من عذرهم )إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ( )الزخرف: 22(، وقول أبى طالب عمّ المصطفى، صلى الله عليه وسلم، بعدما استبان له نور الحق، وبعدما قدّم للإسلام الحماية والنصرة، وهو يعانى ألم السكرات “بل على مِلة عبد المطلب”.
ولم يكن أهل الكتاب بأحسن حالاً من أولئك العرب، فقد استأثر الأحبار والكهان وحدهم بدراسة ومعرفة الكتاب المقدس، ومنعوا غيرهم من دراسته وتلاوته إلا بما يسمحون به من نصوص لا يكاد القارئ يعي منها شيئًا، ليقول الله فيهم (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ) (البقرة: 78)، ونَعى، سبحانه وتعالى، على أولئك الأحبار والكهّان الذين حملوا ماديات على كاهلهم، ولم يحملوا معنى في قلوبهم، ونعتهم بأقبح النعوت جزاء تكذيبهم وظلمهم.
حتى جاء النور ليبدد ظلمات الجهل، ويهدم صنم التقليد، ويزيل الغشاوة عن القلوب والعقول. جاء الإسلام ليضع الأمور في نصابها، وليعيد للرأي مكانته، ويمنح له أهميته؛ فالإسلام يعد حرية الرأي والتعبير أساس جميع الحريات. وبعد أن أقر الإسلام حرية الرأي، ووضعها في نصابها، ولعلمه، سبحانه تعالى، أن الأهواء تختلف، والآراء تتشعب، فقد وضع الإسلام أطرًا وقواعد ينبغي مراعاتها حتى يصل المسلمون إلى الرأي السديد بإذن الله.
فقد منح الله العقل للإنسان، فبه يؤمن، وبه يعتقد، وبه يعلم ما يصلحه وما يفسده، وبه يستطيع اكتساب الخبرات والمهارات، وهو أداة التفكير، إلا أنه لا يستطيع وحده الوصول إلى الرأي السديد.
لذلك حض القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة على التفكر والتدبر في ذات الإنسان، وفى خلق الله من حولنا. إن التدبر والتفكر في هذا الكون ليفتح للإنسان مغاليق العلوم والمسائل، ومن خلاله يصل الإنسان إلى دقائق صنع الله وعجائب قدرته، فيعلم أنه قادر مقدّر، ومن خلال التفكر وصل الإنسان، بشكل عام، إلى اكتشاف قوانين العلوم كالجاذبية، وتعاقب الليل والنهار، ودوران الأرض حول نفسها وحول الشمس. وخير دليل على هذا الحض كثرة الآيات التي تنتهي بقوله “يعقلون” و “يتذكرون” و “يتفكرون”، في دعوة أكيدة لاستخدام هذا العقل كما ينبغي خير من أن يكون سيفًا نذبح به أنفسنا. إلا أن التدبر رغم قيمته وأهميته لا يستطيع وحده الوصول للرأي السديد.
أضف إلى ما سبق من قواعد وأطر اهتمام الإسلام بالعلم، ورفعه من شأن العلماء؛ فحض على طلب العلم وجعله فريضة شرعية كالصلاة، وحض على طلب الحكمة أينما كانت، ورفع الذين أوتوا العلم درجات، فالعقل والعلم يشكلان جبهة قوية لمواجهة تحديات وتطورات الحياة المختلفة، ولعل “اقرأ”، و”ن والقلم وما يسطرون” خير دليل على قيمة العلم في الإسلام، فقد حض الله، سبحانه وتعالى، عليه في أول ما نزل من القرآن رغم كونه، صلى الله عليه وسلم، أُميًا، ويعزز هذا الاهتمام وجود سورة كاملة باسم القلم. ومع ذلك، ورغم قيمة العلم وعظم خطره إلا أنه لا يستطيع وحده الوصول للرأي السديد. كل ما سبق منفردًا لا يصل إلى الرأي الصواب في كل ما عنّ للمسلمين من أمور. إلا أن النظرة الكلية، وبها فقط، هي الحل الأمثل لتلك المعضلة.
إن تحرير العقل من التقليد والجمود، وممارسة التدبر والتفكر فيما حولنا، والسعي دائمًا وأبدًا إلى التعلم واكتساب الخبرات والمهارات والخبرات، كل هذه الأمور مجتمعة تستطيع الوصول بسفينة الأمة إلى بر الأمان، والرأي الصواب، أو الأكثر قربًا للحق، ولا فضل لجانب على جانب، ولا فلاح لعنصر دون البقية.
وبعد أن نجح الإسلام في غرس هذه القيم وتلك المفاهيم فى نفوس معتنقيه، جاء الأمر واضحًا ومباشرًا بضرورة إبداء الرأي في الأمور المختلفة، حتى إن المصطفى، صلى الله عليه وسلم، ومنذ بداية الدعوة حرص على تمييز سلطته الدينية والتي تأخذ دون تحريف أو مناقشة أو تأويل، وبين سلطته السياسية والتي تقبل الأخذ والرد والصحة والخطأ، وما خروج المسلمين في أُحد، وصلح الحديبية إلا خير دليل على تلك الحرية المكفولة للمسلمين في إبداء الرأي. وكثيرًا ما خالف قائد سلاح المهندسين في الجيش الإسلامي الحباب بن المنذر رأى الرسول، صلى الله عليه وسلم، في اختيار أماكن التمركز واللقاء، بأسلوب يفوح احترامًا والتزامًا، ويقبل النبي، صلى الله عليه وسلم، بأسلوب يقطر استجابة وحبًا.
وبعد أن اطمأن النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى التزام أصحابه بتلك الأطر وهذه الضوابط، ومراعاة آداب إبداء الرأي والنصيحة، جاء الأمر واضحًا ومباشرًا بقول الحق مهما كانت سلطة المخطئ، ومهما كانت الفتاوى مضللة، ومهما انحرف العلماء عن الجادة وأصبح الحق غريبًا؛ “فالساكت عن الحق شيطان أخرس”، وحرص النبي، صلى الله عليه وسلم، على أن تكون المكافأة سخية، فقال: “سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله”.
كذلك حرص، صلى الله عليه وسلم، على إبداء صحابته لآرائهم، والأخذ بما اتفقوا عليه؛ ليكون ذلك تدريبًا لهم على هذا النهج، وحرصًا أيضًا على إقرار مبادئ الشورى وقواعدها؛ لأنه “لا تجتمع أمتي على ضلالة”.
وبعد، فإننا نضع هذه النصوص، وتلك المبادئ في ميزان العلم والمعرفة؛ لنرى أهي أكثر ملائمة وأيسر تطبيقًا أم تلك النظم والقوانين الوضعية، التي وضعها واضعوها لكي يخالفوها؟!
فليست حرية التعبير في الإسلام فرصة للتصلّب والتغلب، ولا وسيلة لإحراج المخالف وإضعاف موقفه، وليست مجالاً للتفنّن في السفسطة وقلب الحقائق، ولا ساحة للتباري في الجدال والخطابة. ولا تتسم بمعارضة مطلقة أو موافقة مطلقة، كما يجري الآن لدى الحكومات والأحزاب الديمقراطية وشبه الديمقراطية، بحيث يكون كل واحد فيها ملتزمًا أو ملزمًا بنصرة جهته وفريقه وحزبه، ومناوأة خصومه ومخالفيه بصورة مطلقة وتلقائية، مهما كان رأيه، ومهما تغيّر رأيُه، حتى ولو كان يرى، في قرارة نفسه، الصواب عند خصمه، والخطأ عند جهته.
فهذا السلوك الذي أصبح سائدًا ومسلّمًا به لدى السياسيين اليوم، ليس في الحقيقة ممارسة لحريّة التعبير، بل هو إفساد لحرية التعبير وتلاعب بها. ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال: “رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب”.
والخلاصة: أن الإسلام قد فتح الباب واسعًا لحرية الرأي والتعبير، ولم يجعل أحدًا من الناس فوق المراجعة والمعارضة، فالله تعالى وحده، بجلاله وكماله، هو الذي (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَل) (الأنبياء: 23).