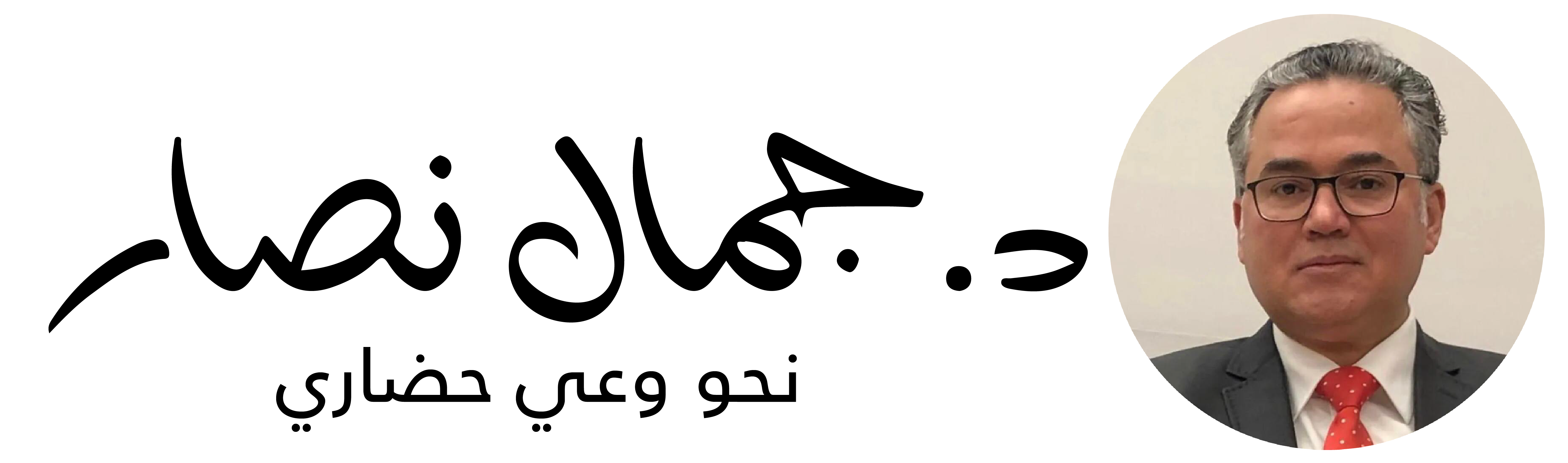أرشدنا الإسلام وأمرنا بالنظر في الكون والتفكر والاعتبار، وفصّل ما تمس إليه الحاجة في حياتنا الدنيا، وما يتعلق بالآخرة، وهدانا إلى أن لكل عمل أثرا لا يتعداه، وأن الأسباب مربوطة بمسبباتها، وكل سبب محمود يفضي إلى غاية شريفة، والأمور الدنيوية لا يمنعها الله عن الذين يسعون إذا أتوا البيوت من أبوابها، والتمسوا الرغائب من طرقها وأسبابها الطبيعية، سواء كانوا مؤمنين أو غير ذلك، وإنما الإيمان شرط للمثوبة في العقبى، وكمال السعادة في الدنيا.
بهذا كان الدين الإسلامي سببا في سعادة ذويه وسيادتهم وريادتهم للدنيا، عندما كانوا مهتدين بهديه ومتمسكين بحبله، لا بأسرار خفية، وأمور غير معقولة. لكن جهل بعض المسلمين بتعاليم دينهم، وتلمسهم النجاة والتقدم بعيدا عن أخلاقهم وهديهم وقيمهم، أفضى بهم إلى التفرق والانقسام، والميل مع الهوى، كما أن جهلهم بحالة وطبيعة العصر زادهم حيرة وتخلفا في معادهم ومعاشهم.
فقانون الأسباب والمسببات قانون عام، هذا القانون في غاية الدقة والإحكام والشمول بحيث لا يخرج عنه شيء، ولا يفلت منه مخلوق أيّا كان موقعه، يحكم كل شيء من المخلوقات بلا استثناء من أصغر ذرة إلى أكبر جرم، ومن الجمادات والنباتات بأنواعها المختلفة إلى ذي الروح بأنواعها المتعددة، ومن حركة الذرة في مادتها التي لا يشعر بها الإنسان إلى حركة الريح العاصف التي تقلع الأشجار وتخرب البيوت. هذا الخضوع التام من الجميع ما هو في الحقيقة إلا خضوع للملك القوي الجبار واضع هذا القانون، وخالق هذا الكون، وهذا القانون الإلهي العام يُطلق عليه “سنة الله” لا يقبل التبديل ولا التحويل.
والعدل الإلهي قائم على تلك السنن الكونية التي تحكم هذا الكون بأمر الله، فأيما أمّة عرفت هذه السنن، واحترمت عقولها، وقدّرت العلم الذي هو الطريق الأول لتطبيق تلك السنن سادت وقادت العالم، ولو كانت تلك الأمة غير مسلمة، طالما أخذت بتلك الأسباب الكونية.
وليس ما نراه اليوم من سيادة غير المسلمين للعالم، وتأخر المسلمين إلى أن أصبحوا في ذيل الأمم في جميع المجالات، إلا عدلا من الله، وتطبيقا لسننه الكونية والتاريخية، لأن من يطبق العدالة بمفهومها الواسع التي تضمن التقدم والرقي في الدنيا، ويأخذ بالعلم ووسائله الحديثة، يتقدّم على غيره، لا محالة، وهذه سنة كونية. ولكن، للأسف الشديد، تخاذل المسلمون وتغنوا بماضيهم التليد، وحضارتهم القديمة فقط، ومواقف من سبقوهم، ونسوا أن عليهم دورا لم يؤدوه، واهتموا بالقشور دون الأصول، ولم يسع الكثير منهم للأخذ بأسباب النهضة والتقدم الرقي.
إقامة العمران من مهام الإنسان
إن المقصد من الوجود البشري في الأرض هو إعمارها وإصلاحها، وتغيير وتحسين وجه الحياة التي نحياها: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) (هود: 61)، فإن أدى هذا المخلوق الذي هو خليفة الله في الأرض وظيفته، وأخذ بأسبابها الصحيحة، ساد الأرض وعلا فيها كعبه، وإن طغى وظلم نفسه، أو ظلم غيره فإن مصيره الهلاك حتما: (وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) (الأعراف: 4 – 5)، فإهلاك الله للأمم بظلمها لنفسها أو لغيرها، والعقوبة أثر طبيعي لازم للعمل الفاسد، وأن ذنوب الأمم لابد من العقاب عليها في الدنيا قبل الآخرة: (أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آَخَرِينَ) (الأنعام: 6)
وهذه هي سنة الانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح، وهي سنة مطّردة في ملكوت الله: (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْض) (البقرة: 251) (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ) (الرعد: 17)، والذي ينفع الناس هو الذي عليه مدار حياتهم وآخرتهم، لا الذي ينفعهم في أمر دنياهم فقط، ولا الذي يفيدهم في أمر آخرتهم فقط، فلابد أن تكون الدنيا معبرا للآخرة، وسبيلا للعيش طبقا للقانون الذي خلقنا الله من أجله، لعمارة الأرض.
وقد كتب سبحانه وتعالى إرث الأرض للصالحين، لإقامة العدل والحق، وتطبيق سنن الله في العمران البشري، وهذا ما يسميه علماء الاجتماع: بقاء الأمثل والأصلح في كل تنازع.
ومدار هذه السُّنّة على أن العاقبة في التنازع بين الأمم على الأرض التي تعيش فيها أو تستعمرها للمتقين، أي الذين يتقون أسباب الضعف والخذلان والهلاك، كاليأس من روح الله، والتخاذل، والتنازع، والفساد في الأرض، والظلم، والفسق، ويتلبسون بغيرها، وبسائر ما تقوى به الأمم من الأخلاق والعلم، وأعلى هذه الأخلاق الاستعانة بالله، الذي بيده ملكوت كل شيء، والصبر على المكاره مهما عظمت. وهذا ما تتفاضل به الأمم في القوى المعنوية، باتفاق علماء الاجتماع.
ومن العجيب حقا أنك تجد معظم المسلمين اليوم يجهلون هذه السنن الكونية، ولا يبالون بالنتائج الوخيمة المترتبة على ذلك، وفي كثير من الأحيان لا يبذلون الوسع والجهد في تحسين أحوالهم وإصلاح شأنهم.