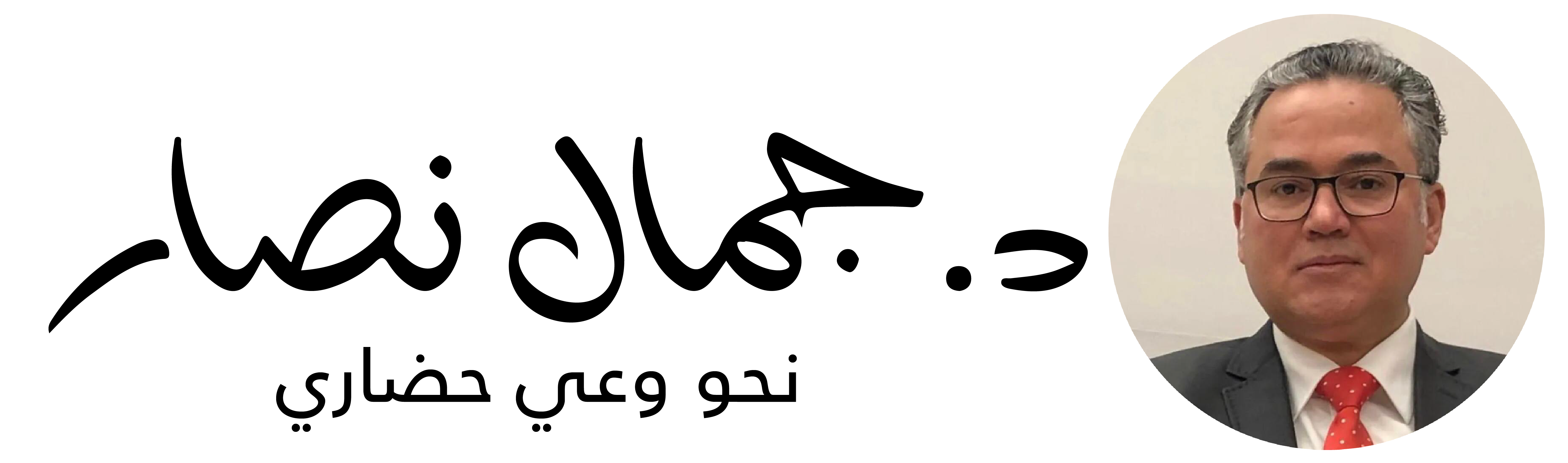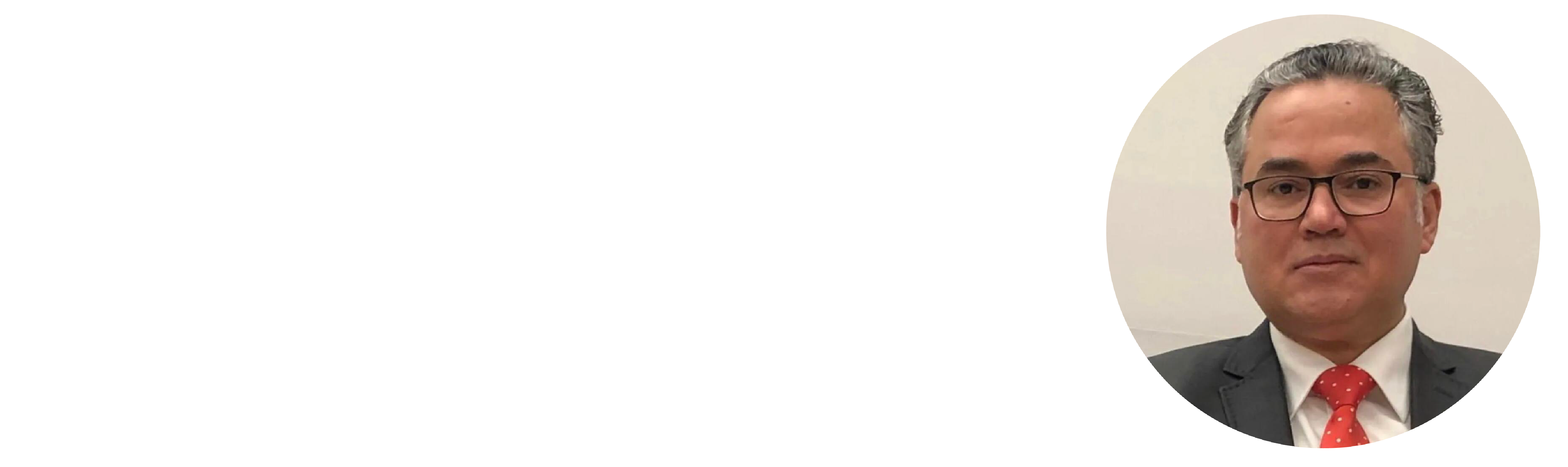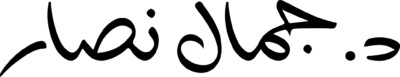د. كمال أصلان – مجلة المجتمع الكويتية
الحروب في الإسلام ليست دينية، أي يمليها التعصب الديني ضد أتباع الديانات الأخرى، فالإسلام دين التسامح الذي يُقر بوجود الأمم والشعوب والأديان الأخرى، ولا يريد إبادة المخالفين في الدين، ولا يجيز الإكراه على الدين أو الاعتقاد، ويتعايش المسلمون مع غيرهم على صعيد راسخ من السلم والأمان، وحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، قال الله تعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيَّ) (البقرة: 256).
وقال ابن تيمية: “لا نُكره أحدًا على الدين، والقتال لمن حاربنا ماله ودمه، وإذا لم يكن من أهل القتال لا نقتله، ولا أحد ينقل أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أكره أحدًا على الإسلام، لا ممتنعًا ولا مقدورًا عليه، ولا فائدة في إسلام مثل هذا، لكن من أسلم، قُبل منه ظاهر الإسلام”. (السياسة الشرعية: ص 123)
والإسلام كدين شامل وضع أسسًا وأخلاقيات واضحة للتعامل مع الأعداء المحاربين، سواء في حالة الحرب أو السلم، هذه الأخلاقيات تستند إلى مبادئ العدل، والرحمة، واحترام الكرامة الإنسانية، حتى في خضم الصراعات الدامية، يقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) (المائدة: 8)، هذه الآية تؤكد على ضرورة العدل حتى مع الأعداء، وعدم السماح للكراهية أن تحيد بالإنسان عن مبدأ الإنصاف، ومن أهم الأخلاقيات التي يجب أن يسير عليها المحارب:
أولا: عدم قتل غير المحاربين وحماية الممتلكات العامة:
اتفق أهل العلم على عدم جواز قتل الشيوخ، والنساء، والصبيان، والولدان في الحرب، باستثناء المشتركين والمساعدين فيها فإنهم يقاتلون، ولا عصمة لدمائهم.
فقد كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يوصي قادة الجند بالتقوى، ومراقبة الله تعالى ليدفعهم إلى الالتزام بأخلاق الحروب، ومن ذلك أنه يأمرهم بتجنب قتل الولدان؛ فيروي بريدة فيقول: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا أمَّر أميرًا على جيش، أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرًا، وكان مما يقوله: (ولا تقتلوا وليدًا) (رواه مسلم)، وفي رواية أبي داود: (ولا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلاً، ولا صغيرًا، ولا امرأة)، ويحرم الإسلام تدمير الممتلكات العامة والخاصة دون ضرورة.
ثانيًا: عدم قتل المتعبدين والرهبان:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز قتل الرهبان والأحبار المسالمين في صوامعهم ومنازلهم، وكذلك أهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس ولا يتزوجون، ولم يكونوا أهل رأي وتدبير في الحرب، فإن قاتلوا أو ساعدوا، أو حرّضوا على القتال قُتلوا.
وكان رسول اللَّه، صلى اللَّه عليه وسلم، إذا بعث جيوشه قال: (اخرُجوا باسمِ اللَّهِ قاتِلوا في سبيلِ اللَّهِ من كفرَ باللَّهِ، ولا تعتَدوا، ولا تَغُلُّوا، ولا تُمَثِّلوا، ولا تقتُلوا الوِلدانَ، ولا أصحابَ الصَّوامعِ). (رواه أحمد).
ثالثًا: تجنب الخيانة والغدر:
كان من وصيته، صلى الله عليه وسلم، للجيش: و(لا تغدروا )، ولم تكن هذه الوصية في معاملات المسلمين مع إخوانهم المسلمين، بل كانت مع عدو يكيد لهم، ويجمع لهم، وهم ذاهبون لحربه! وقد وصلت أهمية هذا الأمر عند رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه تبرأ من الغادرين، ولو كانوا مسلمين، ولو كان المغدور كافرًا؛ فقد قال، صلى الله عليه وسلم: (من أمَّن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، وإن كان المقتول كافرًا). رواه البخاري وغيره.
وقد ترسخت قيمة الوفاء في نفوس الصحابة، رضي الله عنهم، حتى أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، بلغه في ولايته أن أحد المقاتلين قال لمحارب من الفرس لا تخف، ثم قتله، فكتب، رضي لله عنه، إلى قائد الجيش: أنه بلغني أن رجالاً منكم يطلبون العلج (الكافر)، حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع يقول له: لا تخف، فإذا أدركه قتله، وإني والذي نفسي بيده لا يبلغني أن أحدًا فعل ذلك إلا قطعت عنقه.
رابعًا: عدم استهداف المدنيين والدبلوماسيين:
لا يجوز قتل المدنيين غير المحاربين من الرجال كالحرّاس والعسيف (الأجير الذي يستهان به)، والأعمى، والمقعد والزمِن (الذي لا حراك فيه)، والجريح، والمجنون، والمعتوه، والسائح في الجبال الذي لا يخالط الناس، وكبار السن، والمرضى، والمزارعين، وذوي الصناعات والتجارات، ومن في معناهم، والسبب في عدم قتلهم أنهم ليسوا من أهل القتال فلا يُقتلون، لكن إن قاتل منهم أحد قتل، وكذا لو حرّض على القتال، أو دلّ على عورات المسلمين، أو كان الكفرة ينتفعون برأيه وماله، أو كان مطاعًا في قومه، لوجود القتال من حيث المعنى.
ولا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز قتل الرسل، ومن في معناهم من السفراء، وأفراد البعثات الدبلوماسية والتمثيل القنصلي وسائر المستأمنين إلا إذا شاركوا في القتال حقيقة، أو معنى.
فلم تكن حروب المسلمين حروب تخريب كالحروب المعاصرة التي يحرص فيها المتقاتلون من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدى خصومهم، بل كان المسلمون يحرصون أشد الحرص على الحفاظ على العمران في كل مكان، وظهر ذلك واضحًا في كلمات أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، عندما وصّى جيوشه المتجهة إلى فتح الشام، وكان مما جاء فيها: “ولا تفسدوا في الأرض”.
وهو شمول عظيم لكل أمر حميد، وجاء أيضًا في وصيته: “ولا تُغرقُن نخلا ولا تحرقنها، ولا تعقروا بهيمة، ولا شجرة تثمر، ولا تهدموا بيعة.”
خامسًا: الإحسان إلى الأسير والإنفاق عليه:
أكثر العلماء على أن الإمام مخيّر في الأسرى؛ منها المنّ عليهم، ومنها الاسترقاق، ومنها القتل، ومنها الفداء، والأمر مرتبط بخطورة الأسير، ومدى عداوته للمسلمين، فإن النبي، عليه الصلاة والسلام، إنما قتل منهم من تمادى في عداوته للإسلام وأهله (أُبي بن خلف الجمحي)، وقد قتله يوم أحد، كما ينظر إلى تعامل العدو مع أسرى المسلمين عنده، فإن قتل أسرانا قتلنا أسراه، وإن قبل التبادل قبلناه.
وموضوع الأسرى يخضع للسياسة الشرعية والواقع، ولا مانع من الالتزام بالمواثيق الدولية في هذا الأمر إذا احترم العدو هذه المواثيق ولم يخالفها.
ودعا الإسلام إلى الإنفاق على الأسير، وذلك بحكم ضعفه، وانقطاعه عن أهله وقومه، وشدة حاجته للمساعدة، وقد قرن القرآن الكريم البِر بالأسير ببر اليتامى والمساكين، (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) (الإنسان:8).
سادسًا: الرحمة وعدم التمثيل بالجثث:
حرّم الإسلام التمثيل بجثث العدو بعد الظفر بهم والنصر عليهم بأي نوع من أنواع التمثيل، فقد نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن المُثْلَة والنُّهبَى، فروى عبد الله بن زيد، رضي الله عنه، قال: “نَهَى النَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم، عَنِ النُّهْبَى، وَالمُثْلَةِ”. (رواه البخاري). (النُّهْبَى: أَخذ المرء ما ليس له جهارًا، والمُثْلَة: التنكيل بالمقتول، بقطع بعض أعضائه).
ورغم ما حدث في غزوة أُحُد من تمثيل المشركين بحمزة عمِّ الرسول، صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يُغيِّر مبدأه، بل إنه، صلى الله عليه وسلم، هدَّد المسلمين تهديدًا خطيرًا إن قاموا بالتمثيل بأجساد قتلى الأعداء، فقال: (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا، وَإِمَامُ ضَلاَلَةٍ، وَمُمَثِّلٌ مِنَ الْـمُمَثِّلِينَ) (رواه أحمد)، ولم يرِدْ في سيرة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حادثةٌ واحدة تقول بأن المسلمين مثَّلوا بأَحَدٍ من أعدائهم.
والخلاصة أن أخلاقيات السياسة الشرعية في التعامل مع العدو المحارب تُظهر مدى رُقي الإسلام وتكامله كدين يدعو إلى العدل والرحمة واحترام الكرامة الإنسانية، حتى في أوقات الصراع، وهذه المبادئ الأخلاقية ليست فقط تعاليم دينية، بل هي أيضًا قواعد أخلاقية وإنسانية يمكن أن تسهم في تقليل وحشية الحروب وحماية المدنيين من آثارها المدمرة.