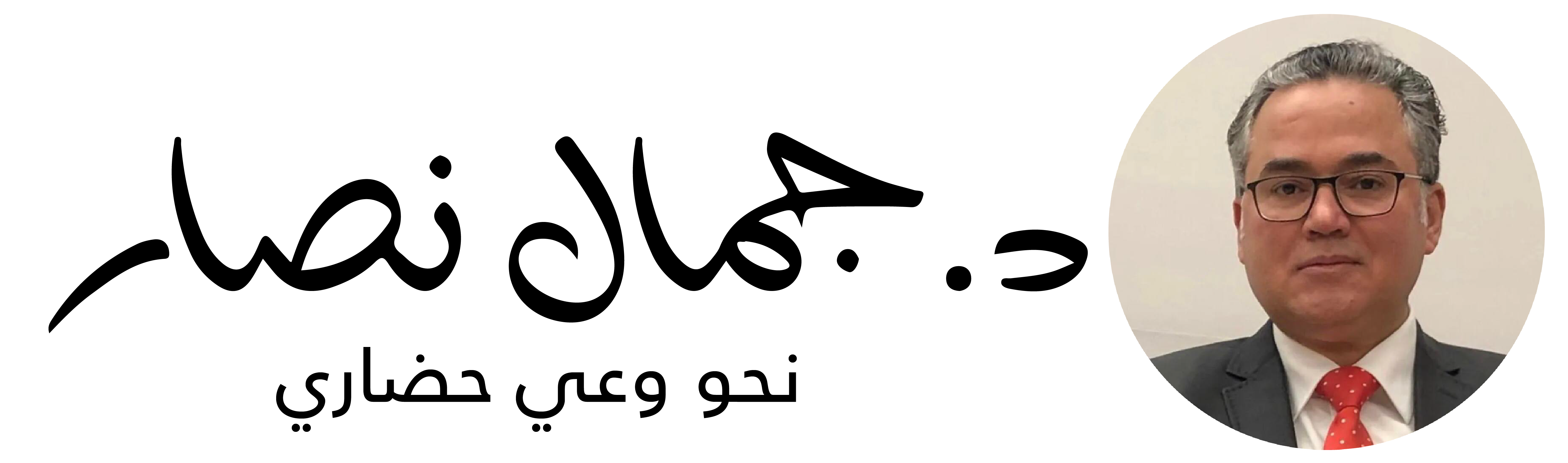د. جمال نصار – الشرق القطرية
من نعم الله تعالى على البشرية أن أرسل لهم رسولًا من أنفسهم يعلمهم ويزكيهم، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وبهذه الرحمة التي عمّت الكون كله، وجب شكر الله عليها آناء الله وأطراف النهار، كما يقول ابن كثير: أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة، سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردّها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة.
ونحن نعيش في هذه الأيام العطرة من شهر ربيع الأول ذكرى ميلاد خير البشر، الذي أنارت الدنيا بمقدمه، وسعدت البشرية برسالته، التي جعلها الله خاتمة لكل الرسالات، وجعله، صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين.
وهذا التفضيل المستحق لنبينا الكريم، صلى الله عليه وسلم، لأن الله، تبارك وتعالى هو الذي رفع من شأنه، وأعلى من قدره، وعلامات ذلك:
أن جعله الله تعالى من أُولي العزم من الرسل، وأرسله إلى الناس كافة على عكس الأنبياء الذين أُرسلوا لأقوامهم خاصة، وجعله الله، عز وجل، خاتم النبيين، فلا نبي بعده، ورفع من ذِكْره بأن قرن اسمه تعالى باسم النبي، صلى الله عليه وسلم، في (الشهادة – التشهد – الأذان – الذكر).
وأنزل الله تعالى سورًا بأكملها فيه، صلى الله عليه وسلم، وحده وهي: (الضحى – الشرح – الكوثر – النصر)، كما أنزل الله تعالى سورة كاملة لتخليد حدث حفظ الله تعالى فيه بيته، وأهلك عدوه في عام مولده، صلى الله عليه وسلم، وهي (سورة الفيل)، وأنزل الله تعالى سورة كاملة في قومه وسمّاها باسمهم (سورة قريش).
وجعل الله تعالى الصلاة عليه، صلى الله عليه وسلم، بصيغة له خاصة، فكل نبي نقول عند ذكره (عليه السلام) أما إذا ذكر (مُحمدٌ) فنقول، صلى الله عليه وسلم، وفضّله الله تعالى على سائر الأنبياء بخصال ست لم ينلها نبي قبله، فعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: “فُضِّلتُ على الأنبياءِ بسِتٍّ: أعطيتُ جوامِعَ الكَلِم، ونُصِرتُ بالرُّعبِ، وأحِلَّت لي الغنائمُ. وجُعِلَت لي الأرضُ طَهورًا ومسجِدًا، وأُرسِلتُ إلى الخَلقِ كافَّةً، وخُتِمَ بي النبيُّونَ” (رواه مسلم).
وجعله الله تعالى أكثر الأنبياء تبعًا، فهو، صلى الله عليه وسلم، أول من يُبعث، وأول من يدخل الجنة، وأول من يشفع، وهو من يشهد للأنبياء على أقوامهم أمام الله، عز وجل، وجعله الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الحوض.
والله تعالى أخبره بأنه غُفر له ما تقّدم من ذنبه وما تأخّر قال الله تعالى: (إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ ومَا تَأَخَّرَ) (الفتح: 1-2)، ولم يُنقل أنه أخبر أحدًا من الأنبياء بمثل ذلك، وأن معجزة كل نبي انتهت وانقرضت، ومعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم باقية إلى يوم الدين.
ومن ثمّ علينا أن نزداد شرفًا بانتسابنا لهذا النبي العظيم، الذي أكرمنا الله به، ونشكره في كل وقت وحين أن جعلنا من أمته، صلى الله عليه وسلم، وتوابع هذا الشكر أن نسير على نهجه، ونستن بسنته في كل حياتنا، ومن ذلك:
التعرّف عليه، صلى الله عليه وسلم، من خلال دراسة سيرته وشمائله، وتطبيق ذلك في أنفسنا وأُسرنا ومجتمعنا، وتعظيم سنته، والحرص على العمل بما جاء فيها فإنها وحي من الله، تبارك وتعالى، كل حسب استطاعته، وتقديم محبته على النفس والمال والولد، لأنه هو سبب سعادتنا في الدنيا، وسيشفع لنا يوم القيامة، والإكثار من الصلاة والسلام عليه، فهذا يعود علينا بالرحمة والمغفرة، وبذل الأموال والأوقات في نشر دعوته وسيرته، كل في ميدانه ومكانه، ومقاطعة بضائع وشركات من يتطاولون عليه، صلى الله عليه وسلم، والاستعانة بالبدائل من المنتجات العربية والإسلامية، وتعليم سيرته وهديه لأبنائنا، وجعل ذلك ضمن مناهجنا الدراسية.
والخلاصة: أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقتدوا بسيد الخلق، ويسيروا على سنته، لأنه خير قدوة لنا، وبقدر قُربنا منه، صلى الله عليه وسلم، وتطبيق منهجه في حياتنا، وأخلاقه في معاملاتنا، بقدر سعادتنا في الدنيا والآخرة، لأن الله أمر بطاعة رسوله في أكثر من ثلاثين موضعًا من القرآن، وقرن طاعته بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته؛ كما قرن بين اسمه واسمه، فلا يُذكر الله إلا ذُكر معه، صلى الله عليه وسلم.