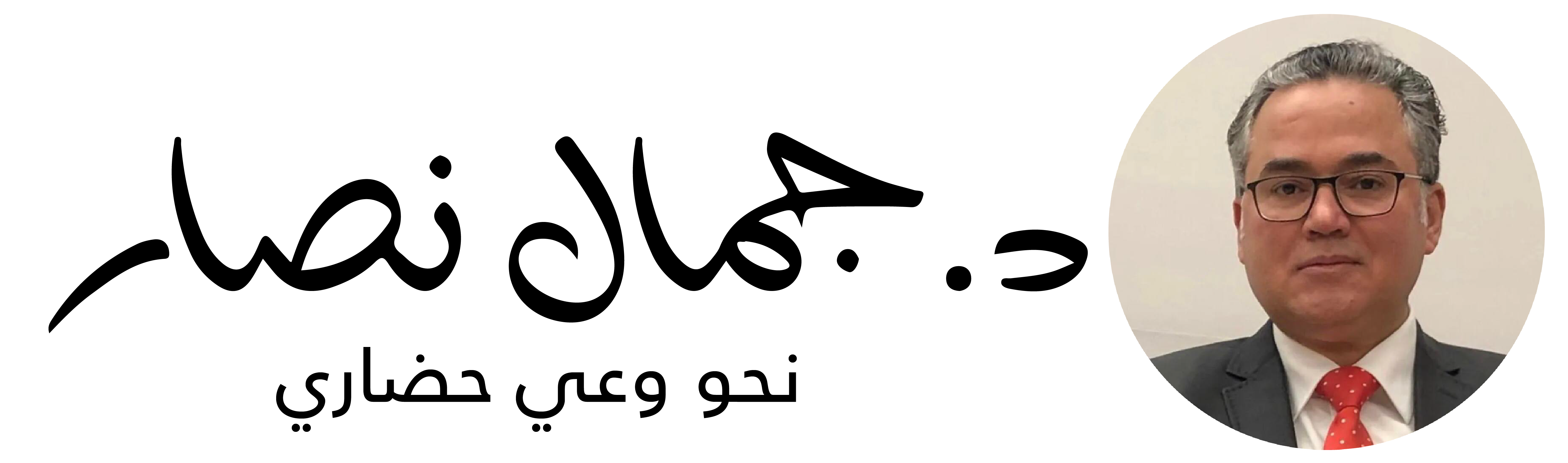الهدف الأكبر لكل المصلحين عبر كل العصور هو تغيير المجتمعات إلى الأصلح، ومواجهة الفاسدين والمستبدين الظالمين في كل مكان. فالصراع الواقع على ظهر الأرض منذ بدأت عليها الحياة البشرية، إنما هو صراع بين المصلحين والمفسدين، والعاقبة فيه لأهل الصلاح في الدنيا والآخرة: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادًا، والعاقبة للمتقين) (القصص: 83)، وللمصلحين طرق ومناهج للإصلاح، كما أن للمُفسدين سبل وطرائق للإفساد، وعلى الناس أن يتبعوا سبيل المصلحين ويجتنبوا سبل المفسدين، قال تعالى: (ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون) (الشعراء: 152).
يقول عباس العقاد: “الأمة التي تُحسن أن تجهر بالحق، وتجترئ على الباطل تمتنع فيها أسباب الفساد”.
قانون الله في التغيير
هذا العالم لا يسير جزافًا، ولا يتحرك اعتباطًا، بل كل شيء فيه بقدر، وكل حركة فيه وفق قانون، وهو الذي يسميه القرآن: سنة، سواء أكانت سنة كونية أم اجتماعية، وأن هذه السنن ثابته لا تتبدل ولا تتحول، وأنها تجري على الآخرين كما جرت على الأولين، وأنها تتعامل مع أهل الإيمان كما تتعامل مع أهل الكفر: (فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا) (فاطر: 43).
ويجب على من يريدون التغيير والإصلاح أن يفقهوا قانون الله في التغيير، فهو لا ينزع نعمة أنعمها على قوم حتى يكون منهم الإفساد والمعاصي، فإذا نزع سبحانه تلك النعمة فلن تعود إلا بالرجوع إليه، حسْب سننه في الكون؛ وسنن الله لا تحابي أحدًا، فأيما قوم أخذوا بأسباب النجاح في الدنيا كُتب لهم، وإذا تم الرجوع الحقيقي من المؤمنين إلى الله تعالى كان التمكين لهم: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (الرعد: 11)، ذلك أن الله استخلفنا في الأرض لنقوم بعمارتها بالعدل والحق والعمل الصالح: (هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) (هود: 61) فمن بدّل نعمة الله كفرًا جرى عليه قانون الاستبدال، وهذه سنة الله في التغيير التي ينبغي على كل مُصلح أن ينطلق منها، ويجعلها أساس كل إنجازه الفكري، ويتخذ من قوله تعالى: (إن الله لا يغير..) قانونًا للتغيير بكل مستوياته، حتى يصل بالأمة إلى هدفها، وهو التمكين لدين الله في الأرض، ويبحث في وقائع التاريخ؛ ليؤكد للعالم أجمع وللعقل المسلم بصفة خاصة، باعتباره مخاطَبا بالآية، أن الله تعالى يعلمنا بها، وآيات القرآن كلها أن التغيير يخضع لسنن ربانية علينا أن نكتشفها ونوظفها في بنائنا الحضاري بكل مستوياته.
كيف يحقق الإنسان مراد الله في التغيير
فكرة البناء الحضاري في الإسلام تؤكد أن الإنسان هو خليفة الله في الأرض، مأمور بتعميرها وبناء الحضارات فيها على أساس المبادئ؛ إذ لا يستطيع الإنسان أن يبني حضارة على هدي السنن الإلهية التي رسمها في كتابه العزيز، والتعرف على الذات الإنسانية، فطرتها وطبيعتها الأولى، وهنا يدرك الإنسان المعنى الشامل للإسلام بكل كيانه، وشمل حضاراته بكل ما فيها، وحوى الدنيا بأسرها، ولم يترك الإنسان يتخبط في غياهب الأوهام.
وعند تحقق هذا الاستخلاف في الأرض فسيكون استخلافًا راشدًا، مصحوبًا بالقدرة على إعمار الأرض وإصلاحها، لا استخلافًا قائمًا على الهدم والإفساد، وسيكون تمكينًا يحقق العدل والطمأنينة، لا تمكينًا يقوم على الظلم والقهر، سوف يسمو هذا الاستخلاف بالنفس البشرية والنظام البشري نحو السماء، متعاليًا بالفرد والجماعة عن مدارج الحيوان!
فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض، وينشرون فيها البغي والجور، وينحدرون بالإنسانية إلى مدارج الحيوان .. فهؤلاء ليسوا مستخلفين، إنما هم مُبْتَلون بما هم فيه من نعيم أو مُلك، أو مُبْتَلَى بهم، ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها الله. وعند تَمَلُّك هؤلاء المفسدين فإن النكسة ستتحقق للبشرية؛ لأن هؤلاء المفسدين غالبًا ما يحكِّمون أهواءهم، ويتبعون نزواتهم، ويعملون لحساب أنفسهم: (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) (المؤمنون: 71)؛ ولذا كانت “حكمة الله تعالى أن الإنسانية حين تصل في نكستها إلى السفح يأذن الله لدينه أن ينبعث من جديد ليؤدي دوره”.
السبيل لتحقيق التغيير
ليس بين الأمة الإسلامية وبين النصر في أي زمان وفي أي مكان إلا أن تستكمل حقيقة الإيمان، وتستكمل مقتضيات هذه الحقيقة في حياتها وواقعها كذلك .. ومن حقيقة الإيمان أن تأخذ العدة وتستكمل القوة، ومن حقيقة الإيمان ألّا تركن الأمة إلى الأعداء، وألّا تطلب العزة إلا من الله، بل وتستشعر هي حقيقة العزة، عزة انتمائها إلي هذا الدين العظيم .. والإيمان في حقيقته قوة حقيقية ثابتة ثبوت النواميس الكونية، ذات أثر في النفس وفيما يصدر عنها من الحركة والعمل، وهي حقيقة ضخمة هائلة كفيلة حين تواجه حقيقة الكفر المنعزلة المبتوتة المحدودة أن تقهرها .. ولكن حين يتحول الإيمان إلى مظهر فإن حقيقة الكفر تغلبه، إذا هي صدقت مع طبيعتها وعملت في مجالها؛ لأن حقيقة أي شيء أقوى من مظهر أي شيء، ولو كانت هي حقيقة الكفر وكان هو مظهر الإيمان!
إن الأمل الوحيد في إنقاذ الأرض من المفسدين في كل الأزمنة والأمكنة، يكمن في قيام أهل الحق والإصلاح، على كل المستويات، بمسؤولياتهم أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر، بكل السبل والوسائل المتاحة.
وكما قال القائل: “إن الفساد يطول عمره كلما انسحب الشرفاء من الميادين وآثروا السلامة وتخاذلوا فيفسحون المجال للصغار التافهين البلطجية”.
ويقول الشيخ محمد عبده: “الفساد يهبط من أعلى إلى أدنى، والإصلاح يصعد من أدنى إلى أعلى”.
ومسؤولية على كل مواطن في نطاق صلاحياته ومسؤولياته، وما يصل إلى سمعه وبصره من صور الفساد الثابتة والمؤكدة؛ التحرك الإيجابي لمواجهة اللصوص والمجرمين الذين أدمنوا الفساد في الشأن العام، سواء أكان هؤلاء من كبار أم من صغار الموظفين الذين تمتد أياديهم الآثمة إلى المال العام بالسرقة والنهب، أو كانوا من اللصوص والمجرمين الذين يستغلون الظروف لبعض المجتمعات العربية لسرقة المال العام وممتلكات الآخرين.
إنه الوعي بطبيعة المرحلة التي نحياها، وضرورة السعي لإزاحة الفاسدين، وخصوصًا إذا خانوا الأمانة، وقهروا الناس لتحقيق مصالحهم الخاصة، بل الأدهى وأمرّ أنهم يحققون أغراض الأعداء التي هي ضد مصالح الأمة، ويسعون في الوقت ذاته لخداع الشعوب بالأوهام المعسولة حينًا، وبالتهديد والوعيد أحيانًا أخرى، مع تشويه صورة كل من يواجههم أو يكشف زيفهم، بحجج ممجوجة مثل دعاوى مواجهة الإرهاب، الذي هم صانعوه!
إن من أخطر الأمور التي تهلك الأمم وتزيلها، وتقضي على طموحاتها وآمالها؛ أن ينال الظلم والفساد من كل مؤسسات الدولة، وخصوصًا إذا قام بهذا الفساد وقنّنه رأس السلطة الذي من واجبه ومهامه الأساسية مواجهة الفساد والمفسدين.
ولذلك يقول ابن خلدون “الظلم مؤذن بخراب العمران”، ويقول الشيخ محمد الغزالي: “إن الفراعنة والأباطرة تألهوا؛ لأنهم وجدوا جماهير تخدمهم بلا وعي”.